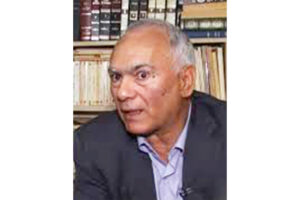
تحظى ظاهرة تشابه النصوص الشعرية منذ القدم، بقدر هائل من الاهتمام ضمن سياق البحث عن تأويل موضوعي لدلالاتها. وبالنظر إلى ما تتميز به من حضور قوي عبر تتالي المدارس والمذاهب والتيارات، التي تميزت بها العصور الأدبية، فإنها لا تزال، موضوع مقاربات علمية اتخذت لها مسارات جدد متعددة، انسجاما مع تعدد مرجعياتها النظرية، وأيضا انسجاما مع خصوصية نصوصها، كي يمتد بين ما يصطلح عليه بـ»المعارضة» و»التناص» تاريخ طويل من التأويل الذي تستحضر فيه كل المقومات الفكرية والجمالية، الكفيلة بتسليط ما يكفي من الضوء على إشكالاتها، دون إغفال أحكام القيمة ذات البعد الأخلاقي، التي لا تتردد في حشرها ضمن خانة السرقات.
ولعل أول ما يمكن إثارته في هذا الصدد، هاجس الهدم الذي كانت مسكونة به الذائقة الجديدة، تجاه بنية موروث شعري، استطاع بفضل ما زامنه من سلط متعالية تكريس هيمنته المطلقة على القول الشعري منذ العصر الجاهلي إلى منتصف القرن الماضي.
والهدم المسكوت عنه الذي نحن معنيون به في هذا السياق، ينصب أساسا على الأزمنة الاستبدادية، التي عانى ويعاني من قسوتها الإنسان العربي، على امتداد قرون وقرون، من حجرها الفكري والإنساني، باسم ثوابت لا حق له بالطعن في مصداقيتها، حيث لم يكن النقد الموجه لعمود القصيدة التراثية، سوى ذريعة فنية وجمالية لمهاجمة كل ما يدور في فلك السلط الرسمية، من قيم وعادات، في مختلف تجلياتها ومظاهرها. وبالنظر إلى المكانة الاعتبارية التي يحتلها الشعر في الذاكرة العربية، بوصفه أصلا راسخا من الأصول المركزية التي تتميز به الهوية، فسيكون من الطبيعي استهدافه من قبل الحركات التجديدية المتطلعة إلى استشراف آفاق أكثر تحررا وأكثر تقدما، ومستجيبة لآمال وأماني الإنسان الجديد.
بهذا المعنى سيكون القطع مع التراث الشعري القديم، في حد ذاته قطعا رمزيا مع كل مظاهر البؤس والتخلف التي تسهر الأنظمة التقليدية على تعميمها، وإدامة هيمنتها وسيطرتها على العباد. ومن هذا المنطلق تحديدا، اكتسبت القصيدة العربية الحديثة طابعها الأيديولوجي بصورة جد تلقائية، انعكس بشكل مباشر على مضامينها المنتصرة للإنسان، والمتمردة على كل التجاوزات القمعية والاستغلالية.
وإذا ما نحن سلمنا بأن هذا البعد التثويري كان من بين أهم مقومات الحركة التحديثية التي تميز بها الشعر العربي المعاصر، فسيكون من الطبيعي أن تأخذ شكل ميثاق يتقيد به الشاعر الذي يكون مطالبا بالوفاء والإخلاص لضمير شعبه، المتطلع إلى قيم الحرية والعدالة والتغيير. وكما هو معلوم فإن مسار الثورة على الإرث الشعري القديم، كان يسير في خطين متوازيين ومتكاملين في آن، يتمحور أحدهما حول الشكل، حيث تم التخلص من سلطة وحدة البيت والقافية، فيما يتمحور الخط الثاني، حول ملحاحية القطع مع المضامين التقليدية، مقابل التبني اللامشروط لقيم التغيير والثورة، التي تجد تعبيرها في مجموع مقومات التحديث.
والملاحظ أن هذا الإبدال الذي استهدف ثنائية الشكل والمضمون في صيغتها التقليدية، لم يلبث هو أيضا أن تحول مع الزمن، إلى أيقونة ثابتة الملامح والسمات، رغم تعدد طبعاتها من المحيط إلى الخليج، مع استثناءات جد معدودة تمكنت من تكريس فرادتها، على أساس حظوة انتمائها العقدي، أو ممارستها التنظيرية المتميزة، كي نخلص في نهاية المطاف، إلى مشهد شعري مؤطر ببنيات شعرية مشتركة، أحادية البعد، ومنمنمة في الآن نفسه، باستثناءات جد رمزية، من شأنها الإيحاء بتعدد وتنوع مشاربه ومساراته.
ومن الواضح أن مفهوم الثورة المحايث للحركية التحديثية، المجبولة في جوهرها على التماهي مع نماذجها المتفردة والأساسية، يبدو هنا جد ملتبس، حيث يمكن حصره في إجراءات ذات طبيعة إسقاطية، مسكونة أولا وأخيرا، بالأمل في تغيير الواقع، حيث يكتفي الشعر بممارسة دور المرآة التي ينتشي فيها برؤية ملامحه الجديدة .علما أن الثورة على الواقع في هذا السياق تعتبر نسبية، لأنها سجينة ثنائية لم تتضح ملامحها المعرفية بما فيه الكفاية، وهي ثنائية الشكل والمضمون، حيث ترسخت فكرة هدم أسسها، بوصفها إنجازا تاريخيا على درجة كبيرة من الأهمية، لكن الملاحظ أن هذا الطموح حالما توصل إلى إنجاز بعض مهامه، لم يعد ثمة ما يمكن هدمه من جديد، فبالنظر إلى التضخم الملموس الذي رافق سؤال الهدم، فإنه أثر سلبا على إمكانية الوعي بما قد يكون أكثر أهمية، ما أدى «ويؤدي» إلى تأجيل القضايا المستوجبة لتغليب غاية البناء والتشييد، خاصة أن الذات مأخوذة كلية بالأمل في هدم قرون طويلة من كوابيس التسلط، والهيمنة التعيسة. علما أن إشكالية الهدم في السياق الذي نحن بصدده، تنهض أساسا على أرضية الوازع الجماعي، وليس انطلاقا من قناعات ذاتية وفردية، وهو الوازع الدخيل والغريب عن أي ممارسة شعرية وإبداعية.
فالإجماع على جدوى الهدم المشترك للشيء، يلغي حتما إمكانية الإقرار بأهمية الحضور الشخصي للمشروع، وهو حضور فعلي يصعب تجاوزه، أو التقليل من أهميته على حساب الانسياق مع فكرة التقديس الأعمى لسلطة الحشود، وبالتالي، فإن هيمنة مقولة الإجماع، تعني الغياب العملي لأي مشروع ذاتي مفكر فيه، عدا مشروع الهدم، وهو في جميع الأحوال سيظل بدوره مؤجلا، بالنظر لحتمية الاصطدام بعائق الحمولة القاصمة التي يتميز بها الموروث، والحافلة بكل أصناف المقدسات التي لا تلبث أن تعلن عن ظهورها، كلما توهمنا أنها شارفت على نهايتها وزوالها، فضلا عن غياب الاستعداد المعرفي الكافي لمساءلة ومحاورة مكونات هذا الإرث، والمؤثر سلبا في إمكانية بلورة مقاربات مستوفية لشروطها المعرفية والمنهجية، مع التذكير بأن إنجاز المشاريع الجماعية والمشتركة، يتطلب توافر شرط السلاسة والمرونة التي لا قبل لشعرية التأمل بها. وذلك هو السر في تمحور المشترك حول الجزئي والثانوي، كحد أدنى من مستويات التعاقد المنصوص عليه بين الفاعلين، الشيء الذي يقلص من عمق واستمرارية مردودية هذه المشاريع ككل، مهما كانت مندرجة في سياق براغماتي وعملي، إلا أنها ومع ذلك، تتميز بمكانتها الخاصة، مقارنة بمشاريع الإبداعات الفردية، التي تظل من وجهة النظر الجماعية، محض انزياحات شخصية، مفرطة في ذاتيتها، لا أقل ولا أكثر. ما يضعها خارج نطاق ما هو مندرج عادة في خانة «المشاريع التغييرية» الموجهة عادة بمقولة الصالح العام، بصرف النظر عن خصوصيتها الإبداعية.
وهنا تحديدا، يمكن التركيز على تلك المحنة الجديدة المتمثلة في وقوع التجارب الحداثية الهاربة من رتابة التشابه التقليدي، في ورطة رتابة مضاعفة، قوامها اجتراحها المشترك للمسارات الأكثر نأيا عن متوقع القراءة، انطلاقا من إصرارها على توسيعها لهوة القطيعة الفاصلة بينها وبين التجارب المهتمة أساسا بمغازلة حماس الجماهير، وإرضاء تطلعاته. بمعنى أننا والحالة هذه، قد انتقلنا من حيز تشابهي مؤطر بمقوماته التقليدية، إلى حيز يبدو من حيث الظاهر مغايرا، عدا أنه مؤطر في جوهره بمقومات التشابه الحداثية.. وفي الحالتين معا يختفي مفهوم الاختلاف الذي تتأسس به حركية الإبداع الشعري.
