
عندما تمتد يد إلى مكتبة، فلا يمكن إلا أن تجد ميلا في لحظة ما إلى عنوان، قد يكون ذلك العنوان فاتحة لقراءة مجموعة عناوين تنتمي لأدب أمّة معيّنة، وقد لا يكون القصد الأول معيّنا في تلك العناوين، ربّما المصادفة أو شيء آخر. هذا ما حدث معي وأنا أجذب كتابيْ «طفولتي» و»حياتي» لمكسيم غوركي، وكنت قد اقتنيتهما منذ سنوات، ومنذ القراءة المستكشفة وجدتني أنغطس باحثا عن عناوين في الأدب الرّوسي طمرتها في رف ما، التي تعمل أحيانا على التّعمية على عناوين كي تقدّم هي عناوينها المختارة، هكذا تلاعبني مكتبتي فتخفي عناوينا وتظهر أخرى إلى أن أتمرّد على نظامها فتقودني الصّدف إلى المعنى في أدب ما، وكان هذه المرّة الأدب الرّوسي الرّفيع.
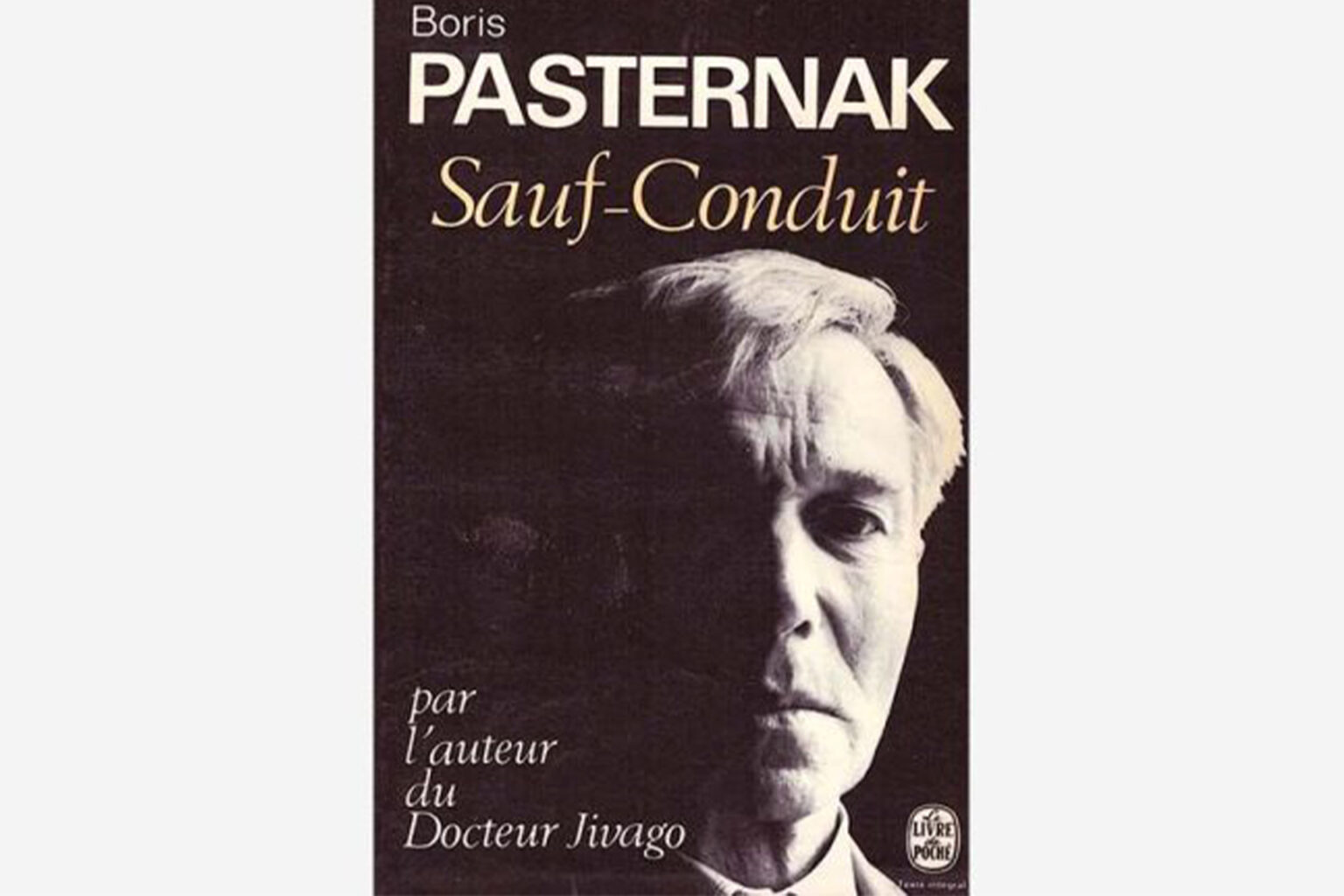
رافقتُ طفولة غوركي في مؤلّفيه السّيريين والأدبيين «طفولتي» و»حياتي» حيث يبدأ «حياتي» بالفقد، فقد الأب، لكن ليس من باب التأثر أو الذّاكرة الحزينة، ولكن من حيث المادّة التي سوف تشكل الخيال المُنهمرةُ منه الكلمات المفتونة بأسرار الحكاية، «.. أتأمل تلك الحفرة التي واروا فيها نعش أبي. والتي كان قاعها مملوء بالماء والضفادع..»، بالنّسبة للطفل غوركي، تمثل هذه الصّورة المسافة بين الدهشة، تلك التي حرّكت جماع الفلاشات المتطايرة والمتلاحقة في مخيّلة الطفل، ومنها ملازمة جثة الأب لتقافز الضفادع في عمق حفرة مملوءة بالوحل، ماذا ستفعل الضفادع بأبيه؟ المسافة بين الدهشة والكلمة التي ستصوغ المعنى مستقبلا في وعي الرّوائي. تمضي الحكاية في «حياتي» في مسار متنوّع المشاهد الحياتية في واقع الطفل، والمأساوية في مجملها، باعتباره سوف ينفصل عن أمّه التي تتزوج تاركة إياه في حضن جدّته وجدّه وأخواله، أين سيعيش المراحل الطاحنة التي سوف تعجن رؤيته للحياة والإنسان، ويبدو لي أنّ تراجيديا الطفولة وانكسارات المسار الوجودي هي التي سوف تجعله في المستقبل رفيقا للديكتاتور ستالين الذي أهداه قصرا استقبل فيه الكاتب الرّوسي الكبير ميخائيل شولوخوف حينما واجه مشكلة في الحصول على إجازة للجزء الثالث من رائعته «الدون الهادئ»، فاستجار بغوركي والذي وجده في انتظاره في ذات القصر رفقة ستالين كما يذكر أحمد شافعي في مقال له حول كتاب «مكتبة ستالين.. الديكتاتور وكتبه» لجيفري روبرتس.
شعرت أنّ غوركي بعد قراءتي لسيرته، ينظر إليّ شذرا بعد أن ذكرت علاقته بستالين، فتسحّب متراخيا من يدي يجرّ صفحات كتابه، منزويا عن أصدقائه الكتّاب الرّوس الذين طبعوا الحياة الثقافية والأدبية الروسية والعالمية، لكن رأيته يشير إلى أعلى المكتبة في آخر الرف إلى روايةٍ بغلاف ملّوّن، قبل أن تصل إليها يدي، أطلّت امرأة عرفْت أنّها «آنا كارنينا»، لم أدرك سبب إشارة غوركي لرواية ليون تولستوي، لكن دأب الأدباء الرّوس هو ذاك، حتى ستالين السياسي كان «يقرأ لأعدائه من أمثال روزا لوكسمبرغ وليون تروتسكي».
وجدت تعاطفا كبيرا مع «آنا» في الرّواية حتى وهي تخون زوجها وتمرّغ شرفه في التراب، ولكن لم أحتمل صبر تولستوي عليها، وبين تعاطف القارئ وصبر الكاتب تنتهي «آنا» إلى الانتحار تحت عجلات القطار، لم يستطع الحب أن يصمد أمام هزّات الخيبة وتوترات النّفس العميقة، في الاستقرار في قلب العشيق فرونسكي أو الأيلولة إلى حضن الزّوج كارنين، الذي كانت تتماوج في داخله أحاسيس ملتبسة وعواطف متصارعة، إلى درجة أنّه توصّل إلى تقبّل الاعتراف بالخيانة من زوجته كإعلان عن التخلص من حملٍ أثقل كاهله، «تبا لها ! لم أحقد عليها؟ أليست زوجتي امرأة كسائر النّساء !» هل كان كارنين يحب زوجته إلى الدّرجة التي يتنازل فيها عن كبرياءه الرّجولي في وسط برجوازي تحكمه تقاليد وأعراف العفة والوفاء في العلاقات الزوجية؟
تمثل رواية «آنا كارنينا» ميثاق قيمي يتشكل داخل مخيال تولستوي المكثف بــ «التحسين الأخلاقي» كما ورد ذكره في رواية «جناح مرضى السّرطان» لسولجنتسين. آنا كارنينا تمثل لعبة الحياة حين تتقاذفها رياح النّزوة والتشبث بالقيم، لكن الرّغبة في الانطلاق وتجريب الحياة في أفق التحرر المبالغ في التأكيد عليه، جعلاها شخصية تمسك بخيوط الرّواية وتنفلت أحيانا من توجيه تولستوي، ولهذا تفاجأت من صبره عليها. لكن يبدو أنّ هذا الصبر كان برنامجا سرديا لتسيير مسارات العائلات التي تعيش وضعا مخمليا لكنّها تقبع في درجة واحدة من الصّراع يسم سلوكاتها بالسلبية، وهو ما هرب منه تولستوي في حياته الواقعية، باعتباره أحد الأخلاقيين الذين يمجّون مظاهر الزّيف المادّي البرجوازي.
لم تستطع «آنا» أن تسكت عما كان يمثله تولستوي من قيم أدبية وفكرية، فأشارت بأصبعها إلى كتاب «ما هو الفن؟» لتولستوي الذي كتبه عام 1898 وترجمه تيودور فيزفا في نفس العام، طبعة 1918، والكتاب عبارة عن عصارة فكر تولستوي في التعبير عن حالة «التحسين الأخلاقي»، حيث حطّ من قيمة «الفن المعاصر» في زمانه ودعا إلى «الفن الديني» الذي يوحّد البشر ويبتعد عن فن الطبقة المخملية الذي يأتي استجابة لرغبات أشخاص دون إحساس داخلي ينتقل من الفنّان إلى النّاس، بمعنى افتعال الفن، ويتساءل عما إذا كانت السمفونية التاسعة لبيتهوفن تعبر عن إحساس ديني لنظام متسامي؟ وهو لا يرى ضرورة في أن يشمل الغموض الشعر، ويرفض أي فن يتعرّض إلى العري. في هذا الكتاب يبدو تولستوي فاصلا في علاقة الأرثودكسية الدينية بالمسار الوجودي للإنسان الذي يعيش في كنفها، هذا في مواجهة التحلل الأوروبي من علائق النّداء الروحي.
بوريس باسترناك كان حاضرا بكتابه «جواز – مرور»، الذي ذكر فيه العناصر التي عبرت به إلى فضاءات الشّعر، تنقّل بين الموسيقى والفلسفة إلى أن استقر على شواطئ الشعر، مستأنسا بصداقة أكبر شعراء روسيا «ماياكوفسكي» الذي مات منتحرا. ما فتئ باسترناك يردّد المقطع من قصيدة «سحابة سروال» لمياكوفسكي الذي ورد في مكالمة هاتفية والتي أعلن فيها موته:
«الأنا» الذي صرته أصبح صغيرا علي/في صدري أحدهم /يسعى لفتح طريق/آلو.. أنت على السماعة، يا أمي؟ /أمي، ابنك يموت بشكل رائع.
جواز مروره إلى الشّعر كان عن طريق «رفض الطريقة الرومانتيكية»، «وتخفّت خلف رفضه هذا رؤية للعالم. كانت رؤية للحياة باعتبارها حياة شاعر».
يحمل باسترناك في كتابه «جواز – مرور» رؤية للوجود في القصيدة دون افتعال القصد إليها، كان يتعلم الموسيقى بإيعاز من والديه ولكن وجّهه أستاذه إلى الفلسفة ومنها كانت أوبته إلى الشعر، الذي انعجنت فيه رؤيا الفلسفة وطراوة الموسيقى.
وجدت بين يدي «ألكسندر سولجنتسين» وروايته «جناح مرضى السرطان»، التقاه بيرنار بيفو صاحب البرنامج الثقافي الفرنسي الشهير «حساء ثقافة» الذي يذكر أن سولجنتسين أخبره بأنّ: «يقين العودة لا يفارقني. إحساسي العميق أنّني سأدخل حيا إلى وطني»، كان هذا في أمريكا، وحينها كان إحساس بيفو أنّ التاريخ سيخيب يقينه.
في رواية «جناح مرضى السّرطان» يتأسّس «كوستوغلوتوف» كمعارض لــ «بول روسانوف» الملتزم الشيوعي باعتباره عنصر من عناصر الجهاز الإيديولوجي البيروقراطي السوفياتي، أما كوستوغلوتوف فهو المتمرّد داخل الجناح الذي لا يكون في النهاية سوى المجتمع الذي تسوده شمولية السلطة الاستبدادية، فسلطة الطبيب التي تقتضي خضوع المريض خرقها كوستوغلوتوف بالأسئلة المحرجة حول السرطان والعلاجات التي يتعرّض لها المرضى، العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة. أفحم من خلال أسئلته الطبيبة المسؤولة والتي تشتغل على أطروحة سوف تقدمها مستقبلا، بما يعني تحول المرضى إلى فئران تجارب. تلك هي الصورة التي حاول بها سولجنتسين نقض أركان الشيوعية وخلخلة المبادئ التي تقوم عليها السياسة الشمولية التي حكمت بها طغمة الحزب روسيا العظيمة.
«غوستوغلوتوف» المتمرّد انتهى بالعودة إلى مسقط رأسه، فهل كانت هذه النهاية هي الحنين الذي أزاح المادة وأعاد الاعتبار إلى الروح باعتبار العلاقة مع المكان؟
«مذكرات طبيب شاب» للطبيب القاص ميخائيل بولغاكوف، الذي يحكي مساره الطبي في بلدة نائية «غراتشيفكا» في مشفى «الموريفسكايا»، ثم يكشف عن الإحساس العميق للطبيب الذي يحاول الإنقاذ فقط، متجاوزا واقعه الشخصي كإنسان. وكيف أنّه وجد وحيدا في مواجهة حالات كانت معلوماته حولها قليلة، ومنها حالة «تحويل الجنين»، عاد إلى المكتبة بسرعة خاطفة متذكرا شيئا حول الحالة في كتاب «دودرليان» «عمليات التوليد». أنقذ الحالة ورجع إلى البيت مدركا «أنّ التجربة الكبيرة يمكن الحصول عليها في القرية – فكرت وأنا أغفو – ولكن يجب فقط القراءة، القراءة كثيرا.. والقراءة..».
