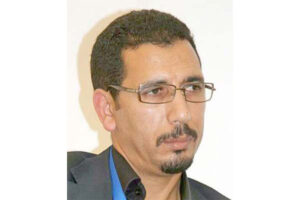
منذ أواخر التسعينيات، برزت كوكبةٌ من الشعراء الشباب يستعصي أن نجمع أفرادها داخل جيلٍ أو نحجرهم على تصنيف عقدي، كما كان جارياً من قبل، وذلك بسبب ما خلقته نصوص تجربتهم من جمالياتٍ كتابية مغايرة، عكست فهماً جديداً لآليات تدبر الكيان الشعري، مما يمكن للمهتم أن يتتبعه في دواوين شعرائها، التي أخذت تتدفق طوال الألفية الجديدة. وهذه التجربة هي ما بات يُصطلح عليه بـ(الحساسية الشعرية الجديدة) التي لم تكن لتجّب ما سبقها، بل هي امتداد وتراكم لتجارب متتالية في سياق تطور القصيدة المغربية الحديثة، بقدر ما هي تجاوزٌ لها في الوقت نفسه. وتظهر لنا هذه التجربة ملأى بالانعطافات التي تحفز شعراءها على التحرك الدائم في جسدها وأخاديدها وأضلاعها البلورية، لا يرهنون ذواتهم لأيديولوجيا محددة، أو ينضوون تحت يافطة بارزة. إنها كنايةً عن اختلاف في تشكلات الرؤية الإبداعية التي يجترحونها، وممتدة بصمت، وأوسع من أن تتأطر داخل مفهوم مغلق ونهائي مثل مفهوم الجيل، وما فتئت تكشف عن أثر التغير الذي يحدث باستمرار، لذلك، يجب أن نلتقطها ونسائلها بصيغة الجمع لا المفرد، وبالتالي نعيد اكتشاف الشعر المغربي في زمننا الراهن.
من خلال اجتهاداتهم واقتراحاتهم النصية، أبان هؤلاء الشعراء عن وعيهم باشتراطات الحساسية الجديدة، فانحازوا إلى شعريتها المختلفة التي تقوم على تنوع الرؤى وتمايزها في طرائق تشخيصها لأقانيم اللغة والأسلوب والخيال، وتكشف عن تحول في الحس الجمالي، وفي مفهوم الذات والنظر إلى العالم، وفي تقنيات التعبير الفني حسب أشكال الكتابة ودوالها المهيمنة. وهكذا، فإن الارتباط بعامل الزمن لا يعني لنا من قيمة إلا بمدى قيمة الشعراء المتحركين داخله، ودرجة حضورهم فيه.
وفي هذه السياق، يمكن أن نسائل نصوص الحساسية الجديدة من منظورات متنوعة؛ أي من حيث تكوينها، ومصادرها، وعلاقتها بتطور القصيدة المغربية الحديثة، وبالأيديولوجيا، والتراث، وحجاب النقد، وغير ذلك.
عبد الكريم الطبال: الطـريق المُضاء
أسطورة مصرية قديمة يحكيها لنا بورخيس عن سمكتين ذهبيتيْن مقدستيْن كانتا تسبحان في مركبهما على مشهد الخطر أمام سفينة الإله شمس. فكان مجراهما في السماء من الشرق إلى الغرب بدءاً من الفجر إلى الغروب، وليْلاً كان مجراهما يتخذ وجهته من تحت الأرض في الاتجاه المضاد بدءاً من الغروب إلى الفجر. ربما هذه الأسطورة هي أسطورة الشعر نفسه، فمركبه وإن كان واحداً فإنه يجري في فلكين هما فلك المطلق أو السماء، وفلك المحدود أو الأرض مرةً في هذا ومرةً في ذاك. وقد يرحل مركبهُ النشوان، وهو نشوان دائماً في الفلكين الاثنين معاً في المرة الواحدة. فكل شيء هو كل شيء كما يقول ابن عربي، فالشعر كان دائماً له ظاهرٌ في الأرض، وله باطنٌ في السماء.
هكذا كانت سيرة الشعر منذ أن كان الشعر قديماً وحديثاً، لا جيل فيه ولا أجيال. هو دائماً مركب نشوان يجري في الفلكين الاثنين معاً أو مفردين. ولذا أرى أن مصطلح التجييل قد لا يكون مقبولاً في غير التأريخ والأَجْرأة، أما ما عدا ذلك ففي ذلك مجازفة، وأي مجازفة. وحتى ما يسمى بالحساسية الشعرية لا تعني عندي سوى السيرورة والتحول والاجتراح. فالشعر كما أراه سفرٌ مستمر لا واحات له في الرمل، ولا مرفأ له في الماء. الشعر طائرٌ سائرٌ في سماء مكتظة بالأصوات فيها الرخيم، وفيها الرخو، وفيها الصلب، وفيها اللين. وفيها القوية، وفيها الضعيفة. وكلها جميعاً سمفونية واحدة لا تنتهي. وقد لا تخلو من نشاز بين فترة وأخرى. وفي تقديري أن هذه الجمهرة من الشعراء الشباب في قلب الطائر المرفرف دائماً. وبينهم المهرة في الغناء، وبينهم الذين يتعلمون المبادئ الأولية، وبينهم من ليس من أولئك ولا من هؤلاء.
والقضية في ما أرى ليست في اختلاف قصيدة النثر عن قصيدة التفعيلة، أو عن القصيدة العمودية، فننسب الحداثة إلى هذه ونسحبها عن تلك، بل إن القضية أساساً في جوهر الشعر الذي هو كامنٌ في اللغة، ومن قبل ذلك كامنٌ في الرؤيا. هنا الاختلاف بين الشعر وسواه، بين الحداثة والقدامة. وفي تقديري ـ حسب متابعاتي المستمرة – أن هذا الشكل الشعري الجديد تتقدمه أسماء مشعة لا يخفى ضوؤها حتى عن الأعشى. وعلى هؤلاء الأمل في العزف الرحب الرخيم العميق الذي يعلو على كل نشاز.
وتبقى أسطورة الشعر التي تشبه أسطورة السمكتين، إن ْكانت تبدأ بالسفر في المركب، فإنها لا تنتهي أخيراً إلا بالوصول إلى مدينة فاضلة، أو إلى الإنسان الكامل، أو إلى عشبة الخلد أو إلى إهالة التراب على القبح في العالم، ووقتذاك فقط سينتهي السفر.
رشيد يحياوي: قصيدة النثر قيمة مضافة
في تصوري، فإن ضمن بدايات ما يندرج تحت مسمى «التجربة الشعرية الجديدة» الشعر المنشور من طرف شعراء سُموا في الثمانينيات بـ«الشعراء الشباب». فقصائد هؤلاء تدخل ولو في شكل ملامح أولية في التجارب الجديدة للشعر المغربي، لأن هؤلاء الشعراء كان لديهم وعي بكونهم يكتبون قصيدة فيها اختلاف عن القصيدة السبعينية.
وهذه الحالة ليست خاصة بالمغرب، بل نجدها في شعر دول عربية أخرى أيضا، وإن كان مصطلح جيل الثمانينيات أكثر حضورا في منظوراتها النقدية من المغرب. فما سمي بالشعراء الشباب ضم – مغربيا- مزيجا من شعراء سبعينيين متأخرين، وآخرين لم يبرزوا شعرياً سوى في العقد الثمانيني. وفي الفترة ذاتها ظهر ما يفيد الميل نحو التجديد متمثلا في ما أطلق عليه نعتا «أدب الشباب» و»الكتابة الجديدة». غير أن الفرز بين شعراء هذه التجربة ستتضح معالمه في التسعينيات، حيث سيتجه عدد منهم نحو قصيدة النثر، فيما بقي الآخرون ضمن قصيدة التفعيلة. ومع أن الغالبية كانت لديها رغبة في التجديد ووعي بضرورته، لكن شعر قصيدة النثر هو ما دفع بعد ذلك للحديث عن وجود حساسية جديدة في الشعر. لا يمكن هنا التغاضي عن أمرين؛ الأول أن شعراء قصيدة التفعيلة المجددين توجد في قصائدهم عناصر من هذه الحساسية الجديدة، والثاني أن الحديث عن أي تجربة شعرية أو حساسية جديدة لا يستقيم ربطه بالشعراء حديثي السن وحدهم، لأن بعض الشعراء من الأجيال السابقة، وإن قل عددهم، فقد أسهموا فيها بدورهم.
لذلك يمكننا القول إننا أمام تراكم من توالي التجارب الشعرية في القصيدة المغربية المعاصرة. والتوالي لا يتنافى مع التجاوز، لأن التوالي يدرك بملاحظة وجود انتكاس أو وجود تقدم. والانتكاس مستبعد، لإفادته رجوع الشعراء في فترة ما، نحو الكتابة من منظور تجارب سابقة بشكل شبه جماعي، أو بشكل يكون فيه الانتكاس بينا. والحاصل أن القصيدة المغربية ما فتئت تسير من تجربة نحو أخرى مغايرة تتطلع لتجاوز السابقة كليا أو جزئيا، مع أن التجاوز الكلي يعني إحداث قطيعة وهو ما ليس هيناً في الشعر. فلإحداث قطيعة ينبغي أن ينتظم شعراء محددون في مدرسة أو تيار شعري معلن عنه وعن أهدافه، كما حدث في الشعر الفرنسي بظهور الدادائيين والسرياليين مثلا. إلا أن القطيعة شعريا، ومهما تم تعميق الأخاديد الفاصلة بينها وبين غيرها، لا يمكنها إلغاء رواسب آتية من تجارب سابقة، لأن اللغة والشعر، لكل منهما ذاكرة يستحيل محوها كلياً.
وإجمالاً، فإن الحساسية الشعرية الجديدة هي ناتج حساسيات شعرية جديدة مختلفة إلى حد التباين أحيانا. وذلك على أساس أن ما يمكن عده مكونات وتمظهرات لهذه الحساسية له أكثر من صيغة للتبَنْيُن نصيا من حيث الكم والكيف والمنظور في قصائد الشعراء. وهؤلاء هم أكثر من جيل. فالشعراء الذين قد يوصفون بكونهم شعراء حقيقيين هم من استطاعوا التقاط مؤشرات التحول في الأنساق الثقافية والفنية، بما فيها الشعرية، وبقوا ضمن دائرة مفتوحة للبحث المتواصل في خطاب القصيدة، ولا يكاد يوجد من يخالف في انتمائهم إلى راهن هذه الحساسيات الشعرية.
عمر العسري: مشروع إعادة البناء
بدأ الشعر المغربي، في نهاية تسعينيات القرن العشرين، ينزع نحو أراضٍ إبداعية جديدة، كان سببها انفتاحه على مختلف الثقافات والعلوم والفنون، وهذا الانفتاح لم يكن بنية الابتعاد عن الأصول، بقدر ما كان هاجسه خلق امتدادات لقصيدة مغربية جديدة. هذه القصيدة التي تجاوزت المرحلة التاريخية والأيديولوجية، بل خلصتها من مفهوم الجيل الذي كان عملة تصنيفية بامتياز. لقد تبنتْ هذه التجارب الجديدة مفهوم الكتابة، ولا شك في أن هذا التوجه يجد سنداً له في الأعمال الشعرية الجديدة التي انطلقت منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي لتؤرخ لمرحلة أخرى، وفي إطار هذا المد لا شك في أن الرؤية التاريخية والنقدية يجب أن تتجاوز المعالجة البنيوية اللسانية، وتدعم الطرح الذي يسعى إلى تحديد الأنساق وتفسير الفعالية الشعرية المترجمة لهذه الحساسية الجديدة.
عكست التجارب الشعرية الجديدة في المغرب رؤية طلائعية بامتياز، ولم توقف زمن الأصول، وإنما اشتغلت عليه وغيرت في مظهره، لأن زمن الكتابة داخل في حدود القصيدة، يمر على نحو مختلف عنه في التاريخ، أو ما ندعوه الحياة الواقعية. إن التاريخي والسياسي كانا أقوى محورين تجاذبا القصيدة المغربية في منتصف القرن الماضي، وعطلا فردية الشاعر وخبرته الروحية، فصار مُلحاً على التجارب الجديدة البحث عن آفاق جديدة للقصيدة، فتطلب الأمر تقصي القصيدة في ضربها المهاري، اللغوي والخيالي المدعوم بالذكاء؛ وامتد هذا السياق بأقنعة مختلفة تأخذ أصباغ كل شاعر، حسب رؤيته ومنطلقاته الجمالية.
يمكن القول إن شعراء الحساسية الجديدة في المغرب يهدفون باستمرار إلى إعادة بناء إدراكنا الاعتيادي للواقع كي يؤسسوا لنا رؤيتهم للعالم بدلاً من مجرد توصيفه، لأن الواقع أحياناً أبلغ من اللغة. والتحول ذاته بَشر به بورخيس وأوكتافيو باث، وبيتر تشايلدز، ووالاس فاولي وغيرهم. عندما توقفوا، سواء في منجزاتهم النقدية أو الشعرية، عند الوعي الجديد للكتابة الشعرية، والمنحى الذي سار عليه الشعراء الجدد الذين اقتحموا أبواب القصيدة في اتجاه الشعر.
محمد ميلود غرافي: مآزق التجديد
بدا المشهد الشعري المغربي، خصوصاً منذ بداية القرن الحالي، خليطاً من الأصوات التي لم تقطع علاقتها بالإرث الشعري العربي التفعيلي، إلا لتسقط في تقليد أبشع لقصيدة النثر الغربية (والفرنسية خاصة) عبر الترجمة التي لم ترْقَ دائماً إلى صياغة القول الشعري الفرنسي أو الإنكليزي في تركيب عربي، وأنتجت أنماطاً من القول ليست في آخر المطاف سوى إعادة إنتاج لتراكيب الجملة الفرنسية أو الإنكليزية. وإذا ما قارنا شعراء قصيدة التفعيلة لأجيال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وحتى ما تلاها بقصيدة النثر المغربية والعربية عموماً، فإننا نلحظ قصوراً ثقافياً وفكرياً بارزاً عند الكثير من الأصوات المحسوبة على قصيدة النثر تتمثل في انعدام أو قلة المرجعيات الثقافية عربية أو غربية، وكذلك فقراً في تصور للشعر وماهيته أدى إلى استسهال للقصيدة، ما جعل من هذه الأخيرة في غالب الأحيان خطاباً سطحياً أقرب إلى الخاطرة منه إلى الشعر.
ومن مظاهر هذه الأزمة أيضاً، وهذا بالنسبة إلى جميع الحساسيات الشعرية، هو عجز النقد المغربي عن متابعة الإنتاج الشعري أو عدم رغبته في هذه المتابعة خارج حلقة الأسماء التي فرضت نفسها من داخل اشتغالها بالصحافة أو تبوئِها مراكز القرار الثقافي بالبلد أكثر من صيتها الشعري. لدينا في المغرب إما «نقد» مجاملات يقول الشيء نفسه عن كل النصوص التي يقاربها، أو نقدٌ تطبيقي همه تبرير النظريات الشعرية أكثر مما تهمه النصوص نفسها. وبينهما تبرز بين الحين والآخر بعض المقاربات الجدية للنصوص، لكنها قليلة. وأعتقد أنه في غياب نقد يتابع بعمق وصدق تطور القصيدة في علاقتها بالواقع والتراث والآخر، لا يمكن للممارسات الشعرية أن ترى بوضوح تشكلاتها ومحطاتها وآفاقها؛ ليس لأن الشاعر يحتاج إلى الناقد كي يبدع، بل لأن النقد الناجع يساهم في الحوار ويطعم النقاش حول قضايا الشعر والأدب بصفة عامة.
