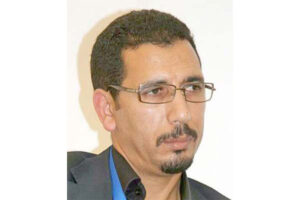
الرباط- «القدس العربي»: ظلت حركة النقد الشعري في المجال العربي، منذ بدايات القرن العشرين، هي التي تقود مشروع التحديث الثقافي، الذي لم يفصل طروحاته وقضاياه الكبرى عن تجديد أسئلة النص والنظرية، واللغة والفكر والمجتمع، من منظورات معرفية ونقدية كانت تتجدد على الدوام بتجدد مناهج النقد الأدبي وإوالياته في القراءة والتأويل. ومن يرجع إلى كتابات دارسي الشعر العربي، ولاسيما بعد نشوء حركة الشعر الحر التي مثلتْ في حد ذاتها حافز التغيير الكبير، وما صاحبها من معارك وسجال أدبي منقطع النظير، لا يعوزه النظر لاكتشاف أصالة هذه الكتابات ونوعيتها الخاصة؛ لما كانت سلطة معرفية وقيمة حضارية بالغة الأثر. وإذا كان أصحابها قد فارقوا الحياة تِباعا، فما زالت مشاريعهم واجتهاداتهم النقدية تواصل نداءها وتختط مسارها بيننا، في قلق وعنفوان حينا، وصمت وارتياب حينا آخر.

ثمة في أيامنا شبه إجماع في أوساط المهتمين على أن نقد الشعر ليس في أحسن حالاته، وبتنا نسمع مثل هذا الكلام: «الشعر في كل مكان، لكن لا نقد»؛ فماذا يحصل بالفعل؟ وبعبارة أوضح، على من تقع مسؤولية تراجع نقد الشعر؟
من الادعاء القول إن ثمة تحديدا دقيقا في وصف حالتنا النقدية، وفي تشخيص أعطابها ومراجع أزمتها المستفحلة، غير أن أبرز أسباب التراجع في السنوات الأخيرة تتمفصل بين أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، أي يمكن التمييز فيها بين ما هو كمي وآخر نوعي. فمن جهة أولى، هناك ما يتصل بالشعر في علاقته بالشعر نفسه ووضعه الاعتباري، أو في علاقته بالأجناس الأدبية، وفي مقدمتها الرواية. وهناك ما يتصل بواقع النقد في علاقته بالنظرية الأدبية وبالمؤسسة الأكاديمية، أو في علاقته بسوق التأليف والنشر وطرق تداوله وقراءته، بل في نظرة الناس إلى الشعر في عالم لا شعري.
رغم الهجرة من الشعر، تنظيرا وممارسة، إلى غيره من أجناس التعبير الأدبي والفني، فما زال بيننا نقاد أوفياء لدرس الشعر، ما فتئوا يجددون في خطابه النقدي والمعرفي، بقدر ما يقترحون صيغا جديدة لمقاربته وتأويله وتنشيط زمنيته الكبرى. وفي هذا السياق، سألت «القدس العربي» بعض نقاد الشعر من هؤلاء الأوفياء: ألا ترى أن نقد الشعر الذي نشط في العقود السابقة، قد تراجع بشكل ملحوظ؟ هل ثمة من أسباب فنية وموضوعية وراء هذا التراجع من لدن النقاد والأكاديميين؟ في المقابل، هل تعتقد أن خفوت صوت الشعر وعزوفه عن القضايا الكبرى هو الذي جعل الناس لا تهتم به؟
منصف الوهايبي: تردي الذائقة
أنا معك في أن النقد غاب أو يكاد، بل حل محله البحث الجامعي الأكاديمي. وشتان بينهما، فالنقد عمل فردي ورؤية واختيار، وخبرة وتمرس أو مراس؛ وهو من ثمة سلطة، أما البحث فعمل يشارك فيه الطالب الباحث والأستاذ المشرف؛ وهو يعد للجنة علمية تناقشه و»تجيزه»، وليس للجمهور أو للقراء عامة. وبإمكان أي طالب أن يكون «باحثا»، لكن ليس بميسوره أن يكون ناقدا؛ بالمعنى الذي ذكرته. ومشكلة الشعر العربي اليوم، أن الذين «يُعنون» به هم من الباحثين الذين تتفاوت بحوثهم من حيث القيمة والإضافة، وليسوا من النقاد؛ وأعرف من الجامعيين، ناهيك عن «الشعراء» من لا يميز بين «قصيدة تفعيلة» وقصيدة نثر» و»قائمة الطعام». والأمر راجع في جانب لافت منه، إلى «تردي» الذائقة، وعدم التمييز بين النص «القوي» والنص «الضعيف» أو «المتهافت». والذائقة ليست مجرد انطباعات أو ارتسامات، وإنما هي محصلة خبرة ومراس وإيلاف النصوص. ولعل الأقرب أنه يرجع إلى قلة محصول من الشعر، ومن الثقافة؛ وربما إلى «ارتباك» ما في منظوماتنا التعليمية.
حال النقد من حال شعرنا اليوم، وهي لا تدرك في سياق الزمنية الخطية؛ وإنما في سياق الزمنية الشعرية.
مشكل النقد أو «القراءة» إذا شئنا أن أكثر شعرنا اليوم، يفتقد هذا «الحوار» حتى يكون منشدا إلى نفسه مثلما هو منشد إلى سابقه؛ لكن من غير أن يكون نوعا من «شعرية المناويل» التي تفسد الشعر. والشعر الأبقى هو المشرع على لاحقه؛ أو لأقل هو الذي ينشأ «قرائيا». وعليه أقدر، والأمر يحتاج إلى تنسيب، أن القراءة هي التي تحل اليوم محل النقد، من حيث هي نفسها استئناف لإنشائية الأثر، والأثر الشعري هو في صميمه ذو طبيعة «قرائية»؛ فهو لا ينشأ كتابة أو تشكيلا أو تنغيما. ثم يُقرأ. إنما هو مثل النقد ينشأ قرائيا، وهو يَقْرأ مواده وخاماتِه وكل ما يدور في فضائه. لكنه يقرؤه أساسا، حسبما تمليه عليه طبيعة جنسه، وحسبما يستعيره من عناصر من تراثه، أو من الأجناس الأخرى، أو المؤثرات التي ألمت به.
هدى فخر الدين: الشعر سابقٌ على النقد
لا ثقافة عربية بلا علاقة مع الشعر العربي وتراثه. فاللغة العربية تفكر وتتخيل وتتفلسف وتنظر وتظل فتية وعصية على الدهر بالشعر. والأشكال الأدبية لا تكون عربية فعلا إلا إذا استفادت في جانب، ولو بسيط، من ثقافة شعرية أو علاقة أو تفاعل مع الشعر العربي. وأشمل بذلك الأشكال الحديثة أو المستجدة كقصيدة النثر طبعا، وحتى النثرية منها كالرواية والقصة والمسرح. فتلك وإن نشأت على نماذج غير عربية من جهة، أو اعتمدت على سوابق في التراث النثري والسردي العربي من جهة ثانية، إلا أنها تكتسب بُعدا عربيا خاصا، وتكون أرسخ وأعمق وأكثر إقناعا في المستوى اللغوي، إذا كان كتابها أصحابَ ثقافة شعرية عربية.
الشعر لا يخدم قضايا خارجه. القضية النبيلة العظيمة لا تصنع قصيدة عظيمة، بينما القصيدة العظيمة عظيمةٌ بمعزل عن موضوعها أو قضيتها، بل تكون في كثير من الأحيان قادرة على جعل العادي عظيما من خلال إعادة خلقه في الفضاء الشعري، فيصير الموضوع مهما كان بسيطا وعاديا أداة للتفكير في اللغة والوجود والشعر نفسه. الشعر يعيد خلق الواقع والتجربة من خلال أساليبه وطرقه الخاصة في التفكير، ولهذا يكون قادرا على تصوير التاريخ والتعليق عليه وانتقاده وتحديه وتصويبه بطريقة مغايرة. وهنا تكمن قدرة الشعر الفكرية.
أما في ما يتعلق بالنقد، الشعر دائما سابق ومتقدم على النقد. وهذا جلي في كل الأزمان. النقد يجهد دوما لمجاراة الشعر المتقدم عليه. والنقد الحقيقي هو الذي يعي حقيقة أن الشعر تجاوز مستمر، تجاوز إبداعي لكل ماضٍ بما في ذلك ماضي الشعر نفسه. ويظل النقد قاصرا وسطحيا إذا ظل معنيا بما يقوله الشعر، لا كيف يقوله. إذ لا جدوى من قصيدة تقول ما يمكن أن يُقال خارج القصيدة.
أجيب عن سؤالك وفلسطين في بالي، في هذه اللحظة الفارقة في حياتنا كعرب. وأعود وأقول، الوفاء الشعري لقضية محورية مثل فلسطين، يكون بالإخلاص الفني لها وعدم التعكز عليها والتهاون الفني بما يكتب عنها. فالكتابات التي تتعكز على القضايا الكبيرة لتخفيَ ضعفها اللغوي وضحالتها الفكرية والفنية ليست شعرا، بل هي ابتذال للشعر وللقضايا المهمة في آن.
حاتم الصكر: أعطاب الممارسة النقدية
عليّ أولا أن أتوقف عند ما في السؤال من كمائن وتفاصيل تتشابك وتزدحم. ليس النقد الشعري وحده موضوع تساؤل واتهام (بالتراجع)، فالشعر ذاته كمادة للممارسة النقدية غدا كما وصف السؤال يعاني من (خفوت) صوته، وعدم اهتمام (الناس) به. يضع السؤال المسألة الجمالية حول الشعر ونقده في موضع الترابط، وهذا يوفر الكثير من عناء التفصيل في الإجابة. فالنقد الشعري مرتهن بالمعدل النوعي للشعر، وبشكل أدق في تشكلات البنية الشعرية في القصيدة، لأن الحكم على الشعر كجنس أدبي، ستأخذنا لتاريخية لا تقدم عونا في تفحص حاضر الإشكالية المفترَضة: خفوت الشعر وتراجع النقد. وإذا ذهبنا إلى جزئيات السؤال، فسأرد على (الوفاء للشعر) بالقول إنه رهان على جمالياته التي تعيد التوازن للحياة في خضم اختلالاتها وارتباكاتها وخساراتها. فالتمثيل الشعري للحياة يهبنا تلك الفسحة الضرورية لإيجاد البديل الخيالي والعاطفي والنفسي للإنسان، وهو يصارع أزماته التي تبدأ من الموت والأمل، ولا تنتهي عند الخلل العارم في موازين العدالة الغائبة. فالتعويض الجمالي للشعر لا يمكن الاستغناء عنه، رغم ازدهار الوسائط والمقترحات الرقمية وتطور سبل القراءة وتعدد كيفياتها. لأن الشعر هو الممكن الوحيد و(الملاذ الأخير) كحلم إنساني. أما نقد الشعر فإنه يتأثر بالانصراف الحاد نظريا وعمليا عن أدبية النقد، لصالح العودة للخطابات الاجتماعية، وربط الكتابة بالمُشغلات غير الفنية والجمالية، بل وصل خطر هجر الأدبية النقدية إلى حد تسفيه جماليات الشعر وفنون كتابته أيضا. وربما إعلان عبث كتابته أحيانا في وهم تفوق الأنواع الأخرى عليه كالرواية. وامتد هذا الانغمار في التحليل الثقافي المفرط في نسخته العربية إلى الدرس الأكاديمي، فأمطرتنا الجامعات برسائل ودراسات ومناهج دراسية تبحث عن الأنساق في الشعر، كدلائل جرمية لإدانة خطابه أصلا، وانتزاع مفردات النصوص للحكم على معانيها الجزئية لا دلالاتها الكلية، لاكتشاف تلك الأنساق التي تغفل النسق العام المتحكم في الكتابة الشعرية ذاتها، وما يحف بها من اشتراطات. ويلي ذلك تقلص قراءة الشعر بما هو فن أولا، ورفع الغطاء المجازي عن الجمل الشعرية وتجاهل بلاغتها، لالتقاط مؤشرات اجتماعية وسياسية، في عودة للخطاب العقائدي الذي عطل الحداثة الشعرية عقودا طويلة في العصر الحديث.
لقد عملتُ مؤخرا على جمع نصوص شعرية تلائم قناعتي بأن قصيدة الحداثة ممثلة بقصيدة النثر، دخلت في مساءلة ذاتها بوعي الشاعر ورؤيته، حتى صارت القصيدة مادة وموضوعا لنفسها عوضا عن الأغراض والموضوعات الكبرى. وفي هذا العناء الميتاشعري، رصدتُ أصواتا ورؤى وتمثلات ترقى بالقصيدة إلى مستوى المدونة الفكرية والجمالية معا. وهذا يشير لدخول القصيدة مناطق جديدة في مسيرة الشعرية العربية الراهنة.
حورية الخمليشي: ضرورة تجديد آليات القراءة
يجب أن لا يبقى الشعر رهين الدرس الجامعي الأكاديمي. لذلك سعيْتُ، في مشروعي النقدي، إلى فتح النقد الشعري على آفاق جديدة في القراءة والتأويل. فنشرتُ العديد من الدراسات التي تجمع بين ما هو معرفي وأكاديمي وإبداعي وفني. ما استدعى منا دراسة الفن والجماليات، والاهتمام بكُتُب التراث الصوفي العربي والفلسفة، ومتابعة ما جد في درس الشعر الحديث. والتصنيف الأجناسي للقصيدة العربية و»سؤال الكتابة» وما أثاره من جدل في الثقافة الشعرية العربية الحديثة. وما أفرزته الحداثة من ثقافة شعرية وفنية متفاعلة مع الشعر العالمي. وهو ما ساعدني على ابتكار ميدان مفهومي خاص بمشروع «شعرية الانفتاح»، أي انفتاح الشعر أدبيا وفنيا وجماليا على باقي الأجناس الأدبية وعلى الفنون البصرية بمختلف أنماطها. فمن الشعر تستمد الفنون جماليتها.
صحيح أن النقد الشعري يشهد تراجعا من حيث عدد الدراسات بالنسبة لما عرفته حركة النقد الشعري في العقود السابقة، وبالنسبة لِما عرفناه مع ناقدات ونُقاد كبار حينما كان النقد الشعري سلطة معرفية، كسلمى الخضراء الجيوسي، وخالدة سعيد، وطه حسين، ومحمد مندور، وعز الدين إسماعيل، ومحمد النويهي، وغيرهم. وهذا لا يمنع من أن هناك اليوم دراسات جادة في مجال الشعرية العربية في ظل ما يعرفه الشعر من تفاعل بين الشعري والفكري والفني. وقد سبق لي أن تحدثت عن هذا في العديد من المنابر والدراسات. ولعل من أهم أسباب هذا التراجع عدم تجديد آليات القراءة، بالإضافة إلى ثقافة كل من الشاعر والناقد. فالشاعر الثقافي يستدعي الناقد الثقافي. لأن الشعر لغة الفكر والإحساس ولغة انسجام الجسد والفكر. والناقد اليوم يجب أن يكون مُلما بالعديد من العلوم، والمعارف، وجماليات الفنون، خاصة في ظل انفتاح الشعر الحديث والمعاصر على أجناس القول وأنماط الفنون البصرية، وفي ذلك تأسيس للقراءات المتعددة للتأمل والبحث، لأن النص الشعري يتجاوز مبدعه ويتجاوز قارئه؛ ما يعني أن ما يسمى اليوم «بالقراءة العاشقة» لم يعد كافيا لقراءة النص الشعري الذي يقتضي قراءة عالمة ومبدعة وعاشقة.
كيف يخفت الشعر وهو يسكن دواخلنا ويلازمنا بحثا عن الحب والحياة السامية التي لم نجد لها طعما في الحياة المعاصرة. إنه بمثابة الخيط الرفيع الذي يمنح المعنى لكل مرحلةٍ من مراحل عمرنا، بذلك يظل دائما متوهجا متحديا الزمان والمكان. فالشعر لم يفقد حـــضوره البهي في حياة الناس وعند كل الأمم والحــــضارات.
