
على بعد ثلاثمائة ميل وأكثر من جبل تشيمبورازو، ومائة ميل منثلوج جبل كوتوباكسي، في البراري الجرداء لجبال الأنديز في الإكوادور، يقع ذلك الوادي الجبلي الغامض، المعزول عن عالم البشر؛ إنه «بلد العُميان». قبل سنين طويلة، كان ذلك الوادي لا يزال مفتوحًا على العالم، بحيث كان يمكن للناس أن يَفِدوا إليه في النهاية، من خلال شعابٍ مسكونة بالرعب، وعبر ممرٍّ ثلجي يوصل إلى مروجه المستوية؛ وهكذا أتى إليه بعض الناس بالفعل؛ كانوا عائلة أو نحو ذلك، من ملوَّنين بيروفيِّين فارِّين من فجور حاكم إسباني لعين، ومن طغيانه. وأتى بعدهم انفجار زلزال «مايندوبامبا» الهائل؛ إذ ظل الليل مخيمًا على مدينة كيتو سبعة عشر يومًا، وكانت المياه تغلي في ياجواتشي، وكانت الأسماك كلها تطفو نافقة، حتى في أماكن بعيدة مثل جواياكيل، وفي كل مكان على امتداد المنحدرات المطلة على المحيط الهادئ، حدثت انهيارات أرضية، وذوبان سريع للجليد، وفيضانات مفاجئة، وانهار بالكامل جانب من قمة جبل أروكا القديم، وتساقط محدثًا رجفة، وعزل «بلد العُميان» إلى الأبد عن المستكشفين. لكن تصادف أن كان أحد هؤلاء المستوطنين الأوائل، على الجانب المجاور للشِّعاب، حينما اضطرب العالم اضطرابًا شديدًا، فاضطُر الرجل إلى أن ينسى زوجته وطفله وجميع الأصدقاء والممتلكات التي سبق أن صعِد بها إلى هناك، وأن يبدأ حياته من جديد في ذلك العالم السفلي. نعم، بدأ حياة جديدة لكنها مريضة؛ إذ استحوذ عليه العمى، وقضَى نَحْبَه متأثرًا بما لاقاه في المناجم من عذاب؛ إلا أن القصة التي رواها، آذنت بميلاد أسطورةٍ ما يزال صداها يتردد على امتداد سلسلة جبال الأنديز حتى يومنا هذا.
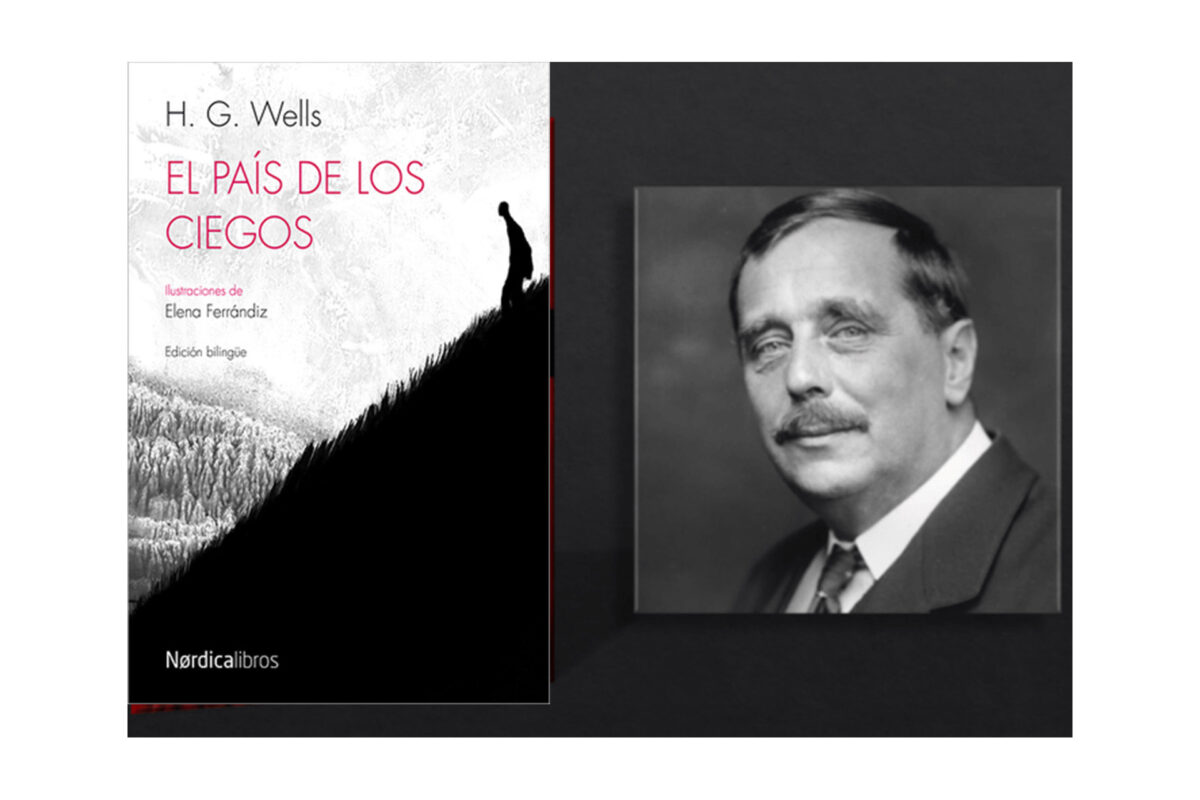
حكى عن الأسباب التي جعلته يغامر عائدًا من ذلك المكان الحصين، الذي حُمل إليه أول مرة مثبَّتًا بالأحزمة على ظهر لاما، بجانب كومة كبيرة من العتاد، حينما كان طفلًا. قال إن الوادي كان يزخر بكل ما تشتهيه الأنفس، من مياه عذبة، ومراعٍ، وطقس معتدل، ومنحدرات من التربة السمراء الخصبة، مع غطاء كثيف من الشجيرات التي تطرح فاكهة شهية، وحوى أحد جوانبه غابات صَنَوْبرية معلَّقة مهيبة، كانت بمنزلة مِصدَّات للانهيارات الثلجية. وعلى أقصى حدود الوادي من جوانبه الثلاثة الأخرى، كانت هناك جروف متسعة من الصخور الخضراء المائلة إلى الرَّمادي، تتوِّجها جروف ثلجية؛ لكن النهر الجليدي لم يكن يمر بها، بل كان يجري بعيدًا في منحدرات أبعد، وبين فَيْنة وأخرى فقط، كانت كتلٌ ضخمة من الثلوج تسقط باتجاه الوادي. في ذلك الوادي، لم تكن السماء تمطر ولا تثلج، لكن الينابيع الوفيرة، وفَّرت مرعًى أخضر خصبًا، واستطاعت مياهها أن تروي كل مساحة الوادي. وبالفعل كان السكان يَحيون هناك حياة طيبة. وكانت حيواناتهم بحالة جيدة، وأعدادها تتضاعف، لكن شيئًا واحدًا كان يعكِّر صفوهم، بل كان كافيًا لإفسادها بشدة. حلَّ عليهم مرض غريب، وتسبب في جعل الأطفال الذين يولدون لهم هناك — بل حتى كثير من الأطفال الأكبر أيضًا — عُميانًا. كان السعي إلى إيجاد تعويذة أو ترياق مضاد لوباء العمى ذاك هو السبب في عودته إلى الشِّعب، على الرغم مما كابده من متاعب ومخاطر وصعوبات. في ذلك الزمن، لم يكن الناس في حالات كهذه يفكرون في الجراثيم والعدوى، ولكنهم كانوا يفكرون في الخطايا؛ وبدا له أن السبب في تلك المحنة هو تقاعس هؤلاء المهاجرين الذين ليس لهم رجل دين عن اتخاذ مقام مقدَّس فور حلولهم بالشِّعب. أراد أن يُنصَب في الوادي مقامٌ أنيق ورخيص ومؤثِّر؛ أراد تذكارات وما شاكلها من أشياء إيمانية عظيمة، ومواد مباركة، وقلائد سحرية، وصلوات. وكان يملك في جَعبته قطعة من الفضة الخام، لم يكن ليُفصح عن مصدرها، كان يصرُّ على أنه لا يوجد أيٌّ منها في الوادي، بشيء من الإصرار الذي يتسم به كاذب متمرس. كانوا جميعًا قد جمعوا أموالهم وحُليَّهم بعضها إلى بعض؛ إذ كانت حاجتهم إلى مثل هذه الكنوز لا تُذكر هناك، حسب قوله، آملين أن تعينهم على شراء معونةٍ مقدسةٍ تنقذهم من مرضهم. أتخيَّل ذلك الشابَّ الجبليَّ المنطفئ العينين، الهزيل الجسد، الشديد القلق، الذي لفحته الشمس، وشدَّ قبعته على رأسه بشدة، ولم يكن معتادًا على العيش في ذلك العالم السفلي، وهو يقص هذه القصة قبل استفحال البلاء، على كاهنٍ يقظ ذي عينين ثاقبتين؛ أستطيع أن أتخيَّل الشابَّ الآن وهو يَنْشد أن يعود بأدوية مقدسة ناجعة لهذا الداء، وأتخيَّل كذلك الاستياء البالغ الذي لا بد أنه واجه به المساحة الواسعة التي انهارت مُخفيةً الشِّعب الذي كان ظاهرًا يومًا ما. لكن بقية قصته الحافلة بالبلايا لم تبلغني، ولا أعلم إلا أنه مات ميتة بشعة بعد بضع سنوات. يا له من شريد مسكين ضلَّ كلَّ ذلك الضلال! إن المجرى المائي الذي شقَّ الشِّعب يومًا ما، ينبثق اليوم من فم كهفٍ حجري، والقصة الأسطورية الركيكة القليلة التفاصيل التي رواها الرجل، نمت لتصبح أسطورة عِرق كامل من البشر العُميان، الذين عاشوا في مكان ما «هناك»، لا نزال نسمعها حتى اليوم.
وسط العدد القليل من سكان ذلك الوادي الذي أصبح معزولًا ومنسيًّا، دارَ المرض دورته. أصبح الكبار يتلمَّسون طريقهم ومصابين بعمًى جزئي، والشباب يبصرون، ولكن برؤيةٍ غائمة، أما الأطفال الذين أنجبوهم فلم يبصروا على الإطلاق. لكن الحياة كانت سهلة للغاية في ذلك المنخفض المحاط بالثلوج، الذي لا يعلم بوجوده أحد في العالم، وليس فيه عَوْسَج ولا أشواك، وليست فيه حشرات مزعجة، ولا بهائم سوى سلالة وديعة من اللاما التي سحبوها ودفعوها وساقوها في مجاري الأنهار الجافة في الشعاب التي أتت إليها. كان البصر يخفت بينهم تدريجيًّا، إلى حدِّ أنهم لم يلحظوا فقدانه. أخذوا يُرشدون صغارهم المكفوفين هنا وهناك، حتى صاروا يعرفون الوادي كلَّه عن ظَهْر قَلْب، واستطاع العِرق مواصلة حياته حتى بعد زوال البصر منهم. كان لديهم وقت ليعلِّموا أنفسهم كيفية التحكم الأعمى في النار التي كانوا يشعلونها بعنايةٍ في مواقد حجرية. كانوا في البداية سلالةً بسيطة من الناس، أُمِّيِّين، متصلين اتصالًا بسيطًا فحَسْب بالحضارة الإسبانية، ولهم نصيب من ميراث فنون بيرو القديمة وفلسفتها التي طواها الزمن. جيل أعقب جيلًا. نسُوا الكثير من الأشياء؛ وأبدعوا الكثير من الأشياء. أما ميراثهم من العالَم الأكبر الذي أتَوْا منه، فقد صار مصطبغًا بالخرافة، ومشكوكًا فيه. كانوا بارعين ومتمكنين من كل شيء، ما عدا الرؤية، وتصادف أن وُلد بينهم شخص ذو عقل فذ، أجاد التحدث وإقناع الآخرين، ووُلد بعده آخر مثله. مات هذان الشخصان وتركا تأثيراتهما، ونمت الجماعة عددًا ووعيًا، وواجهت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي ثارت، وحلَّتْها. تعاقبت الأجيال، ثم أتى عليهم زمن، وُلد فيه طفل يفصله خمسة عشر جيلًا عن ذلك السالف الذي خرج من الوادي بقطعة فِضية ملتمسًا معونة الرب، ولم يعُد قط. في ذلك الزمن تقريبًا، تصادف أن وفَد رجل إلى هؤلاء القوم، قادمًا من العالم الخارجي. وإليكم قصة ذلك الرجل.
كان متسلِّق جبال، أتى من الريف المتاخم لمدينة كيتو. رجل ركب البحر وشاهد العالم، قارئ للكتب على نحو مميز، رجل ذكيٌّ ومغامر. وقد استعانت به جماعة من الإنجليز الذي ذهبوا إلى الإكوادور لتسلُّق الجبال؛ ليستعيضوا به عن أحد مرشديهم السويسريين الثلاثة الذي أقعده المرض. تسلَّق جبالًا هنا وجبالًا هناك، ثم جاءت محاولة تسلُّق جبل باراسكوتوبيتل، الشهير في جبال الأنديز شهرة الماترهورن في جبال الألب، وهناك صار مفقودًا من منظور العالَم الخارجي. هذه الواقعة كُتِبت قصَّتها أكثر من مرة، لكن أفضل رواية لها هي رواية بوينتر، الذي يروي كيف شق الفريق الصغير طريقه الوعر العمودي تقريبًا، صعودًا نحو مشارف الجُرف الأخير والأعظم، وكيف ابتنَوْا لأنفسهم مأوًى ليليًّا على رصيف صخري صغير وسط الثلوج. ويحكي بأسلوبٍ دراميٍّ واقعيٍّ، كيف اكتشفوا حينئذٍ أن نونيز مفقود. انطلقوا ينادونه بصوتٍ عالٍ، ولم يكن ثمة مجيب؛ صاحوا وصفَّروا، وقضَوْا بقية ليلتهم تلك لا يغمض لهم جفن.
ومع إشراقة الصباح، شاهدوا الآثار التي خلَّفها سقوطه. بدا من المستحيل أن يكون قد أحدث صوتًا. زَلَّت قدمه وسقط شرقًا باتجاه الجانب المجهول من الجبل؛ وعلى مسافة بعيدة في الأسفل، اصطدم بمنحدر ثلجي حادٍّ، ثم تابع سقوطه السريع، وسط انهيار ثلجي. انتهت آثاره مباشرةً إلى شفا جُرف مخيف، واختفى كلُّ شيء بعد هذه النقطة. بعيدًا في الأسفل، على عمق سحيق يبدو ما فيه ضبابيًّا لبُعده، أمكنهم أن يرَوْا أشجارًا تبرُز من وادٍ ضيقٍ ومغلق؛ هو «بلد العُميان» المفقود. غير أنهم لم يكونوا على علم بأنه «بلد العُميان» المفقود، ولم يميزوه من أي وادٍ شريطيٍّ ضيق آخر على سطح الأرض. أفقدتهم الفجيعة رِبَاطة جَأْشهم؛ فقرروا مع حُلول الظهيرة التخلي عن محاولتهم، واستُدعي بوينتر للمشاركة في الحرب، قبل أن يتمكن من الشروع في حملة استكشافية أخرى. وحتى يومنا هذا، لم يزل جبل باراسكوتوبيتل يحمل على رأسه قمةً غير مغزوَّة، ولم يزل المأوى الذي حكى عنه بوينتر، يقبع مُقوَّضًا بين الثلوج، لا يقصده أحد.
أما الرجل الذي سقط، فقد نجا.
عند نهاية المنحدر، سقط ألفَ قدم، وهبط وسط سحابة من الثلوج، فوق منحدر ثلجي أشد حدة من الذي يعلوه. أسفل تلك النقطة، أصابه الدوار والذهول وتشوَّش وعيه، لكن عظمةً واحدةً في بدنه لم تُكسَر؛ ثم حلَّ أخيرًا بمنحدرات أقل حدة؛ حيث انفرد جسده ورقد في سكون، مدفونًا وسط كومة ناعمة من الكتل البيضاء التي رافقته وأنقذته. أفاق على خاطر ضبابي، أنه مريض طريح الفراش؛ ثم أدرك موقعه بحصافة متسلق جبال؛ فاجتهد كي يحرِّر نفسه من الثلوج ويخرج منها بعد أن استراح قليلًا؛ حتى استطاع رؤية النجوم. تمدد على صدره برهة، متسائلًا في حَيْرة عن المكان الذي هو فيه، وعمَّا حدث له. تفقَّد أطرافه، واكتشف ضياع كثير من أزراره، وأن مِعطفه التفَّ حول رأسه. سكِّينه اختفت من جيبه، وقُبَّعته ضاعت، على الرغم من أنه سبق أن ربطها تحت ذقنه. تذكَّر أنه كان يبحث عن أحجار سائبة لتعلية نصيبه من جدار المأوى. واختفت فأسه الجليدية.
استقر في نفسه أنه لا بد أن يكون سقط، ونظر إلى أعلى ليرى كم كانت رحلة الهبوط شديدة الطول، وقد جعلها ضوء القمر الخافت تبدو أطول. استلقى بعض الوقت، محدِّقًا بدهشة في الجُرف الكبير الشاحب الشديد الارتفاع، الذي أخذ ارتفاعه ينجلي بين لحظة وأخرى، مع انحسار مدِّ الظلام. أسَره جماله الشبحيُّ الغامض، مدة من الزمن، ثم تملَّكته نوبةٌ من الضحك الباكي.
بعد رَدْح من الزمن، أصبح على دراية بأنه قريب من الحافَة الدنيا للجليد. في الأسفل، تحت ما كان حينئذٍ منحدَرًا مقدورًا عليه ينيره القمر، رأى المظهر الداكن المتكسر لغطاء عشبيٍّ تتناثر فيه الصخور. كافح للوقوف على قدميه، ونزل بألم من أكوام الثلوج المتفككة المحيطة به، وهو يشعر بالوجع في كل مفاصله وكل أطرافه، ومضى للأسفل حتى وصل إلى السطح العشبي، وهناك استلقى، بل خرَّ واقعًا، بجوار صخرة كبيرة، وأخذ يشرب بنهمٍ من القِنِّينة التي كانت في جيبه الداخلي، وسُرعان ما غطَّ في النوم.
أيقظه صوت تغريد الطيور على أغصان الأشجار بعيدًا في الأسفل.
اعتدل جالسًا، وأدرك أنه موجود على جبل صغير عند سفح جُرف متسع، شكَّله الأخدود الذي سقط فيه هو وثلوجه. وارتفع قُبالتَه جِدار صخري آخر يشق عَنان السماء. امتد الشِّعب الواقع بين هذه الجُروف، شرقًا وغربًا وكان يغمره ضوء الصباح، كاشفًا جهةَ الغرب عن كتلة الجبل المنهارة التي سدَّت مدخل الشِّعب المنحدِر. وبدا من تحته أن هناك جُرفًا مساويًا في الانحدار، لكنه وجد فيما وراءَ ثُلوج الأخدود، صَدعًا عموديًّا تقطُر منه مياه الثلج الذائب، وهي ما قد يخاطر من أجله رجل يائس. تبيَّن له أن الأمر أيسر مما كان يبدو، ووصل أخيرًا إلى جبل مقفِر آخر، ثم تسلق صخرة دونما عناء يُذكر؛ ليجد نفسه إزاءَ منحدر حادٍّ تكسوه الأشجار. حدَّد موقعه، وولَّى وجهه لأعلى ناحية الشِّعب؛ حيث رآه يُفضي إلى مُروج خضراء، استطاع حينئذٍ أن يلمح بينها بوضوح مجموعة متقاربة من الأكواخ الحجرية، من طراز غير مألوف. لبعض الوقت، كان التقدم الذي أحرزه ضئيلًا، كما لو كان يتسلق جدارًا عموديًّا، ثم أَفَلَت الشمس عن الشِّعب، وتلاشت أصوات الطيور المغردة، وازداد الجو حولَه برودةً وظُلمة. لكن مرأى الوادي البعيد، ومنازله، هو ما هوَّن عليه الأمر. وما لَبِث أن وصل إلى كتلة من الصخور المتشظية المنحدرة، ولحظ بينها — وقد كان رجلًا قويَّ الملاحظة — وجود سَرْخس غير مألوف، بدا أنه نما بين الشقوق، مادًّا كُفوفًا خضراءَ فاقعة. قطف ورقة أو نحوها، وقضَم عُروقها فوجدها جيدة.
مع انتصاف النَّهار تقريبًا، خرج أخيرًا من عنق الشِّعب، إلى السهل المتسع وضوء الشمس. كان يشعر بالتيبس والإنهاك؛ فقعد في ظل صخرة، وملأ قِنِّينته بالماء من أحد الينابيع، وجَرع منه، وظلَّ هناك لبعض الوقت ليستريح، قبل أن يُكمل طريقه نحوَ المنازل.
كانت شديدة الغرابة لناظرَيْه، بل إن جانب الوادي كله صار أغربَ وأقلَّ ألفة حينما نظر إليه. كان الجزء الأكبر من سطحه مَرْجًا أخضرَ وارفًا، تزينه زهور جميلة كثيرة، وتُسقى بعناية فائقة، ويدل مظهرها على زراعة منظَّمة، لكل واحدة منها. في الأعلى، أحاط بالوادي جدار، وما بدا أنه قناة مائية محيطية، كانت تأتي منها قطرات الماء القليلة التي تسقي نباتات المرج، وعلى المنحدرات الأعلى كانت قُطعان اللاما تتغذى على الكلأ القليل. كانت هناك حظائر، موزعة هنا وهناك بجانب الجدار المحيطي، تُستخدم على ما يبدو لإيواء اللاما أو لإطعامها. كانت قنوات الري تَجري معًا؛ لتصب في قناة رئيسية في مركز الوادي، يحفُّها من كلا جانبيها جدار بارتفاع الصدر. كل ذلك منح ذلك المكان المعزول طابعًا عمرانيًّا استثنائيًّا، طابعًا عزَّزته بقوة حقيقة أن عددًا من الطرق المرصوفة بأحجار سوداء وبيضاء، وعلى جانب كل منها رصيف غريب، كان يمتد هنا وهناك بطريقة منظَّمة. كانت المنازل في القرية المركزية مغايرة تمامًا للكتل العشوائية في القرى الجبلية التي عرَفها؛ فقد كانت تتراصُّ في صُفوف متصلة على جانبَيْ شارع رئيسي يتميز بنظافة مبهرة. وهنا وهناك، كانت واجهات المنازل متعددة الألوان، يشقها باب في المنتصف، لكن جبهاتها المستوية كانت خِلْوًا من النوافذ. كانت متعدِّدة الألوان بعشوائية غير عادية، وملطخة بنوع من الجص الذي كان رَماديًّا أحيانًا، وأحيانًا رَماديًّا مصفرًّا، وأحيانًا بلون الإردواز أو داكن السُّمرة؛ وكان منظر هذا التجصيص الفج هو ما استدعى كلمة «عُميان» إلى ذهن المستكشِف، للمرة الأولى. قال في نفسه: «لا بد أن الرجل الطيب الذي فعل هذا كان أعمى كخفَّاش.»
هبط عبر أحد المنحدرات، حتى وصل إلى الجدار والقناة المائية المحيطة بالوادي، قريبًا من المكان الذي كانت القناة تجود فيه بفَيضها على أعماق الشِّعب، في صورة شلال رقيق ومتموِّج. استطاع حينئذٍ أن يرى عددًا من النساء والرجال، يستريحون على أكوام من العشب، وكأنهم في قيلولة. في الجزء البعيد من المرج، والأقرب من القرية، عدد من الأطفال الراقدين، ثم قريبًا منه، ثلاثة رجال، يحملون دِلاءً على أنيار، على ممشًى صغير، يمتد من الجدار المحيط باتجاه المنازل. كان الرجال يرتدون ملابس من صوف اللاما، وأحذية وأحزمة من الجلد، واعْتَمروا قُبعات من القُماش، لها ألسنة تغطي الأذنين ومؤخَّر الرأس. كان أحدهم يتبع الآخر، في صف واحد، يمشون ببطء ويتثاءبون أثناء مشيهم، كأنهم كانوا مستيقظين طوال الليل. كان في هيئتهم شيء يوحي بنجاحهم واستحقاقهم للاحترام على نحو مُطمْئن للغاية، حتى إن نونيز، بعد تردد وجيز، وقف أمامهم فوق صخرته محاولًا أن يبدوَ ظاهرًا لهم بأكبر قدر ممكن، وأطلق صرخة قوية، تردد صداها في أنحاء الوادي.
توقَّف الرجال الثلاثة، وحرَّكوا رءوسهم كما لو كانوا يتلفَّتون حولهم. أشاحوا بوجوههم نحو هذا الاتجاه وذاك، ونونيز يومئ لهم بطلاقة. لكن لم يبدُ أنهم كانوا يرَوْنه، على الرغم من كل إيماءاته، وبعد مدَّة صاحوا كما لو أنهم يجيبونه، بينما هم متوجهون نحو الجبال إلى أقصى اليمين. زَعَق بهم نونيز مرة أخرى وأخرى، وكلما لوَّح لهم بلا فائدة، طفَت إلى السطح في عقله كلمة «عُميان». قال في نفسه: «الحمقى، لا بد أنهم عُميان.»
وأخيرًا، وبعد كثير من الصراخ والحنق الشديد، عندما عبَر نونيز الممر المائي من خلال جسر صغير، ودلف عبر بوابة في الجدار، مقتربًا من الرجال، كان متأكدًا من أنهم عُميان. كان متأكدًا من أن هذا هو «بلد العُميان» المذكور في الأساطير. تملَّكه هذا الاقتناع، مع شعور بأنه إزاء مغامرة عظيمة، ويُحسد عليها بعض الشيء. وقف الرجال الثلاثة جنبًا إلى جنب، غير ناظرين إليه، لكنهم وجَّهوا آذانهم إليه، وأخذوا يكوِّنون فكرتهم عنه؛ استنادًا إلى خطواته غير المألوفة لهم. وقفوا متقاربين، كما لو كانوا خائفين بعض الشيء، واستطاع نونيز أن يرى محاجر أعينهم مغلقة وغائرة، كما لو كانت مُقلة العين نفسها قد ضمُرت في مَحجرها. وكان على وجوههم تعبير يشبه الهلع.
قال أحدهم بلغة إسبانية يمكن تمييزها بالكاد: «رجل»، وتابع: «إنه رجل — رجل أو روح — هابط من الصخور.»
لكن نونيز تقدَّم بخطوات واثقة، تليق بشابٍّ مقبل على الحياة. استرجع عقلُه كل الحكايات القديمة عن الوادي المفقود و«بلد العُميان»، وسرى بخاطره ذلك المثل القديم، كما لو كان لازمة تتردد:
«في بلد العُميان يكون الأعور ملكًا.»
«في بلد العُميان يكون الأعور ملكًا.»
وبتحضُّر شديد، حيَّا الرجال. تحدَّث إليهم، واستخدم عينيه.
سأل أحدهم: «من أين أتى، أخي بيدرو؟»
«لقد هبط من الصخور.»
قال نونيز: «أتيتُ من وراء الجبال. أتيتُ من البلاد الواقعة خلفها؛ حيث يستطيع الناس أن يرَوْا. من مكان قريب من بوجوتا؛ حيث يوجد مِائة ألف إنسان، وحيث تمتد المدينة لأبعد من مجال الرؤية.»
تمتم بيدرو: «الرؤية؟» وأعادها: «الرؤية؟»
قال الرجل الأعمى الثاني: «إنه آتٍ من الصخور.»
لَحَظ نونيز أن أقمشة معاطفهم مصمَّمة بطريقة غريبة، فكل منها مخيط بطريقة مختلفة عن الآخر.
فاجَئوه بحركة متزامنة معًا نحوه، وقد مدَّ كلٌّ منهم إحدى يديه. أمَّا هو فتقهقر إلى الخلف، مبتعدًا عن تلك الأصابع الممدودة.
قال الرجل الأعمى الثالث: «تعالَ إلى هنا»، وهو يتبع حركته ويقبض عليه بإحكام.
أمسكوا بنونيز وأخذوا يتحسسونه، ولم ينطقوا بكلمة واحدة إلى أن انتهَوْا من ذلك.
صاح: «رفقًا»، وقد امتد إصبع إلى عينه، واكتشف أنهم كانوا يعتقدون أن ذلك العضو بجفنيه الرَّافَّين، هو شيءٌ شاذٌّ فيه. تعرَّضوا لعينه مجدَّدًا.
قال المدعو بيدرو: «إنه كائن غريب يا كورِّيا. المس خشونة شعره. يشبه شعر اللاما.»
«إنه خشن مثل الصخور التي لفظته»، قال كورِّيا ذلك وهو يستكشف ذقن نونيز غير الحليقة، بِيَدٍ ناعمة ورطبة بعض الشيء. وأضاف: «ربما سيصير أنعم بمرور الوقت.» حاول نونيز أن يقاوم تفحُّصهم له، لكنهم كانوا مُحكِمين قبضتهم عليه.
كرَّر قوله: «رفقًا.»
قال الرجل الثالث: «إنه يتكلم. لا شك أنه إنسان.»
قال بيدرو وهو يتفحَّص خشونة معطفه: «يا للقرف!»
سأله بيدرو: «وأتيت إلى العالَم؟»
أجاب نونيز: «بل من العالم. قطعتُ جبالًا وأنهارًا جليدية؛ موجودة في الأعلى، هناك بالضبط، في منتصف المسافة إلى الشمس. خرجتُ من العالم الكبير العظيم الممتد، في رحلة إلى البحر، تستغرق اثني عشر يومًا.»
لم يبدُ أنهم يُولُونه اهتمامًا كبيرًا. قال كورِّيا: «آباؤنا قالوا لنا إن البشر ربما خلقتْهم قوى الطبيعة. إنه دفء الأشياء، والرطوبة، والعفن … العفن.»
قال بيدرو: «فلْنَقتدْه إلى الشُّيوخ.»
قال كورِّيا: «اصرخوا أولًا؛ لئلَّا يشعر الصغار بالخوف … إنه حدث بالغ الغرابة.»
لذا صرخوا، وانطلق بيدرو أولًا، وأخذ نونيز من يده يقوده إلى المنازل.
سحب نونيز يده قائلًا: «أستطيع أن أرى.»
قال كورِّيا: «ترى؟»
أجاب ملتفتًا إليه: «أجلْ، أرى»، وتعثَّر بدَلْو بيدرو.
قال الرجل الأعمى الثالث: «حواسُّه لم تكتمل بعد. إنه يتعثَّر، ويتفوَّه بكلمات لا معنى لها. اقتادوه من يده.»
قال نونيز: «كما تشاءون»، واقتادوه وهو يضحك.
بدا أنه لم تكن لهم معرفة بالبصر.
حسنًا، سيعلِّمهم عاجلًا أم آجلًا.
سمع الناس يصرخون، ورأى عددًا من الأشخاص متجمهرين على الطريق التي تتوسَّط القرية.
أحسَّ أن مواجهته الأولى تلك مع سكان «بلد العُميان»، ترهق أعصابه، وتستنفد صبره أكثر مما كان يتوقع. كان المكان يبدو له أكبر كلما اقترب منه، والتجصيص الملطخ يبدو أغرب. تحلَّق حولَه حشدٌ من الأطفال والرجال والنساء (سرَّته ملاحظة أن وجوه بعض النساء والبنات كانت حلوة إلى حدٍّ ما، على الرغم من أن عيونهن كانت مغلقة وغائرة)، وكانوا يُمسكون به، يتحسسونه بأيدٍ ناعمة وحساسة، ويتشممونه، ويُنصتون إلى كل كلمة يَنْبِس بها. وعلى الرغم من ذلك، انتبذ بعض الأطفال والعذراوات جانبًا، كما لو كانوا خائفين، وللحق، بدا صوته خشنًا وغليظًا مقارنةً بنغمات أصواتهم الرقيقة. تكالب عليه الناس. أما مرشدوه الثلاثة فقد ظلوا ملازمين له، بشيء من التملُّك، وهم يردِّدون مِرارًا وتَكرارًا: «رجل متوحش خارج من بين الصخور.»
قال لهم: «بوجوتا، بوجوتا. أعالي الجبل.»
قال بيدرو: «إنه رجل متوحش، يستخدم كلمات متوحشة»، وأضاف: «هل سمعتم كلمة «بوجوتا» تلك؟ لم يكتمل عقله بعدُ. إنه لا يُحسن سوى مبادئ الكلام.»
قرَص فتًى صغير يده، وقال هازئًا: «بوجوتا!»
قال نونيز: «نعم! إنها مدينة، مقارنةً بقريتكم. لقد أتيتُ من العالَم الكبير؛ من حيث يملك الناس أعينًا ويُبصرون.»
قالوا: «اسمه بوجوتا.»
قال كورِّيا: «لقد تعثَّر؛ تعثَّر مرتين في طريقنا إلى هنا.»
قيل: «أحضروه إلى الشيوخ.»
على حين غِرَّة، دفعوا به عبر بوابة مؤدية إلى غرفة سوداء سواد القار، إلَّا أن نارًا موقدة كانت تضيء بخفوت في آخرها. تحلَّق الحشد خلفه، حاجِبين كلَّ شيء ما عدا بصيصًا خافتًا من ضوء النَّهار. وقبل أن يستجمع نفسه، سقط على وجهه عند قدمَي رجل جالس. واندفعت ذراعه بينما كان يسقط؛ فأصابت وجه شخص آخر، فشعر بالأثر الناعم لملامح ذلك الوجه وسمع صرخة غاضبة. ولبرهة أخذ يقاوم عددًا من الأيدي التي امتدت إليه. كانت معركة من طرَف واحد. فلما استشفَّ حقيقة الوضع، استسلم بهدوء.
قال نونيز: «لقد سقطت. لم أستطع أن أرى ما أمامي وسط هذه الظُّلمة الحالكة.»
كانت هنالك لحظة صَمْت، كما لو كان الأشخاص الذين لا يستطيع رؤيتهم من حوله يحاولون أن يفهموا كلامه. ثم سمع صوت كورِّيا يقول: «ليس سوى إنسان بُدائي. إنه يتعثَّر حين يمشي، ويخلط بكلامه كلمات لا معنى لها.»
وكذا قال عنه آخرون أشياءَ لم يسمعها، أو لم يفهمها بوضوح.
سألهم: «هل تسمحون لي بأن أنهض؟» وسكت هُنَيْهة ثم قال: «لن أقاومَكم مرة أخرى.»
تشاوروا فيما بينهم، ثم سمحوا له بالوقوف.
انطلق صوت رجل كبير في السن، وبدأ يستجوبه؛ فوجد نونيز نفسه يحاول أن يشرح لهؤلاء الشيوخ القابعين في الظلام في «بلد العُميان» طبيعةَ العالَم العظيم الذي سقط منه، ويحكي لهم عن السماء والجبال والإبصار وما شابه ذلك من عجائب. لم يصدِّقوا أو يفهموا أيَّ شيء مما كان يُخبرهم به، وهو ما كان خارج توقعاته تمامًا. بل إنهم لم يفهموا كثيرًا من كلماته. فلأربعةَ عشَرَ جيلًا، ظل هؤلاء الناس عُميانًا ومنقطعين عن العالم المبصر؛ تلاشت أسماء كل الأشياء المتعلقة بالنظر وتغيرت؛ تلاشت قصة العالَم الخارجي، وتحوَّلت إلى حكاية تُحكى للأطفال؛ ولم يعودوا يشغلون بالهم بأي شيء فيما وراء المنحدرات الصخرية التي تعلو الجدار المحيط بهم. ظهر بينهم عُميان عباقرة، وأخذوا يشككون في المعتقدات والتقاليد المهترئة التي ورثوها من أزمان إبصارهم السالفة؛ ومن ثم أبطلوا كل هذه الأشياء، باعتبارها ضلالات عديمة الفائدة، واستبدلوا بها تفسيرات جديدة وأكثر تعقُّلًا. قدر كبير من قدرتهم على التخيُّل ذبُل مع ذبول أعينهم؛ فصنعوا لأنفسهم مخيلات جديدة معتمدة على آذانهم وأناملهم التي أصبحت أرهف إحساسًا. أدرك نونيز هذا ببطء؛ أن ما كان ينتظره من انبهار واحتفاء بهذا الأصل وبمواهبه، لم يكن ليحدث. وبعد محاولته البائسة لشرح حاسَّة الإبصار لهم، حصروه في زاوية بوصفه نسخة مرتبكة من مخلوق بُدائيٍّ يصف عجائب أحاسيسه المرتبكة، الأمر الذي جعله يفتر تحت وابل هجومهم، ويستسلم لاتباع تعليماتهم. وتولَّى كبير العُميان مسئولية تعليمه أمور الحياة والفلسفة والدين، وكيف أن ذلك العالم (يعني واديهم) كان في البدء عبارة عن فراغ أجوف بين الصخور، وحينئذٍ جاءت في البداية جمادات لا تملك نعمة اللمس، ومعها اللاما وكائنات أخرى قليلة لها حواسُّ ضعيفة، ثم أتى البشر، وأخيرًا أتت الملائكة، وهي كائنات يمكن للإنسان أن يسمعها تغني وتُصدر أصوات رفرفة، لكنه لا يستطيع لمسها على الإطلاق، الأمر الذي أوقع نونيز في حَيْرة عظيمة، إلى أن استنتج أنهم يقصدون بها الطيور.
مضى الشيخ يخبر نونيز كيف أن الوقت كان مقسمًا إلى الدافئ والبارد، وهما مكافئا النَّهار والليل عند العُميان، وكيف أنه من الأفضل أن ينام الناس في الدفء، وأن يعملوا في البرد؛ ولذلك، لولا قدومه لكانت بلدة العُميان كلها نائمة الآن. وقال إن نونيز لا بد أنه خُلق على هذا النحو الخاص لينهل من الحكمة التي حازُوها، وأن يعمل في خدمتها، وإنه على الرغم من كل اضطراباته العقلية وسلوكه المتعثر، عليه أن يتحلَّى بالشجاعة، وأن يفعل كل ما بوسعه ليتعلَّم، وهو الأمر الذي همْهَم الناسُ الواقفون عند الباب كلهم مشجِّعين عليه. وقال الشيخ إن الليل — إذ يسمِّي العميان نَهارهم ليلًا — قد انقضى تمامًا، ويتعين على الجميع العودة إلى النوم. ثم سأل نونيز عما إذا كان يعرف كيف ينام؟ فأجابه نونيز بالإيجاب، لكنه يريد أن يأكل قبل أن ينام.
أحضروا له الطعام — قدحًا من لبن اللاما، وخبزًا جافًّا مملحًا. وقادوه إلى مكان خالٍ من الناس؛ ليأكل بعيدًا عن مسامعهم، ثم يَهجعون إلى أن يوقظَهم برد المساء الجبلي؛ ليبدءوا يومهم من جديد. لكن نونيز لم يغمض له جَفن على الإطلاق.
بدلًا من ذلك، جلس في المكان الذي تركوه فيه، مريحًا أطرافه، ومسترجعًا عواقب وصوله غير المتوقعة مِرارًا وتَكرارًا في عقله.
كان يضحك بين حين وآخر، مرة بمرح، ومرة بغيظ.
قال مستنكرًا: «عقل غير مكتمل!» وتابع قائلًا: «لا يملك حواسَّ بعد! هؤلاء ليس لديهم أدنى فكرة عن أنهم يُهينون مَلِكهم وسيدهم الذي أرسلتْه السماء إليهم. أعتقد أن عليَّ أن أعيدَهم إلى جادَّة الصواب. فلأفكرْ في طريقة لفعل ذلك؛ لأفكرْ.»
كان منهمكًا في التفكير حين غربت الشمس.
امتلك نونيز عينًا ذواقةً للجمال، وقد استشعر أن الوهج الذي جلَّل حقول الثلج والأنهار الجليدية التي عَلَتْ محيطةً بالوادي، هو أجمل ما رأى. تحولت عيناه عن ذلك البهاء البعيد المنال، إلى القرية والحقول المروية، التي غمرتها حُمرة الغسق سريعًا، وفجأة جاشت مشاعره، وأخذ يشكر الرب من أعماق قلبه، أنْ وهبه نعمة البصر.
نما إلى سمعه صوتٌ يناديه من خارج القرية. «أنت، يا بوجوتا! تعالَ هنا!»
عندئذٍ نهض وهو يبتسم. سيُبدي لهؤلاء الناس، مرة واحدةً وإلى الأبد، ما تعنيه الرؤية للإنسان. سيبحثون عنه، ولن يجدوه.
قال الصوت: «لا تتحرك يا بوجوتا.»
ضحك ضحكة مكتومة، وتسلَّل مبتعدًا خطوتين عن الممر.
«لا تطأ العشب يا بوجوتا؛ ليس مسموحًا بذلك.»
كان نونيز بالكاد قد سمع هو نفسه وقع قدميه؛ فتوقف مدهوشًا.
أتى صاحب الصوت راكضًا نحوه عبر الممر المرقَّط.
فتراجع عائدًا إلى الممر، ثم قال: «ها أنا ذا.»
قال الرجل الأعمى: «لماذا لم تأتِ حين ناديتك؟ هل يجب أن تُقاد مثل الأطفال؟ ألا يمكنك سماع صوت الممر وأنت تسير؟»
أجاب: «أستطيع أن أراه.»
قال الرجل الأعمى بعد تفكير: «لا توجد كلمة اسمها «أرى» أبدًا. كفَّ عن هذه الحماقة، واتبع صوت قدميَّ.»
تبعه نونيز وهو متضايق بعض الشيء.
قال: «ستحين فرصتي.»
أجابه الرجل الأعمى: «سوف تتعلم، هناك الكثير ليتعلمه المرء في العالَم.»
قال نونيز: «ألم يخبرك أحد بالمثَل القائل: «في بلد العُميان يكون الأعور ملكًا»؟»
سأله الرجل الأعمى من خلف كتفه بلا اهتمام: «ما معنى «العُميان»؟»
مرت أيام أربعة، وفي اليوم الخامس كان «ملك العُميان» ما يزال نَكِرة، كغريب أخرق لا نَفْع منه بين رعاياه.
اكتشف أن إعلانه عن نفسه، كان أكثر صعوبة مما تخيَّل، وفي الوقت نفسه، وبينما كان يُمعن التفكير في محاولته «الانقلاب»، كان يفعل ما يُؤمر به، ويتعلم عادات «بلد العُميان» وتقاليدهم. اكتشف أن العمل والسعي في أثناء الليل، أمر مزعج للغاية، وقرر أن يكون ذلك أول ما يغيره.
لقد عاش هؤلاء الناس حياة كادحة بسيطة، بكل ما فيها من عناصر الاستقامة والسعادة؛ إذ إن هذه الأشياء من السهل أن يفهمَها البشر. كانوا يجدُّون في عملهم، لكن ليس إلى درجة استنزاف أنفسهم؛ فقد كان لديهم ما يكفي حاجاتهم من الطعام واللباس؛ وكانت لديهم أيام ومواسم للراحة؛ ومارسوا الكثير من الموسيقى والغناء، وكان بينهم حب، وأطفال صغار.
كان مدهشًا ذلك القدْر من الثقة والانضباط الذي سيَّروا به أمور عالَمهم المرتَّب؛ فكل شيء، كما ترى، تم ضبطه ليلائم احتياجاتهم؛ كل طريق من الطرق الشعاعية في منطقة الوادي، تصنع مع الطريق المجاورة لها زاوية محددة ثابتة، وكانت مميزة بعلامة خاصة على أرصفتها؛ كما كانت جميع العوائق والشذوذات في الطرق والمروج، قد أزيلت منذ وقت طويل؛ وكانت أساليبهم وطرائقهم كلها تنبع بصورة طبيعية من احتياجاتهم الخاصة. صارت حواسُّهم حادةً على نحو مذهل؛ وكان بإمكانهم أن يسمعوا ويقيِّموا أقل حركة من إنسان على بُعد عشر خطوات، بل وأمكنهم أن يسمعوا دقات قلبه نفسها. ومنذ وقت طويل حلَّ تنغيم الأصوات محلَّ تعبيرات الوجه، وحلَّت اللمسات محلَّ الإيماءات، وأصبح استخدامهم للمِعْول والمِجْرفة والمِذْراة يتم بالسلاسة والثقة المعتادة في أعمال البَسْتنة. كانت حاسَّة الشم لديهم قوية على نحو استثنائي؛ إذ أمكنهم التمييز بين الروائح المختلفة، بالمهارة التي تمتلكها الكلاب، واعتادوا استئناس حيوانات اللاما التي عاشت بين الصخور في الأعلى، وأتت إلى الجدار بحثًا عن الغذاء والمأوى. كل ذلك جعل نونيز في نهاية الأمر يُقر بما وجده من السهولة والثقة الكبيرتين اللتين انطوت عليهما تحركات هؤلاء الناس.
ثارت ثائرته فقط بعدما حاول إقناعهم.
حاول في البداية في أكثر من مناسبة أن يحدِّثهم عن الرؤية. قال لهم: «أيها الناس، تعالَوْا، انظروا إليَّ، عندي أشياء لا تفهمونها.»
استجاب له مرةً أو مرتين شخص أو شخصان؛ جلسا إليه مطأطئَين رأسيهما موجِّهَين آذانهما كليَّةً نحوه، وقد بذل قُصارى جهده ليشرح لهما ما يعنيه الإبصار. وكان بين مستمعيه، فتاةٌ ذات أجفان أقل حمرة وغورًا من غيرها؛ حتى ليخيَّل إلى الرائي أنها تُخفي عينين، وقد أمل أن يقنعها هي بالذات. تحدَّث عن جماليات الرؤية، من مشاهدة الجبال والسماء وشروق الشمس، وقد استمعوا إليه بتشكك مرِح، سُرعان ما تحوَّل إلى معارضة شديدة. قالوا له إنه لا وجود فعليًّا للجبال على الإطلاق، وإن نهاية الصخور التي كانت قُطعان اللاما ترعى فيها، إنما هي في الواقع آخِر العالم؛ أمَّا في الأعلى فهناك سقف كهفي للكون، يسقط منه الندى والكتل الثلجية؛ وحينما أصر بتحدٍّ على أن العالم ليس له نهاية ولا سقف مثلما يعتقدون، قالوا له إن أفكاره مغلوطة. وبقدر ما تمكن من أن يصف لهم السماء والسحب والنجوم، بدا ذلك لهم فراغًا بشعًا، وخواءً رهيبًا، يحل محل السقف الناعم الذي يظلل الأشياء الذي آمنوا به. كانت مسألة إيمان لديهم أن سقف الكهف له ملمس شديد النعومة. رأى أنه صدمهم بطريقة أو بأخرى؛ فيئس وتخلى عن محاولة إقناعهم بهذا الجانب كلِّيَّةً، وجرَّب أن يُريَهم الأهمية العملية للإبصار. ذات صباح رأى بيدرو يمشي في الطريق المسماة «سبع عشرة» متجهًا إلى المنازل في المركز، لكنه كان لا يزال أبعد من أن يُسمع أو يُشم، وكان نونيز قد أخبرهم بالكثير. قال متنبِّئًا: «بعد قليل سيكون بيدرو هنا.» علَّق رجل مسنٌّ بأن بيدرو لا شأن له بالطريق «سبع عشرة»، وحينئذٍ، غيَّر بيدرو مساره بعد أن كان قريبًا، وكأنما كان يصدِّق على كلام الرجل، واتجه نحو الطريق «عشرة» عائدًا إلى الجدار الخارجي بخطوات سريعة. سخروا من نونيز حينما لم يأتِ بيدرو، وحينما استجوب بيدرو لاحقًا لكي يوضِّح موقفه، أنكر بيدرو الأمر وتحدَّاه، وكان بعدها عدائيًّا تجاهه.
بعد ذلك أقنعهم بأن يتركوه يذهب بعيدًا مُرتقيًا المروج المنحدرة نحو الجدار، وبصحبته رجل وافق على الصعود معه، وقد وعدهم بأن يصفَ لهم مِن هناك كل ما يحدث بين المنازل. وصف ما تبيَّنه من الغاديات والرائحات، لكن الأشياء التي عدَّها هؤلاء الناس مهمة، إنما حدثت داخل البيوت التي لا نوافذ لها، أو من خلفها — كانت تلك الأشياء تحديدًا هي محك اختبارهم له — وهذه الأشياء لم يستطع أن يراها أو يخبرهم بشيء عنها. ونتيجةً لفشله ذاك في تلك المحاولة، ولسخريتهم منه التي لم يستطيعوا كتمها، قرر نونيز أن يلجأ إلى العنف. فكَّر في الاستيلاء على مِجْرفة، ومباغتةِ واحد أو اثنين منهم بالضرب وطَرْحهما أرضًا؛ ليريهم في تلك المعركة العادلة مزية الأعين. شرع بالفعل في تنفيذ خُطته واستلَّ مِجْرفته، ثم اكتشف في نفسه شيئًا جديدًا، وهو أنه كان يستحيل عليه أن يضرب رجلًا أعمى بدمٍ بارد.
أصابه التردد، ووجد أنهم تنبَّهوا جميعًا إلى أنه رفع المِجْرفة. وقفوا متأهبين، وقد أمالوا رءوسهم إلى جانب واحد، وحوَّلوا آذانهم نحوه، تحسُّبًا لما قد يفعله تاليًا.
قال له أحدهم: «ألقِ هذه المِجْرفة على الأرض.» فشعر بشيء من الرعب البائس، وكاد أن ينصاع لأمرهم.
حينئذٍ، دفع أحدهم إلى الوراء، ملصقًا إياه بجدار أحد المنازل، ثم مرق من جانبه، هاربًا إلى خارج القرية.
انطلق يقطع واحدًا من مروجهم، مخلِّفًا مسارًا من العشب الموطوء وراءَ قدميه، ولم يلبث أن جلس على أحد جانبَيْ طريق من طرقهم. كان يشعر بشيء من النشاط الذي يعتري الرجال جميعًا في مقتبل المعارك، لكن ذلك الشعور كان أكثر تعقيدًا؛ فقد بدأ يدرك أن المرء لا يستطيع أن يشعر بالرضى وهو يحارب كائنات تقف على أرضية عقلية مختلفة عنه. وعلى مسافة بعيدة، رأى رجالًا عدة يحملون مجارفَ وعِصيًّا، خارجين من الطرق المحيطة بالمنازل، وآخذين في الانتشار على امتداد طرق مختلفة ساعِين نحوَه. كان تقدُّمهم وئيدًا، وكانوا يتحادثون فيما بينهم على نحو متكرر، وبين فَيْنة وأخرى، كان أفراد الطوق يَلزمون أماكنهم جميعًا، يتشمَّمون الهواء وينصتون.
في المرة الأولى التي فعلوا فيها ذلك، ضحك نونيز، لكنه لم يضحك بعدها.
عثر أحدهم على آثار قدميه على عشب المرج، وانكفأ يتحسس طريقه على امتدادها.
لمدة خمس دقائق، شهد نونيز التمدد البطيء للطوق، ثم تحوَّلت رغبته المتراخية في القيام بتحرُّك فوري إلى اندفاع محموم. هبَّ واقفًا، وخطا خطوة أو خطوتين نحو الجدار المحيطي، ثم التفت، وتقهقر لمسافة قصيرة. عندئذٍ وقفوا جميعًا مكوِّنين حلقة هلالية الشكل، ساكنين ومُصغِين.
لَزِم هو أيضًا مكانه، قابضًا على مِجْرفته بشدةٍ بكلتا يديه. تُرى هل يجب عليه أن يهاجمَهم؟
كان النبض في أذنيه يجري على إيقاع «في بلد العُميان يكون الأعور ملكًا!»
تُرى هل يجب عليه أن يهاجمَهم؟
من جديد، نظر خلفه إلى الجدار العالي الذي لا يمكن تسلُّقه — لا يمكن تسلُّقه بسبب تجصيصه الأملس، لكنه مع ذلك يحتوي على العديد من الثقوب فيما يشبه أبوابًا صغيرة — ونظر كذلك إلى صف مطارِديه الذين أخذوا يقتربون منه. ومن ورائهم، كان آخَرون يتوافدون من الشوارع المحيطة بالمنازل.
تُرى هل يجب عليه أن يهاجمهم؟
ناداه أحدهم: «بوجوتا! بوجوتا! أين أنت؟»
قبض على مِجرفته، لكن بقوة أكبر، واندفع نازلًا إلى المروج نحو المساكن، وبمجرد أن تحرك اندفعوا نحوه بدورهم. «سأضربهم إذا لمسوني.» أَقسم: «بحقِّ السماء، سأفعل. سأضرب.» وعلا صوته: «انظروا إليَّ، سوف أفعل ما يحلو لي في هذا الوادي. أتسمعون؟ سوف أفعل ما يحلو لي، وسوف أذهب إلى حيث يحلو لي!»
كانوا يتحركون نحوه بسرعة، يتحسسون طريقهم، لكن سرعتهم تتزايد. كان الأمر شبيهًا بلُعبة الغُمَّيْضة، غير أن الجميع كانوا مغمضي الأعين عدا واحدًا. صرخ أحدهم: «أمسِكوا به!» ووجد نونيز أن مطارِديه يُضيِّقون عليه الخناق، وشعر فجأة بأن عليه أن يتصرف بسرعة وحزم.
«أنتم لا تفهمون.» صرخ فيهم بصوتٍ قَصَد أن يكون قويًّا وحازمًا، لكنه تحوَّل إلى الانكسار. «أنتم عُميان، وأنا يمكنني أن أرى. دعوني وشأني!»
«بوجوتا! ضع تلك المِجْرفة أرضًا، واخرج من بين العشب!»
الأمر الأخير، الذي بدا مألوفًا وبشعًا، فجَّر بداخله عاصفة من الغضب.
قال وهو يشهق بانفعال: «سأُوذيكم. بحقِّ السماء، سأُلحق بكم الأذى. دعوني وشأني!»
أطلق ساقيه للريح، غير عارف إلى أين يتجه بالضبط. هرب من الرجل الأعمى الأقرب إليه؛ لأنه كان من المرعب أن يضربَه. ثم توقف وزاد سرعته ليهرب من صفوفهم المقتربة منه. وأراد أن يستغل وجود فجوة كبيرة بينهم، لكن الرجلين على طرَفيها، نتيجةً لملاحظتهما السريعة لتقدُّم خطواته، اندفع أحدهما نحو الآخر ليغلقاها. هَرْول مسرعًا، لكنه عرف أنه سيسقط في أيديهم لا محالة، وفجأة سُمِعت «هسهسة!» أصابت المِجْرفة. شعر بارتطامها الطري بيد أحدهم وذراعه، وسقط الرجل أرضًا مُطلقًا صرخة ألم، ليجد نونيز منفذًا.
ها قد عبر! وحينئذٍ، كان قريبًا من شارع المنازل مرة أخرى، بينما الرجال العُميان، بمجارفهم وعصيِّهم المُشهَرة، يهرولون هنا وهناك بخفَّة ملحوظة.
في ذلك الوقت، سمع وقع خطوات من خلفه، ووجد رجلًا طويلًا يندفع نحوه، ويضرب الهواء في إثر صوته. فقد نونيز أعصابه، وقذف خَصمه الذي كان على بُعد ياردة واحدة منه بمِجْرفته، والتفَّ هاربًا، مُطلقًا صيحة انتصار مُستحَقَّة؛ إذ نجح في تفادي رجل آخر.
كان الفزع يتملك نونيز. أخذ يعدو بجموح واضطراب؛ يناور حينما لا تكون ثَمَّة حاجة للمناورة، ويتعثَّر حينما يحمله توتُّره على التلفُّت حوله في جميع الجهات في الوقت نفسه؛ حتى إنه سقط للحظات، وسمعوا سقطته. وبعيدًا، ظهر له باب صغير مفتوح في الجدار المحيط، بدا وكأنه باب من أبواب الجنة؛ فاندفع نحوه اندفاعًا ناريًّا، غير عابئ حتى بالتلفُّت حوله لرؤية مطارِديه، إلى أن وصل إلى هدفه، وعبر الجسر بتعثُّر، ثم تسلَّق الصخور لمسافة قصيرة، ليُفزع لاما صغيرًا ويجعله يتقافز ويتوارى عن الأنظار، وأخيرًا رقد على الأرض يشهق محاولًا التقاط أنفاسه.
وهكذا انتهى «انقلابه».
ظلَّ وراء الجدار المحيط بوادي العُميان، لمدة يومين وليلتين، بغير طعام ولا مأوى، متفكرًا فيما قد يحدث من أمور غير متوقَّعة. وأثناء هذه التأملات كان يردد بتواتر، وبحسٍّ مفعمٍ بالسخرية دائمًا، المثل الذي نُسِف: «في بلد العُميان يكون الأعور ملكًا.» فكر في المقام الأول في طرق لمحاربة هؤلاء الناس ودحرهم، لكن، صار من الواضح بالنسبة إليه استحالة أن يتوصل إلى طريقة قابلة للتطبيق؛ فهو لم يمتلك أي أسلحة، وسيكون من الصعب أن يمتلك سلاحًا الآن.
كانت «لوثة الحضارة» قد أصابته، حتى في بوجوتا، فلم يجد في نفسه القدرة على النزول إلى هناك واغتيال واحدٍ من العُميان. لو فعل ذلك، لربما أمكنه حينئذٍ أن يمليَ عليهم شروطه، مهدِّدًا إياهم بأن يقتلَهم جميعًا. ولكن، عاجلًا أم آجلًا، كان لا بد أن ينام!
حاول أيضًا أن يبحث عن الطعام بين أشجار الصَّنَوْبر، وأن يحتميَ تحت أغصانها في الليل أثناءَ تساقط الصقيع، وحاول بيدٍ مرتعشةٍ أن يحتالَ لاصطياد أحد حيوانات اللاما؛ لكي يحاول قتله — ربما بضربه بحجر — ولعله في النهاية يأكل بعضًا منه. لكن حيوانات اللاما كانت متوجسة منه، وكانت ترمقه بعيون بُنية مرتابة، وتبصق عليه كلما اقترب منها. غلبه الخوف في اليوم الثاني، واعترتْه نوبات من الارتجاف. وفي النهاية، زحف نازلًا إلى جدار «بلد العُميان» وحاول أن يعقد اتفاقًا. تقدَّم ببطء مع التيار وأخذ يصرخ، حتى خرج إليه من البوابة رجلان أعميان وتكلَّما معه.
قال لهما: «كنت طائشًا، لكن ذلك كان بسبب أني بُدائي.»
أثنيَا على كلامه.
وأخبرهما بأنه أكثر تعقُّلًا الآن، وبأنه نادم أشد الندم على كل ما اقترفه من أفعال.
ثم دمعت عيناه دون قصد؛ إذ كان في غاية الضعف والاعتلال، وقد رأى الرجلان في ذلك بادرة طيبة.
ثم سألاه عما إذا كان لا يزال يعتقد أن بإمكانه أن «يرى».
أجابهما: «كلا، تلك كانت حماقة. الكلمة لا تعني أي شيء، بل هي أقل من أن تكون لا شيء!»
ثم سألاه عما يوجد في الأعلى.
أجابَهما: «على بُعد حوالي عشرة أمثال طول الإنسان، يوجد سقف يغطي العالم — مصنوع من الحجر — وهو ناعم جدًّا جدًّا» … ثم انفجر من جديد في بكاء هستيري. وقال: «قبل أن تسألوني عن أي شيء آخر، امنحوني بعض الطعام وإلَّا متُّ من الجوع.»
كان يتوقع أن يَلقى عقابًا أليمًا، لكن هؤلاء الناس العُميان كانوا قادرين على التسامح. كانوا يرَوْن أن تمرُّده ليس سوى دليل إضافي آخر على حالة الخبال والنقص العامة التي يتسم بها؛ وبعدما جلدوه، أوكلوا إليه القيام بأبسط الأعمال وأشقِّها على الإطلاق بالنسبة إليهم، وقد انصاع لأوامرهم باستسلام؛ إذ لم يجد طريقة أخرى للبقاء على قيد الحياة.
أصابه المرض لبضعة أيام؛ فاعتنوا به برفق. خفف عليه ذلك من وطأة خضوعه. لكنهم أصروا على تركه يرقد في الظلام، وكانت تلك تعاسة بالغة. كان حكماء عُميان يحضرون إليه، يحدِّثونه عن خفة عقله وفساده، ويوبِّخونه بتأثر شديد بسبب شكوكه حول الغطاء الصخري الذي يُطْبِق على الوعاء الكوني الذي يعيشون فيه؛ حتى إنه كاد يتساءل في نفسه عما إذا كان بالفعل ضحية للهذَيان؛ لعدم تمكنه من رؤية ذلك السقف.
وهكذا أصبح نونيز أحد مواطني «بلد العُميان»، ولم يعُد ينظر إلى سكانه نظرة معمَّمة، بل صار يعرفهم بصفاتهم الشخصية، وتولَّدت بينه وبينهم أُلفة، بينما كان العالم فيما وراء الجبال يبعد أكثر فأكثر ويغدو غير واقعي. كان هناك ياكوب؛ سيِّده، وهو رجل طيب حينما لا يزعجه أحد؛ وكان هناك بيدرو، ابن أخي ياكوب؛ وكانت هناك ميدينا-ساروتي؛ صغرى بنات ياكوب. كانت تحظى بقليل من التقدير في عالَم العُميان؛ لأنها امتلكت وجهًا حادَّ الملامح، وافتقرت إلى تلك النعومة اللماعة المرضية التي هي مثال الجمال الأنثوي لدى الرجل الأعمى؛ لكن نونيز كان في البدء يراها جميلة، وسرعان ما صارت أجمل الخَلْق كلهم في نظره. لم يكن جفناها المُطبقان غائرَيْن وأحمرين مثلما هو شائع بين سكان الوادي، بل كانا مرتخيَيْن كما لو كانا سينفتحان مرة أخرى في أية لحظة؛ وكانت لها أهداب طويلة، عدَّها الناس تشوُّهًا خِلقيًّا خطيرًا. وكان صوتها قويًّا، فلم يناسب السمع الحاد الذي تمتع به شباب الوادي. ولذلك كله، لم يكن لها حبيب.
وجاء وقتٌ اعتقد فيه نونيز بأنه إن استطاع الفوز بها، فسيَقنع بالعيش في الوادي ما تبقَّى من أيام حياته.
كان يراقبها؛ ويتحيَّن الفرص ليُسديَ إليها خدمات بسيطة، وسرعان ما اكتشف أنها كانت تراقبه بدورها. وذات مرة، في تجمُّع خلال أحد أيام العُطَل، جلس أحدهما بجوار الآخر تحت ضوء النجوم الخافت، وكانت الموسيقى عذبة. لامست يده يدها، وتجرَّأ على الإمساك بها. فما كان من ميدينا-ساروتي إلَّا أن ضغطت على يده برقَّة بالغة. وذات يوم، بينما كانا يتناولان الطعام في الظلام، شعر بيدها تلمسه بنعومة شديدة، وتصادف في تلك اللحظة أن اشتعلت النار فجأة؛ فرأى رقَّة وجهها.
كان يسعى إلى التحدُّث إليها.
ذهب إليها في يوم من الأيام، بينما كان جالسة تغزل تحت ضوء قمر الصيف. جعلها الضوء تبدو وكأنها شيء مصنوع من الفِضة والغموض. جلس نونيز عند قدميها، وأخبرها بأنه يحبها، وبكم بدت له جميلة. كان له صوتُ عاشق، وكان يتكلَّم معها بلِين واحترام جمٍّ أقرب إلى التهيُّب، وهي لم تكن قد اختبرت ذلك الهُيَام من قبلُ. لم تمنحه إجابةً قاطعة، لكن كان من الواضح أن كلماته قد أسعدتها.
بعد ذلك، كان يتحدَّث معها كلما وجد الفرصة سانحة. أصبح الوادي هو العالَم بالنسبة إليه، بينما صار العالَمُ الواقع وراءَ الجبال حيث يعيش الناس تحت الشمس لا يعدو كونه حكاية خيالية يقصها على مسامعها من وقت لآخر. ثم حدَّثها — بشيء من التردد والاستحياء — عن الرؤية.
بدت لها الرؤية أكثر الخيالات شاعرية، وأصغت لوصفه النجوم والجبال، ولجمالها هي الحلو الوضَّاء، كما لو أن ذلك لهوٌ آثم. لم تصدِّق، بل بالكاد فهمت، لكنها كانت مبتهجة على نحو غامض، حتى إنه اعتقد أنها فهمت الأمر تمامًا.
ثم زال التهيُّب عن قلبه المحب، واكتسب الجسارة. ولم يمضِ وقت طويل حتى طلب من ياكوب والشيوخ يدها، لكنها كانت متخوِّفة وتأخرت في الرد. كانت إحدى أخواتها اللاتي يكبرنها سنًّا هي أول من أخبر ياكوب بأن ميدينا-ساروتي ونونيز واقعان في الحب.
منذ البداية، كانت هناك معارضة شديدة لزواج نونيز وميدينا-ساروتي؛ ولم يكن هذا بسبب تقديرهم لها بقدر ما كان بسبب أنهم يعدُّونه كائنًا دخيلًا، مخبولًا، وشيئًا فاقد الأهلية لا يَرْقى إلى أدنى مراتب الإنسان. وعارضت أخواتها الزيجة بضراوة؛ باعتبارها تشوِّه سُمعتهن كلهن؛ أمَّا ياكوب والدها، فعلى الرغم من أنه كان يُكِنُّ لتابعه الأخرق المطيع شيئًا من الإعجاب، فإنه هزَّ رأسه قائلًا إن هذا الأمر لا يمكن أن يتم. وأمَّا الشبان فكانوا كلهم غاضبين لاعتقادهم أن هذا الزواج سيُفسد العِرْق، وبلغ الغضب من أحدهم مبلغًا إلى حدِّ أن سبَّ نونيز وضربه. ردَّ له نونيز الضربة. وقد لمس عندئذٍ للمرة الأولى فائدة الإبصار، رغم اقتراب مغيب الشمس، وبعد انتهاء تلك المعركة، لم يُقدِم أحد على رفع يدٍ ضده. لكنهم كانوا ما يزالون يرَوْن زواجه مستحيلًا.
كان ياكوب العجوز رءوفًا بصغرى بناته، وقد أغمَّه بكاؤها على كتفه.
«افهمي يا حبيبتي، إنه أخرق! لديه أوهام وضلالات، ولا يستطيع القيام بأي شيء على النحو الصحيح.»
بكت ميدينا-ساروتي، وقالت: «أعلم ذلك، لكنه الآن أفضل مما كان عليه. إنه يتحسن. وهو قوي يا والدي العزيز، ولطيف، أقوى وألطف من كل رجال العالم. إنه يحبني، وأنا يا أبي أحبه.»
أصيب ياكوب العجوز بحزن شديد؛ إذ وجد ألَّا شيء يمكنه تهدئتها والتخفيف عنها، فضلًا عن أنه — وهذا ما أحزنه أكثر — كان يحب نونيز لأسباب كثيرة. ولذا ذهب إلى حجرة المشورة التي لا نوافذ لها، وجلس مع غيره من الشيوخ، وراقب اتجاه الحديث، وفي التوقيت المناسب، قال لهم: «إنه أفضل حالًا مما كان. ومن المرجَّح أن نجده قد أصبح عاقلًا ومتَّزنًا مثلنا في يوم من الأيام.»
بعد ذلك، خطرت لأحد الشيوخ فكرة، بعد تفكير عميق. كان الطبيب العظيم بين هؤلاء الناس، الرجل الذي يداويهم، ويملك عقلًا حكيمًا وخلَّاقًا، وقد راقت له فكرة علاج نونيز لتخليصه من خصاله الغريبة. وذات يوم، حينما كان ياكوب حاضرًا، أعاد الشيخ فتح موضوع نونيز.
قال: «لقد فحصت بوجوتا، وحالته باتت أوضح بالنسبة إليَّ. أعتقد أن هناك احتمالية كبيرة لشفائه.»
قال ياكوب العجوز: «هذا ما تمنيته دومًا.»
أضاف الطبيب الأعمى: «إن دماغه متضرر.»
هَمْهَم الشيوخ موافقين.
وأضاف الطبيب: «الآن، «ما» الذي أصابه بالضرر؟»
قال ياكوب العجوز: «أجلْ!»
«هذا.» قال الطبيب مجيبًا عن السؤال الذي طرحه بنفسه، وأكمل: «ذانك الشيئان الشاذَّان المسمَّيان العينين، اللذان يوجدان ليُضفِيَا على الوجه حزنًا ناعمًا لطيفًا، هما المريضان في حالة بوجوتا، بطريقة تؤثِّر على دماغه. إنهما منتفخان إلى حد كبير، وهو يملك أهدابًا، وجفونه تتحرك باستمرار؛ ومن ثم فدماغه في حالة من الاستثارة والتشتت المستمرَّين.»
سأل ياكوب العجوز: «إذن؟» وكرر: «إذن؟»
«أعتقد أن بإمكاني القول — بدرجة معقولة من الثقة — إنه لكي نعالجه تمامًا، فكل ما علينا فعله، هو جراحة بسيطة وسهلة؛ بالتحديد، إزالة تلك الأجسام المزعجة.»
«وبعدها سيصير عاقلًا؟»
«سيصير عاقلًا على نحوٍ مثالي، وسيصير مواطنًا مثيرًا للإعجاب تمامًا.»
قال ياكوب العجوز: «شكرًا للسماء على نعمة العلم!» وذهب من فوره ليبشِّر نونيز بآماله السعيدة.
لكن الطريقة التي تلقَّى بها نونيز الخبر السارَّ صدمَتْه؛ إذ كانت باردة ومخيِّبة للآمال.
قال له: «قد يظن المرء من لهجتك أنك لا تهتم لأمر ابنتي.»
كانت ميدينا-ساروتي هي التي حاولت إقناع نونيز بالتوجه إلى الجراحين العُميان.
قال لها: ««أنت» لا تريدينني أن أفقد نعمة بصري»؟
هزَّت رأسها.
«عالَمي هو البصر.»
طأطأت رأسها أكثر.
أضاف: «هناك توجد الأشياء الجميلة؛ الأشياء الصغيرة الجميلة؛ الأزهار، والأشنات التي تنمو بين الصخور، وبريق قطعة من الفراء ونعومتها، والسماء البعيدة، بما تحمله من سحب، والغروب، والنجوم. وهناك «أنتِ». لأجلك أنتِ فقط، من الرائع أن أملك البصر؛ لأرى وجهَكِ الحُلو الرائق، وشفتيكِ الرقيقتين، ويديكِ الجميلتين الحبيبتين وهما متشابكتان … إن عينيَّ هاتين هما مغنمك، هاتان العينان اللتان تعلِّقانني بكِ هما ما يسعى وراءه هؤلاء الحمقى. من دونهما، سيكون عليَّ أن ألمسك، وأن أسمعك، وألَّا أراكِ ثانية. سيكون عليَّ أن أدخل تحت ذلك السقف المصنوع من الأحجار والصخور والظُّلمة؛ ذلك السقف المريع الذي يتدنَّى تحته الخيال … لا، أنتِ لن تريدي لي ذلك، صحيح؟»
داخَلَه شكٌّ بغيض، فتوقَّف عن الحديث وترك السؤال معلَّقًا.
قالت له: «أتمنى … أحيانًا …» وسكتت.
قال بتوجُّس: «نعم …»
«أتمنى أحيانًا، ألَّا تتكلَّم بهذه الطريقة.»
«أي طريقة؟»
«أعلم أنه جميل، ذلك الذي تتخيله. أحبه خيالك، لكن الآن …»
شعر ببرودة، وقال بصوت خافت: «الآن ماذا؟»
ظلت جالسة في وجوم تام.
«أنتِ تعنين — تعتقدين — أنه سيكون أفضل أن أكون، ربما الأفضل أن أكون …»
كان يستوعب بسرعة بالغة؛ فشعر بالغضب، كان غاضبًا حقًّا من تصاريف القدر القاسية، لكنه شعر أيضًا بتعاطف معها لعجزها عن الفهم، تعاطفٍ أقرب إلى الشفقة.
قال لها: «حبيبتي.» وكان يرى من خلال شحوبها مقدار الضغط النفسي الذي كانت تعانيه بسبب الأشياء التي لم تستطع قولها. أحاطها بذراعيه وقبَّل أذنها، وجلسا صامتَيْن لبعض الوقت.
أخيرًا، سألها بصوتٍ بالغ الترفُّق: «لو أني وافقتُ على هذا؟»
طوَّقته بذراعيها وأجهشت بالبكاء. «آهٍ لو أنك توافق.» قالت مواصلة النحيب: «فقط لو أنك توافق.»
- ••
طوال الأسبوع السابق لموعد العملية التي هدفت إلى رفعه من منزلة التبعية والنقص إلى منزلة المواطن الأعمى، لم يذق نونيز طعم النوم، وخلال ساعات النَّهار الدافئة، بينما كان الآخرون ينامون هانئين، كان هو يجلس متفكرًا، أو يَهِيم على وجهه بلا هدف، محاولًا شحذ عقله للتعامل مع الأزمة التي كان يمر بها. كان قد ردَّ عليهم بالفعل، وأعطاهم موافقته، لكنه لم يكن واثقًا بعد. وأخيرًا انتهى وقت العمل، وأشرقت الشمس بكل بهائها على القمم الذهبية، وبدأ يومه الأخير في عالَم الرؤية. وقد حظي ببضع دقائق مع ميدينا-ساروتي، قبل أن تذهب إلى النوم.
قال: «غَدًا … لن أعود قادرًا على الإبصار.»
أجابته: «يا حبيب قلبي!» وضغطت على يديه بكلِّ قوَّتها.
وتابعت: «سيؤلمونك، لكنه ألم يسير، وسوف تتغلب عليه، سوف تتغلب عليه يا حبيبي؛ لأجلي «أنا» … حبيبي، لو كان لقلب امرأةٍ وحياتها أن يعوِّضاك، فسأدفعهما لك. حبيبي الأوحد، حبيبي ذا الصوت الحنون، سأعوِّضك.»
كان يغمره شعور بالشفقة لحاله ولحالها.
احتضنها بين ذراعيه، وطبع قُبلة على شفتيها، ناظرًا إلى وجهها الحُلو للمرة الأخيرة. همس لتلك الصورة العزيزة على قلبه: «وداعًا! وداعًا!»
ومن ثم تولَّى عنها في صمت.
كان بإمكانها سماع وقع خطواته البطيئة المبتعدة، وقد وجدت في إيقاع تلك الخطوات ما هيَّج دمعها.
كان عازمًا على الذهاب إلى مكانٍ خالٍ، حيث المروج الجميلة وأزهار النرجس البيضاء، والبقاء هناك حتى تحين ساعة التضحية، وبينما هو ذاهب، كان يرفع عينيه إلى أعلى متأملًا الصباح؛ الصباح الذي يشبه ملاكًا بدرع ذهبي يتنزل عبر المنحدرات.
أمام تلك الروعة، بدا له أنه هو، وهذا العالم الأعمى في الوادي، وحبيبته، والجميع، لم يكونوا سوى خطيئة كبرى.
وبدلًا من أن ينعطف كما كان ينوي أن يفعل، واصل المضي قدمًا، واجتاز الجدار المحيط، خارجًا نحو الصخور، بينما كانت عيناه معلَّقتَيْن بالجليد والثلوج التي تضيئها أشعة الشمس.
شاهد جمالها اللانهائي، وحلَّق خيالُه إلى ما وراءَها من أشياءَ يُفترض به أن يودِّعَها الآنَ وإلى الأبد.
فكَّر في ذلك العالَم الحر العظيم الذي أُبعِد عنه؛ العالَم الذي كان له يومًا ما، وقد راوده مشهد تلك المنحدرات البعيدة، رقعة بعيدة بَعد رقعة، وبوجوتا، موطن جمال مثير متعدد الأشكال، بهاء في النَّهار، غموض متألق في الليل، موطن القصور والنوافير والتماثيل والمنازل البيضاء، مستلقية على نحو جميل تتوسط تلك البقاع. وفكَّر في أن الواحد قد يستغرق يومًا أو أكثر ليقطع السبل مقتربًا أكثر فأكثر من شوارعها وطرقها المزدحمة. فكَّر في الرحلة النهرية التي تنطلق يومًا بعد يوم من بوجوتا العظيمة إلى العالم الأوسع الرابض خارجها، مارَّةً بالمدن والقرى، بالغابات والصحاري، والنهر المندفع يومًا بعد يوم، إلى أن تتناءى ضفَّتاه وتأتي البواخر الكبيرة ماخرة عُبابه، ويكون الواحد قد وصل إلى البحر؛ البحر اللامحدود، بآلاف جُزره، آلاف جُزره، وسفنه التي تَلُوح باهتة من بعيد، في رحلاتها الأبدية حول ذلك العالَم الأعظم. وهناك، بغير حِجاب من الجبال، يرى الواحد السماء؛ السماء الحقيقية، التي لا تشبه القرص الذي يراه في الوادي، بل هي قوس من الزُّرقة اللامحدودة، وهي غور الأغوار الذي تسبح فيه النجوم الدوَّارة.
حدَّقت عيناه في الستار الجبلي العظيم بنظرة بفضول أشد.
فكَّر مثلًا في إمكانية الذهاب بذلك الاتجاه، والصعود بمحاذاة الأخدود، ثم تسلُّق العمود الصخري هناك؛ ومن ثم قد يرتقي المرء إلى أعلى، ليصير بين أشجار الصَّنَوْبر القصيرة تلك، التي التفَّت فيما يشبه الرفوف، وبَسَقت أعلى فأعلى، معتلية الشِّعب. ثم ماذا بعد؟ يمكن التعامل مع تلك الكتلة من الصخور المتشظية المنحدرة؛ ومن ثم قد يجد المرء في نفسه القدرة على التسلق، ليصل إلى الجُرف الواقع أسفلَ الجليد. وفي حال فشل في تسلُّق العمود، فيمكن لعمود آخر بعيد يقع إلى جهة الشرق، أن يفيَ بالغرض على نحو أفضل. ثم ماذا بعد؟ ثم سيخرج المرء ليصير فوق الثلوج المضاءة بأشعة الشمس البرتقالية في الأعلى، ويكون بذلك في منتصف الطريق إلى قمة تلك الخلوات الجميلة.
نظر إلى الوراء، ملقيًا نظرة على القرية، ثم التفت نحوها بكُلِّيَّته، وحدَّق إليها مَلِيًّا.
مرَّت ميدينا-ساروتي بخاطره، لكنها صارت الآن ضئيلة وبعيدة للغاية.
من جديد، التفت إلى الجدار الجبلي المشرف على المكان الذي حانت فيه ساعة تخلِّيه عن عينيه.
ثم شرع في تسلُّق الجدار بحذر بالغ.
بحلول غروب الشمس، كان قد كفَّ عن التسلُّق، لكنه كان قد ابتعد وارتفع. كان معتادًا على الوصول إلى ارتفاعات أكبر، لكن الارتفاع الذي وصل إليه كان لا يزال شاهقًا. كانت ملابسه ممزقة، وكانت أطرافه ملوثة بالدماء؛ إذ أصابته كدمات في أكثر من موضع، لكنه استلقى كما لو كان في أفضل حالاته، وارتسمت على وجهه ابتسامة.
من حيث كان يستريح، بدا له الوادي كما لو كان واقعًا في هُوَّة، على بُعد ما يقرب من ميل. كان المكان معتمًا بالفعل، تحت تأثير الضباب والظلال، ومع ذلك فقد بدت له قمم الجبال المحيطة به، كتلًا من النور والنار، وكانت تفاصيل الصخور الصغيرة القريبة منه غارقةً في جمالٍ أخَّاذ؛ حيث تتداخل معادنُ خضراء مع أخرى داكنة، وتبرق الأسطح الكريستالية هنا وهناك. وللحظة، كان بالقرب من وجهه أُشْنة برتقالية اللون ذات جمال لحظي. كانت هناك ظلال عميقة غامضة تكسو الوادي الضيق، وغاصت الزرقة عميقًا في اللون الأرجواني، وغاص الأرجواني في ظلمةٍ بهيَّة، وقد غطت ذلك كلَّه رحابة السماء التي لا يحدُّها حد. لكنه لم يَعُد عابئًا بكل تلك الأشياء، واكتفى بالتمدد هناك بتراخٍ تام، وكان يَبْسِم كما لو كان يشعر بالرضى — فقط — لأنه هرب أخيرًا من وادي العُميان الذي كان يظن أنه سيكون فيه «الملك».
انقضى ألْقُ المغيب، وهبط الليل، وما يزال نونيز يرقد بسلام مسرورًا، تحت النجوم الساطعة الباردة.
