
تشهد رواية «حيزيا» لواسيني الأعرج، ركاماً مضطرباَ من الأنساق الثقافية المتنوعة، لكن، دون مراعاة من الكاتب للسياقات الثقافية والهوياتية للمكان والزمن المرجعيتين في النص السردي، ما أنتج ركاماُ موازيا من الارتباكات:
أولا- الارتباكات المعرفية في تأثيث المكان:
في أول تيه معرفي بالمكان الروائي، يثبت الروائي أن منطقة سيدي خالد، الصحراوية، مشهورة بالزلازل، وهي التي لم يسجل أي زلزال في تاريخها ـ فضلا عن أنها منطقة صحراوية، ولا أحد يدري على أي منطق أسس الكاتب وصفه للمكان الذي يبدو أنه لا يملك عنه معرفة كافية، حين نراه يلصق بمكان القصة ما ليس من طبيعتها، فزاد للرواية نشازاً ولقصة حيزية اغتراباً عن مكانها: (إن الكأسين مثبتين في الرف، مخافة أن يسقطهما زلزال، هذه المنطقة مشهورة بالهزات الدائمة).
وفي ارتباك معرفي آخر بالمكان، يؤثث الكاتب منطقة سيدي خالد في ريف بسكرة (أولاد جلال حالياً) بمعالم لم تكن يوماً هناك. ولم توجد حتى هذه اللحظة، كالمطارات مثلا: (كنت أرى الطائرات وهي تنخفض كأنها تستعد للنزول في أحد المطارات القريبة).
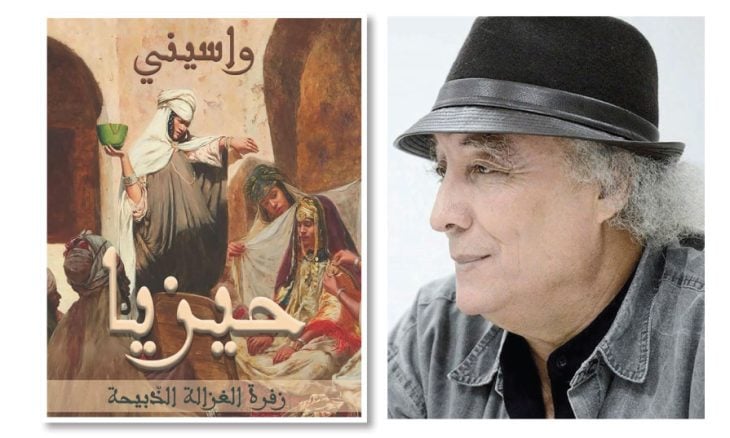
وفي فقرة ثانية يؤكد: (سمعت للمرة الثانية أزيز طائرة، تتبعت طريقها، ودرجة انحدارها، وقوة محركها، تأكد لي بما لا يدع مجالا للشك، أنها شرعت في النزول. المطار لم يكن بعيداً).
وفي تيه معرفي ثالث، يتحدث الكاتب عن شجرة «الأرقن»، التي يعتقد خطأ بأنها تنبت في صحراء الزاب الغربي في منطقة سيدي خالد، (موطن قصة حيزية الأصلي)، يقول الراوي عن البطل خالد أثناء توجهه لصومعة جامع النبي في سيدي خالد: (وضع أصابعه في فمه حتى لا يطير الشاش، متخفياً وراء شجرة الأرقن، هي شجرة مباركة سمع عنها الكثير في طفولته، بل وعرف تفاصيلها وفوائدها من جدته). ومعروف أن شجرة الأرقن أو الأرقان هذه، ليست من نباتات بوابة الصحراء، وما كان لها أن تنبت هناك، لأن البيئة الأصلية لهذه الشجرة هي منطقة الساحل الافريقي والصحراء الكبرى، ولا يمكن أن تنقل لمناطق شمالية مثل مدينة بسكرة، التي لها نباتاتها الخاصة التي لم تكن من بينها شجرة الأرقان في يوم من الأيام، ولعله اعتقد (نظراً لقلة الإحاطة المعرفية بالأمكنة) بأن أي نبتة صحراوية يمكن أن تنمو في أي مكان من الصحراء، وهذه أكبر مغالطة بيئية. لا يمكن للخيال أن ينشئها، وهو يؤثث لثقافة المكان. وفي استزراع ناشز لعنصر ثقافي غريب في البيئة التي تتحدث عنها الرواية، يجلب الروائي لمنطقة سيدي خالد آلة الإمزاد، والشاش التارقي وهما أيقونتان ثقافيتان أمازيغيتان من ثقافة التوارق، الذين ليسوا من سكان هذه المنطقة، التي لها شاشها الخاص وآلاتها الموسيقية الخاصة، ولا ندري ما وظيفة الشاش والإمزاد التارقيين، في هذه المنطقة التي ليست أمازيغية ولا تارقية، ومع ذلك يؤثثها الكاتب بعناصر من تلك الثقافة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام. في قوله: (انكفأ خالد على وجهه بعد أن غطاه بالشاش الترقي). وفي قوله على لسان لالة ميرا (التي ينادونها سلطانة، وهي في الأصل: تمالا ابنة حيزيا): (كلما توحشت أمي القايمة، أو حيزيا أخرجت الإمزاد واستدعيت، الإمزاد يعيد الأرواح الضائعة على الوجود، جاءها بالإمزاد القديم، وضعه في حجرها وجلس بالقرب من خالد شدت خيط الإمزاد بقوة، ثم بدأت تعبث به جيئة وذهاباً، ثم التفتت نحو حشاني: جيب لي الإمزاد الكبير، اللي من جهة قبر سيدي خالد، دخل حشاني بعد لحظات، حاملاً الإمزاد الكبير في يده ثم وضعه في حجر سلطانة احتضنته قليلاً، ثم عزفت بكل شوق).
ولم يبرر الكاتب فيه سبب زجه بالثقافة الأمازيغية التارقية العريقة، في صلب الثقافة الهلالية التي تنبت فيها قصة حيزيا التي أسس عنها روايته.
ومن أغرب التأثيثات الثقافية للمكان في الرواية، أن الجازية زوجة جلول لديها ليسانس، وكانت في مدرسة رقص وكورال في بسكرة»، وفي المرجعية التاريخية للمكان، وطوال التاريخ الثقافي لمدينة بسكرة، لم تشهد هذه المدينة أي مدرسة للرقص، سواء في الحقبة العثمانية أو حقبة الاستعمار، أو ما بعد الاستعمار، ولا حتى في يومنا هذا، حيث لم تشهد المدينة يوما تأسيس ولو قسم واحد ولم تعرف حتى يومنا هذا، أي نوع من التكوين أو التمدرس في الرقص، فبأي تخييل أو مرجعية تاريخية، يؤسس الكاتب، لنوع من الثقافة في مكان لم يشهدها أبدا في تاريخه، فهل يسمح التخييل بتأثيث الأمكنة ثقافياً بما لم يكن من ثقافتها، يوماً؟ تقول الرواية: (ستعود للتدريس، عندها ليسانس، وكانت في مدرسة رقص وكورال، في بسكرة)، أم أن الكاتب يظن أن مدارس الكورال الموجودة في رواياته الاستغرابية، يصلح زرعها في أي مدينة أو مكان يتحدث عنه، حتى إن لم يعرف ذلك المكان شيئاً من تلك الثقافة في حياته.
وفي مفارقة مكانية أغرب، ينسب الكاتب إلى بلدية الدوسن، وجود المستشفى الجهوي بها، حينما تريد الجازية (وهي من قرية سيدي خالد) أن تلد، فيأخذوها إلى الدوسن وليس إلى أولاد جلال، التي تقع بين سيدي خالد والدوسن، وهي الملاصقة لسيدي خالد، وتحتوى على أكبر مستشفى تاريخي في المنطقة. بينما يستحيل الوصول من سيدي خالد إلى الدوسن دون العبور على مستشفى أولاد جلال، وهو الأكبر في المنطقة منذ أقدم العهود، تقول الرواية: (لم تنفع الإسعافات البعيدة، إذ كان عليها أن تقاد حتى الدوسن.. كادت تموت).
والمستغرب، هو كيف تؤخذ امرأة في حالة استعجالية من الولادة، إلى قرية الدوسن، التي لا طريق لها من سيدي خالد، إلا العبور الضروري على مركز مدينة أولاد جلال التي فيها أكبر مستشفى في المنطقة الذي يعالج فيه أهل الدوسن أنفسهم والقرى المجاورة لمدينة أولاد جلال التي لا تفصلها عن سيدي خالد إلا 7 كلم، بينما تبعد الدوسن التي تقع على الطرف الآخر من أولاد جلال حوالي 30 كلم.
ما يعني أن الثقافة الموظفة في الرواية لا علاقة بثقافة المنطقة التي تدور فيها أحداثها، والمكان الروائي لا علاقة له بالمكان المرجعي الذي دارت فيه أحداث القصة والواقعية لحيزية. ولا حتى الزمن ويحتمل أن تقع فيه نوازل يبتكرها المخيال، كنزول الوحي، وظهور البارود لدى القبائل العربية قبل بعثة النبي محمد (ص). وهذا ما أثر بشكل عميق في منطق السرد، وتمزيق حبكته، ومنطقه، إذ لا يعقل أن شخصيات راسخة الأصالة في المكان لا تعرف اتجاهاته ومعالمه وطرق السير فيه؟
ثانياً- الارتباكات اللغوية
وكباقي روايات واسيني السابقة تتكرر الهجنة اللغوية، التي تطمس هوية المتكلمين، تبقي القارئ حائرا في هوية الشخصيات ومنابتها، حيث تخاطبنا حيزية، باللهجة العاصمية، وهي التي لم تزر العاصمة قط، ولا علاقة تربطها بها، فتقول لسعيد: (حبيبي سعيد ديالي)، وكلمة «ديالي» في اللهجة العاصمية، تعني «ملكي» أو «لي»، والمعروف لي لهجة الزاب الغربي من بسكرة، هو لهجتهم الهلالية، التي تستعمل لفظة «تاعي» للتعبير عن الملكية، أما كلمة «ديالي» فهي منطوق خاص بالعاصمة الجزائرية حصراً. وفي المغرب الأقصى. وليس في الصحراء الجزائرية. كما تنادي حيزية جدتها في الراوية بكلمة: [حنا]، وهو لقب يطلق على الجدات في الغرب الجزائري تحديداً، (خاصة تلمسان موطن الكاتب)، لكنه ليس من ألفاظ الصحراء ومنطقة الزاب أبداً، حيث يشار إلى الجدة بكلمة [نانا]، أو [جدة]. ولم تدرج هذه الكلمة يوماً كلمة حنا من بين مسمياتها.
– ومن النشاز اللغوي، ما نقرأ في الرواية على لسان سعيد عشيق حيزية، حين يقول: (واووووو سيدي عبد الرحمن موجود إذن). لتجيب حيزية، حين خاطب سعيد قائلة: (واووووو ما أجمل الاسم). ومن الشطط عن المنطق السردي أن نقنع القارئ أو نعتقد أن هذه الكلمة (المعبرة عن الدهشة) وهي المجلوبة من البيئة الأمريكية وعبر وسائل الإعلام العالمية، كانت موجودة في منتصف القرن التاسع عشر ورائجة بين قبائل البدو الرحَّل من بني هلال في فيافي الصحراء الجزائرية.
وكذا كلمة [بابا] التي ينادى بها الأب، والتي يستحيل أن يكون لها وجود حتى بين المدن الجزائرية في منتصف القرن التاسع عشر، فما بالك إن سمعناها تقال لدى البدو الرحل من بني هلال، في ذاك الزمن الغابر، كأن تنادي حيزية أباها: (يا بابا العزيز يعلم الله كم أحبك).
وما هذا إلا غيض من فيض من الأخطاء المعرفية التي تنم عن فجوة ثقافية ومعرفية عميقة تفصل الروائي عن البيئة والهوية الثقافية للنص الذي يكتبه.
ثالثاً- الارتباكات الثقافة الدينية في الرواية
من غريب الأخطاء المعرفية الواردة في هذه لرواية، الأخطاء في المعرفة الدينية، وما زاد في فداحتها أن المنطقة التي تشتغل الرواية على ثقافتها هي منطقة تميز بعمق الوازع الديني وقد تصل حد التشدد حين يحدث أي خلل في الممارسة أو الشعائر، لكن الروائي، يورد أخطاءً معرفية ساذجة تعلق ببديهيات صلاة الجنازة التي اعتقد بأنها تؤدى جهراً، يقول الراوي: (صلى بن قيطون صلاة الجنازة، قرأ الفاتحة بصوت مرتفع وكأنه كان يريد أن يوصل آلامه لكل الحاضرين، وعندما وصل إلى «وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت» توقف بعد أن خانه صوته نهائياً انتابته بحة، ثم كحة ثم حشرجة كادت تخنقه.. لم يستطع إنهاءها، فأنهاها إمام جامع سيدي خالد الحاج ميمون بوعكاز). وما يصعب تخيله هنا، أن الشاعر محمد بن قيطون رجل دين وإمام معروف، فكيف يجهل أدبيات أداء الجنازة؟ وإن افترضنا أنه فعلها متعمداً، كيف يهدم الإمام ديناً وهو من يقوم به بين الناس؟
تحدث المغالطة المعرفية، حينما تختل أو تغيب أبسط المعارف الشائعة في الحياة الثقافية التي يكتب عنها وبها الروائيون، فقد يرفرف التخييل عبر كامل سماوات الإبداع، لكن الخطأ المعرفي في بناء أو إعادة بناء ثقافة نصية ما، يخرب التخييل، ويكسر منطق النص ويشوه وجهه الفني. وأعتقد أن جوهر الخلل في الانهيار المعرفي الفادح الذي وصل حد قلب الخريطة الجغرافية، والتاريخية والثقافية واللغوية والدينية للمنطقة يعود إلى التسرع نحو نشر النص، قبل نضجه أو بالأحرى إنضاجه، بتقصي المعلومة، ومعايشة الثقافة، والبحث الأولي البسيط حتى ولو في الإنترنت، التي قد تصحح المعارف الابتدائية في حياة المجتمعات ذلك أن السرديات الثقافية التي تتمرجع بالمكون المعرفي، تاريخياً وجغرافياً وثقافة لتجعل منه معياراً لقراءتها وتحليلها، بما أنها تشتغل على خلفيته ومرجعيته الواقعية والتاريخية. التي لها حيزها المعلوم في ثقافات الشعوب والأمم.

تعليق واحد
قراءة واعية وناضجة لرواية فقيرة للمعلومة، وغير ناضجة..
تقديري أستاذنا..