
لم يكن الحرف سوى مضغة طفل.. أو حلمة رضاعة استبدلها الزمن بدلا من حلمة الأم، لذا حين كان البكاء سيّد الموقف، ليس احتمالا لجوعٍ، بل هو احتجاجٌ كاملٌ على الإفلات من الحزن إلى تحشيد الصورة التي لم تكن مركّزة بشكلٍ واعٍ على كلّ ما يمكن أن يكون في متّسعه ليشكّل محطة أولى للانطلاق.
لم يكن الحرف سوى لحظة طلقٍ ثانية، بعد أن كانت الأولى عبارة عن محطّة قطارٍ لم تكمل عامها الثاني، فنزلت الأمومة من صهوة حصانها إلى مدفنٍ أرضي ليغيّب عمرا لم يتجاوز الخامسة والعشرين، وتضيع السنوات التي بعدها هباء في الحروب.
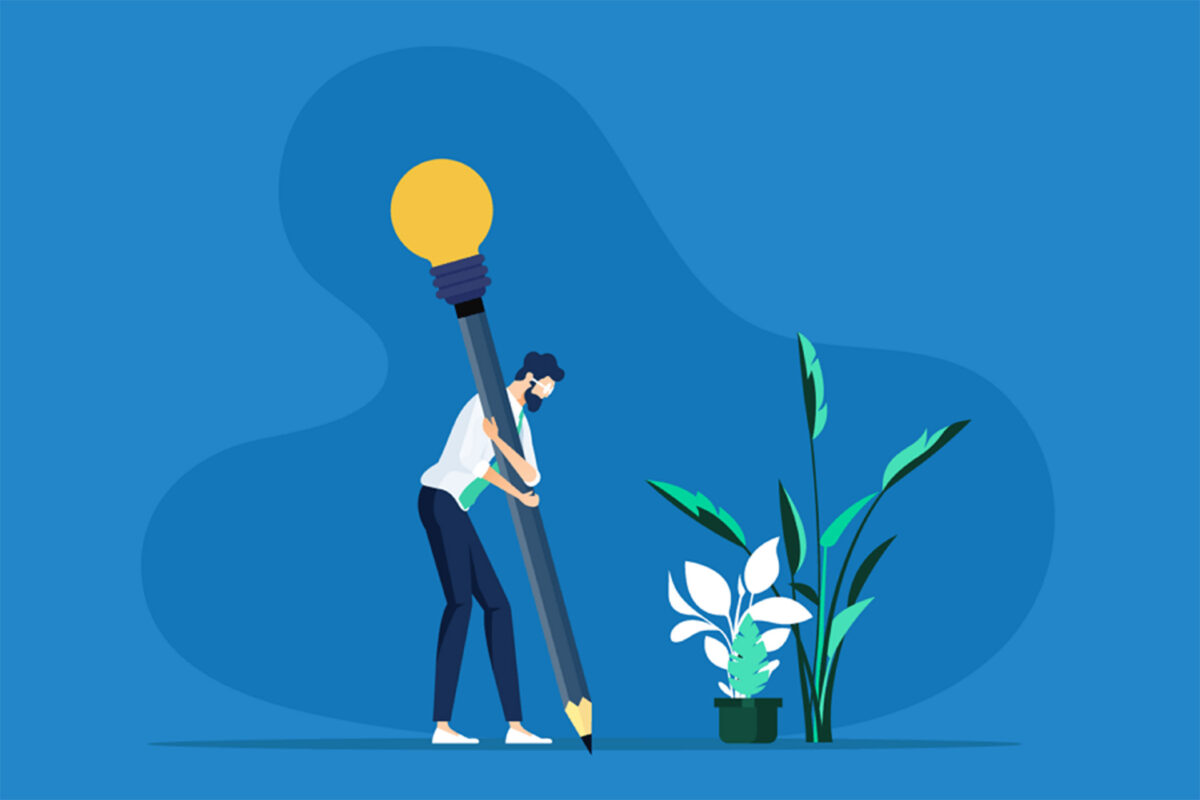
كان الحرف ملاذا.. كأنه ضوءٌ ساطعٌ مثل أفلام الرعب أو الأكشن.. فتتحوّل الأفكار إلى علامات استفهامٍ كثيرة.. ولأن الجسد بلا حضن، كان المسيرُ أعرجَ، والحرف وحده من يسند القامة، لعلّ أحدا لا يتنمّر حين أُطلق بعضه، وهو يلفظُ حرفَ الراء غينا.. فهرب من الشعر والإلقاء إلى القراءة والصمت والمتابعة لما يحفره الكتاب ليأخذه إلى متاهات الوجود..
كان الحرف سوء طالعٍ أيضا.. لأنه يزيد الفقر فقرا، والنظرة إلى العالم بطريقةٍ لا تتوافق مع الواقع، والعكس صحيح، حيث ينظر العالم الآخر البسيط المحيط والبيئة، إلى الحرف على أنه مضيعة وقت. لكنه أي الحرف لم ينفع مع الحرب.. ولم ينفع أن يكون ملجأ من الصواريخ والجبهات والسواتر. وكم حاول أن يكون جملا طوال أحد عشر عاما من الانفجارات والرمال، والموت والجراح، والإجازات والجبهات والعقوبات والتفكير بالهرب واللجوء، لكنه كان يرسم الكذب ليجمّل عمره، ويخاف من قولِ ما يريد، مخافة أن تسحق الرقبة أو يثقب الرأس. تلك كانت المحطات الأولى التي نما فيها الحرف حتى استقام عوده.. وقد كبر وشعر بنفسه أنه يكبر، كلما قرأ كتابا ولاذ برفوف الكتابة في سوق الشيوخ، وكأنها رفوف العمر، واتّكاءات الحياة، ومنقذة الفشل الذريع في إيجاد صنوٍ آخرَ للحزن غير الحرف.. وكأنه أسف على ما فات، وملاذٌ على ما سيأتي، فلم يجد الرأس غير الحرف، ولم يجد القدر مجالا آخر، حتى لو كان يدندن بأغنيةٍ، لعلّه ذات يوم يعرف الأطوار والمقامات ليغنّي، لكنه الحرف الذي كلّما هرب لاحقته الأقدار، ليأتي إلى ثنايا الروح، مثل مولدٍ أعرجَ لم يصلِّ في محرابٍ، ولم تغشّه زليخة، ولم يرمه أحد في الجب لتأتيه السيارة، ولم يصعد جبلا ليقطّع حمامة وتجمعها الغرائبية، ولم يتراكم مجالا للصبر ليأكل دود تحمّله ويتمه.
لم يكن الحرف أب يوسفٍ ليُرمى عليه القميص ذات عمي.. كان ابن فقيرٍ تعرفه المدينة، لأنه صديقهم أيام الدراسة، حيث يوزّع عليهم المحبّة بالمجان، ويقضم أصابعه في المساءات، بحثا عن لحظةِ صفاءٍ بلا لذّة، كي يعيش الطفل في رحم الحرف. كانت الأسئلة تتراكض لتتخم الحرف سمنته، وتمنحه لونه، وتخيط مقاس ما يرتديه، فتتآلف قلوبُ ما تناسل منه وما انشطر، وإن تعلّقت كلّ الولادات بروحه وشكله ومعناه، فلم يغادر (حزنه) بعد أن جعله دوحته الكبرى والمصير الأخير، وإن تنازعته وتقاطعت معه الحاجة والعمل والفقر. فكان رفيق درب في الأحياء الصناعية في سنوات الحصار، كأوّل دوّار فيها، يبسط الأدوات كما يبسط الحروف على سجّادة الورق، لعلّه يحصد رزقا يعيل به أطفالا كبروا وصاروا خمسة بقامات الرجولة والأنوثة..
كان يتقاسم كلّ شيء.. الأكل والملبس، السياسة والفقه، الدهر والحاجة. السؤال والإجابة.. الأمل والخيبة، الضغينة والجمال.. لذا كان عليه أن يولد بعظمٍ ليس فيه هشاشة، وليس فيه قوة، لكسر إرادة الجملة التي سيسعى لتكوينها ويصيّرها عمرا وأبناء رؤى ورؤية، ومتاهات وصراعات وبحوثا وأبحاثا.. كان الحرف أشبه بمجرى نهرٍ صغيرٍ، حفر في مزرعةٍ لا يعرف صاحبها ماذا يزرع، وماذا ستكون وكيف يسقي تفاصيلها.. ثمة أشياءٌ تدور في المخيّلة كلّما قرأ كتابا أو سمع حكاية أو استنطق معلومة، فتسري المياه في شرايينه، ويتحوّل إلى عروقٍ، كلّما ازْداد سمنة، وتعود الحفر ليسقي بستانه الذي تحوّل إلى بساتين من أعنابٍ وأرطاب وما زقزق بينهما عصفور وبلبل، ولم يغافل وجود الغراب والهدهد وحتى (سْحير الليل).
كان يعوض حرمانه بانتفاخة الاطّلاع، كأنه هروبٌ إلى محنٍ أخرى، وأقدارٌ جديدةٌ ومسالكٌ متهاويةٌ منفوخة الأوداج، تعبر الأنهر وتطير عبر فضاءاتٍ تارة ضيّقة وأخرى واسعة، لعلها تلتقط الحب الناضج من رحلة الصيد، ويجمع مؤونة الرحلة إلى أيامٍ لا نصيب فيها، وعمرٍ لا ناقةَ له من الحرب، ولا غناء له غير بحّةٍ جنوبيةٍ طوّقها الحصار بالألم والجوع والقمع والكبت والصبر، فحوّلته من حرفٍ يريد الطيران إلى حرفٍ يبحث عن عنادٍ آخر في التجوال.
إنه الحرف الذي طرّز ألوانه بأسماءٍ ثلاثة، كونّت اسما أريد له أن يكون في دائرة الضوء، فانتبذ مكانا وسطا يعلّق عليه الآمال، كلاما سار في الطريق مع الآخرين أو وحيدا، كونه لا يخاف اقتحام المسالك الملغّزة أو المعروفة.. ويجذب الغيم إلى واحته لعلّه يقول أينما تمطرين فأنت تسقين زرعي وحرثي وقوامي وأفكاري، فلا خوفَ عليك من هدر المطر، فكل بستانٍ لك أغنية، أو حتى صولة.. إنه الحرف الذي كلّما جمع رطبَ الكتب رشّوا عليه أسمدة الكراهية أو الحسد، فيرمونه بحجر الانتقاص مرّة أو الاتهامات مرّة أخرى، منيبون عنه أن يسلك سبيلا واحدا لحجّة التمكّن تارة، أو عدم التبعثر تارة أخرى أو التشظّي والفشل، دون أن يكلّف مطلقوها فرصة واحدة لأنفسهم لقرأوا الحرفَ كيف صيّر نفسه وكيف وُلدَ وكيف نمى على الورق وصار كتابا، سواء شعرا أو قصة أو رواية أو نقدا أو حتى مقالة أو خبرا صحافيا، فهو يصرخ منذ عقود أنه حرفٌ ولا شيءَ غيره.. وأنه صار خياطا ماهرا لا يجوب الأزّقة لينادي على بضاعته، ولا يمتحن الصبر ليعلن البراءة من المكوث، ولا يصمت لكي يرضي الآخرين، ولا يهادن ليموت في داخله العناد، بل هو يرمي ردّة الفعل على فعل الانتقاص، بمزيد من الحروف، كأنه يفتح حنجرته ليخرج من أوتارها ما صار من زواجٍ بين المخيلة والكتابة.
لكنه للآن، وهذا الحرف لم يدرك معنى الوطن، كيف يكون أمام محنة السلطة، فكان يعد النسر ليأكل جيفة السياسة، ويعد الغراب ليحفر قبر الفقه، وكان يطلق سراح ما تناوشته الكلمات لعله يأتي بخبرٍ كلّما دخل عليه محراب اللغة وجده يصوغ معناه. لم يدرك معنى الوطن، فاستعاض عنه بالبلاد كي يزيح الطغاة، وكلّما صار الحرف كتابا زادت محنته.
