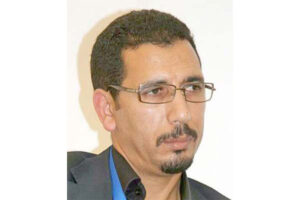
منذ ثورة الشكل الشعري، التي كرست مبدأ الاختيار الحر الناظم للموضوع، وفق رؤية شاملة، لم يعد للقصيدة جهازٌ قَبْلي تصدر عنه، أو تُحيل عليه، وهو ما قاد إلى بروز أشكال وظواهر فنية جديدة يكون الشاعر الحديث قد ابتكرها من ورشة جهده الإبداعي، أو استلهمها من قراءاته للشعر العالمي، أو لنظرية الأدب الحديث. فقياسا إلى مبدأ الهدم وإعادة البناء، الذي يتقاطع مع حرية ذات الشاعر وفرادته، وثرائه الأسلوبي، وطبيعة التجارب أو المصادر التي تُغذي عمله الشعري، ومع رغبته في التجاوز المستمر للأشكال، كان معمار القصيدة الحديثة والمعاصرة لا ينقطع عن شهوة الابتكار والتجريب، ويغتني بهذه الأشكال والظواهر على الدوام، كما تأثر بذلك جسدُها الطباعي- الكتابي (فواتح استهلالية، علامات ترقيم، فراغات، فواصل بين الجمل أو المتواليات، مقاطع ولوحات مُرقمة أو حاملة لعناوين فرعية، تخطيطات ورسوم كاليغرافية وفوتوغرافية)، بل إن بنية القصيدة صارت من التركيب والثراء والانفتاح إلى حد أن مفهومها الجاري لم يعد يعكس تطورها وتَعقد وضعيتها الكتابية كنص وخطاب في آن.

بيانات الكتابة
توجهت جهود الشعراء إلى استثمار المؤشرات الطباعية والإفادة من وسائل التوزيع الخطي بشكل أدخل القصيدة في «تعددية معقدة التوزيع». وفي هذا السياق، كان شربل داغر، ابتداء من كتابه «الشعرية العربية الحديثة» (1988)، من أوائل النقاد بدراسة هذه التنويعات الطباعية، التي هي جزء من التحويل الشكلي- الجمالي الذي ميز القصيدة الحديثة وشكلها الخطي، ما سمح ـ في نظره- بانبثاق «شعرية عربية بصرية» نقلت القصيدة من «العهد الشفوي» إلى «العهد الكتابي- البصري». فقد قلص تنوعُ الأشكال والأنماط البنائية داخلها من بعدها الشفاهي- الغنائي الذي ظل يتحكم في نظام دوالها الداخلي وخواصها البنيوية (وحدة الوزن والقافية، التوازي، التكرار، التناظر السيمتري)، مثلما كرس هذا المتغير الرئيسي فعلَ الكتابة كمفهوم وممارسة، وتماهى مع ما كان يتطلع إليه المشهد الشعري المعاصر منذ سبعينيات القرن العشرين، تحت تأثير الرغبة في التجريب ونقض المُجْمع عليه، من تحولٍ دائم في الشكل وتعددية الأجناس والفنون التعبيرية العابرة إليه، بوعيٍ من الشاعر أو في غفلةٍ منه.
أخذ النزوع الكتابي يمارس، تدريجيا، فعله المؤثر في القصيدة، وصاحب ذلك نشاطٌ معرفي وتأملي كانت تُمليه مجموع البيانات النظرية والدراسات النقدية التي سعت إلى تأسيس التصور النظري للكتابة الشعرية الجديدة، وممكناتها النصية والجمالية، لكل من جبرا إبراهيم جبرا وخالدة سعيد ويوسف الخال وعز الدين إسماعيل ومحمد النويهي، وكمال أبوديب ومحمد مفتاح وغيرهم. مثلما ساهمت بيانات الشعراء فرادى وجماعات في تكريس هذا النزوع، كما الحال بالنسبة إلى «جماعة شعر 69» في العراق، التي وقع أفرادها (فاضل العزاوي، وسامي مهدي، وخالد علي مصطفى وفوزي كريم) على ما سُمي بـ»البيان الشعري» في انحيازه إلى دور الحلم، وتأكيد المغامرة في الإبداع، وإلى قيمة مراجع الأسطورة والتصوف والفلسفة، في توسيع الرؤية الشعرية، وفق منظور «أكثر ثورية» يلتزم فيه الشاعر ببحث الحقيقة في ذاته وليس في الوهم والشعارات الأيديولوجية. ويبقى أدونيس أكثر هؤلاء حماسا وتنظيرا، في التعبير عن هذا الإبدال الجديد منذ دعوته إلى «تأسيس كتابة جديدة» (1971). بموازاة هذا النص- البيان النظري المُطول الذي ظهر على ثلاث حلقات في مجلة «مواقف»، الأعداد 15 و16 و17/ 18، 1971، نشر أدونيس في المجلة نفسها قصائده المطولة التي ذاعت شهرتها؛ مثل: «هذا هو اسمي»، و»مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف»، و»قبر من أجل نيويورك»، بما هي تعبيرٌ عن روح هذا الإبدال الجديد وتنظيرٌ لممارسته النصية داخل شروطها البنائية (التدوير، المزج بين الوزن والنثر، التناص..)، لاسيما بعد عثوره على كتاب «المواقف» للنفري سنة 1965، ومواكبته للإبدالات الأدبية والمعرفية في فرنسا، عدا انشغاله وقتئذ بأطروحة «الثابت والمتحول» ذائعة الصيت.
وفي البيانين اللاحقين: «بيان الكتابة» (1978) و»بيان الحداثة» (1980)، حرص أدونيس على تنظير الحداثة الشعرية وتوسيع حقل ممارساتها الدالة وتحصينها من الأوهام، إذا علمنا بأن مجلة «مواقف» التي تأسست في بيروت عام (1969)، بعد طلاقه مجلة «شعر»، كانت تُقدم نفسها، طوال حقبة السبعينيات ومطلع الثمانينيات، حاضنة لتجارب الكتابة الشعرية الجديدة التي تقوم خارج التراتبات والتقسيمات الأجناسية، على التنوع والحرية و»اللاشكل»، ولا يكون ذلك إلا بقدرة الدوال نفسها على التعبير عن ذلك لغة وإيقاعا وتخييلا، ضمن مسار إنتاج الدلالة؛ أي أن «نوعية المكتوب» لا تتحدد إلا من خلال «درجة حضوره الإبداعي». وفي هذا الأفق، كانت للمجلة أصداء قوية في المشهد الشعري العربي، وتأثير ذو اعتبار في نفوس الشعراء الجدد. ففي المغرب، مثلا، أصدر محمد بنيس «بيان الكتابة» (1980) وعبد الله راجع «الجنون المعقلن» (1981)؛ فكانا معا يسايران هذه الممارسات الكتابية، التي بدأت تفرض نفسها التجديدي على القصيدة باعتبارها شكلا مفتوحا وتشكيلا بصريا قابلا لاحتضان النصوص والأشكال والتعبير عنها بمنأى عن النمطية والتكرار، عدا استثمار بعض الخصوصيات الثقافية المحلية مثل الخط المغربي وعلاقته بالمكان، كما تحققت نصيا مع بعض شعراء السبعينيات في المغرب. وقد درس محمد الماكَري في كتابه «الشكل والخطاب» (1991) مثل هذه الممارسات من منظور ظاهراتي يقارب مسألة الاشتغال الفضائي، أي مجموع مظاهر «التفضية» في عرض النصوص الشعرية المكتوبة، أو تلك المعطيات الناتجة عن الهيئة الخطية أو الطباعية للنص، آخذا بعين الاعتبار بلاغة هذا الاشتغال من خلال التبئير والتشاكلات والاستعارات البصرية.
نحو العمل الشعري
ما يعنينا في هذه البيانات وفي غيرها، هو إجماعها على «انفتاح الشكل» الذي تُحققه الكتابة في أكثر من مستوى، لعل أهمها «عناق الشعر والنثر، أي حذف وإزالة تلك المسافة الفاصلة بين ما كان خاصا بالشعر، من مفردات وتعابير وصور، وما كان خاصا بالنثر» كما يقول صلاح بوسريف في كتابه «حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر» (2012)، الذي كرسه للدفاع عن مثل هذه الحداثة وهي تقطع مع مفهوم القصيدة في بعدها الشفاهي؛ فالصفحة، أو البياض باعتباره امتدادا، عمل على وعي الكتابة بشرطها الخطي، وبوضعها اليد والعين معا، في مواجهة هذا المصير الجديد الذي ظل مُلْغى ومُؤجلا، أو منسيا في الممارسات السابقة. لقد قاد مثل هذا القلب في بناء الممارسة الشعرية وتأويلها إلى تجاوز مفهوم البيت داخل بنيته الشفاهية، وإلى اختراق الحدود بين الأجناس الأدبية على نحو ساهم في تجذير النزوع الكتابي لهذه الممارسة، وصار فيه فضاء الكتابة محل عبور وبناء مفتوحا يتعدى فكرة الوحدة العضوية، إلى ما به تكون فسيفساء عملٍ مُركبٍ ومُتعدد البناء ضمن مشروع كتابٍ جامعٍ تتنافذ عبره ذواتٌ وخطاباتٌ وأزمنة متباعدة.
وفي خضم هذا النشاط الكتابي، بدأت تبرز مشاريع «العمل الشعري» في حقبة التسعينيات، تستفيد من الممارسات الدالة الجديدة، كما طُرِحت في النقاش النظري والسجال النقدي؛ وهذا العمل ليس مُؤلفا من قصائد، أو تنتظمه موضوعة ما، أو يصب في اتجاه معين ـ لأن من هذه النماذج ما نعثر عليها منذ بدايات التحديث الشعري ـ أكثر من أنه يحقق وظيفة العمل الشعري بمعناه الحديث الذي يجسد شرطه الكتابي بأبعاده المتنوعة، البوليفونية والخطية والبصرية، ويجري وَفْق غائيةٍ داخليةٍ مُفكرٍ فيها، عدا أنه في المقام الأول كتابٌ سيري- تخييلي في المقام الأول، يستلهم تجربة تاريخية جماعية، أو فردية تهم شخصية الشاعر وموقفه من الذات والمجتمع والحضارة، التي يحياها في عصره؛ ولعل أبرز نماذج هذا العمل في شعرنا المعاصر: «لماذا تركت الحصان وحيدا» لمحمود درويش، و»الكتاب: أمس، المكان، الآن» لأدونيس، و»كتاب الحب» لمحمد بنيس و»أخبار مجنون ليلى» لقاسم حداد. ويمكن أن نجد نظائر لهذا الكتاب عند شعراء آخرين، من أمثال: سليم بركات، وسيف الرحبي، وهاشم شفيق، وشربل داغر، وعبد المنعم رمضان، وأحمد الشهاوي، وأحمد بلحاج آية وارهام، وفتحي آدم، ومنصف الوهايبي، وصلاح بوسريف وغيرهم.
إن مثل هذه الأعمال الشعرية، أو النصوص المعاصرة المركبة، التي اصطلح عليها الناقد محمد مفتاح بـ»النصنصة»، كانت تستضيف أجناسا وفنونا ذات قرابة مشتركة، بقدر ما أخذت تخترق مواضعات الجنس الأدبي وتعيد ترتيب العلاقة بين الشعري والنثري، وبالتالي طرحت إشكاليةَ التجنيس بصورة أوضح من ذي قبل.
