
نبدأ بالسؤال التقليدي الذي لا بد منه، في بداية كل حوار : من هو عبد السلام الفيزازي؟
عبد السلام فزازي مغربي الموطن، ولد في منطقة الريف، شمال المغرب المطل على الضفة الأخرى- إسبانيا، من أم وأب ريفيين. تربيت مهاجرا بين موقعين استعماريين؛ موقع استعمرته فرنسا، وهو مهد المولد، وموقع استعمرته إسبانيا في شمال المغرب.. كان أبي فقيهاً منذ صغره، وسرعان ما دخل جيش التحرير ومن ثم المقاومة، وما لبث أن طرده المستعمر الفرنسي، فهاجر معية أسرته إلى منطقة الشمال؛ حيث حكم الإسبان. وبعد الاستقلال رجعت العائلة إلى مسقط رأسها، وكان من ضريبة هذا الإبعاد أنني وأخي الصغير حرمنا من التحدث بالعربية؛ إذ كنا نتكلم اللغة الريفية، ولا نعرف اللغة العربية، وهي ضريبة جعلت منا ومن الأسرة التي كانت وفية لحالة اجتماعية معروفة، تتمثل في أن الطفل الأول من الأسرة عليه أن يقتفي آثار الآباء والأجداد فيحفظ القرآن الكريم؛ وبالفعل حفظت من القرآن 51 حزبا، بشكل يكاد يكون ببغاويا، أما أخي فكان معفىً من ذلك، وحفظ 6 أحزاب فقط.. وبما أن أبي كان جنديا صاحبته أمي وجدتي وأخي الصغير في رحلته المتنقلة في أرجاء المغرب، بينما تركني أبي في قرية أكنول، وبالتحديد قرية “بوحدود”؛ لأختم القرآن، إلا أنني سرعان ما صاحبت ابن عمتي إلى القرية الكبيرة، حيث كان معلما، ورأى أن وجودي في “الجامع” معصية لا توصف، لا سيما أنه كان يعرف شغفي بالدراسة النظامية.. كانت تجربة فيها مغامرة لكن تقبلها أبي بشرط أن أختم القرآن على يده؛ فكان له ما أراد.. وهذه التجربة علمتني أن أعيش الهجرة باكرا وأحرم من حميمية الأسرة؛ وهو ما جعل شخصيتي تبدو صعبة بقدر ما هي قمة الحنان والشعور بالآخر، لا سيما المعذبين في الأرض.. وعلى هذه الشاكلة نمَت سيكولوجيتي منسجمة مع عقلي ومنهجية تفكيري، والحمد لله..

كيف أثرت حياة القرية على الأستاذ الفيزازي؟ وهل كانت لعلاقتك بالريف المغربي -حيث نشأت- أثرا على وعيك وثقافتك وكتاباتك؟ وكيف كان ذلك؟
أثرت حياة القرية في شخصيتي بشكل لا يوصف إذ جعلتني أعيش -عبر الذاكرة الموشومة- الطفولة طفولتين، “الطفولة/ الطفولة”، و”الطفولة، وأنا في هذا العمر الذي صرته”، ابن الطبيعة.. المدينة مجرد دخيل لم يستأذن في دخول حياتي، أو بطريقة أخرى الدراسة والعمل هما من جعلاني أقبل الحياتين في واحدة.. والقرية أو ما نسميه “البادية” تعلم الإنسان كيف يعيش على الفطرة؛ قانعا بالموجود، إنسانا لا يقبل الظلم والغرور وحب الذات ما دامت الطبيعة أنا وأنا الطبيعة، أفكر خلالها كما تفكر خلالي.. والريف قبلة لا أرضى بقبلة أخرى تحل محلها؛ وإلا فكيف لي أن أعيش بعيدا عن السماء الأولى، وأنا الأرض كما يقال، وأقصد بالأرض هنا حيث ولدت وفتحت عيني؛ هذا ما كان يقودني دوما أثناء العطل إلى ترك المدينة والعودة إلى مسقط رأسي لأمارس الحياة بلا مركّب نقص، طالما يعيشه أقراني ويغبطونني، والعودة هذه هي التي جعلت جل كتابتي تبحر في تفاصيل الطبيعة، وكثيرا ما كان أصدقائي ينعتونني بـ” حي بن يقظان”، وكنت أسعد بهذا النعت؛ والعودة عندي كانت عودة لغتي الأم التي أرتاح إليها إلى درجة لا توازيها إلا اللغة العربية التي عشقتها حدّ الجنون؛ وكان للأدب المشرقي الأثر الكبير الذي أنساني اللغة العامية، التي لا أتقنها إلى حد الآن؛ لأهرب إلى اللغة الريفية أو العربية أو الإسبانية التي تعتبر عندي تقريبا اللغة الأم الثانية بحكم منطقتنا التي استعمرها الأسبان، فكل كتاباتي كانت استجابة شرطية لواقع شببت فيه عن الطوق.. ولعل البادية تعلم الإنسان ما لا يمكن لأهل المدينة تعلمه، فكانت ثقافتي مخضرمة بامتياز؛ يغبطني فيها باقي زملائي في الجامعة..
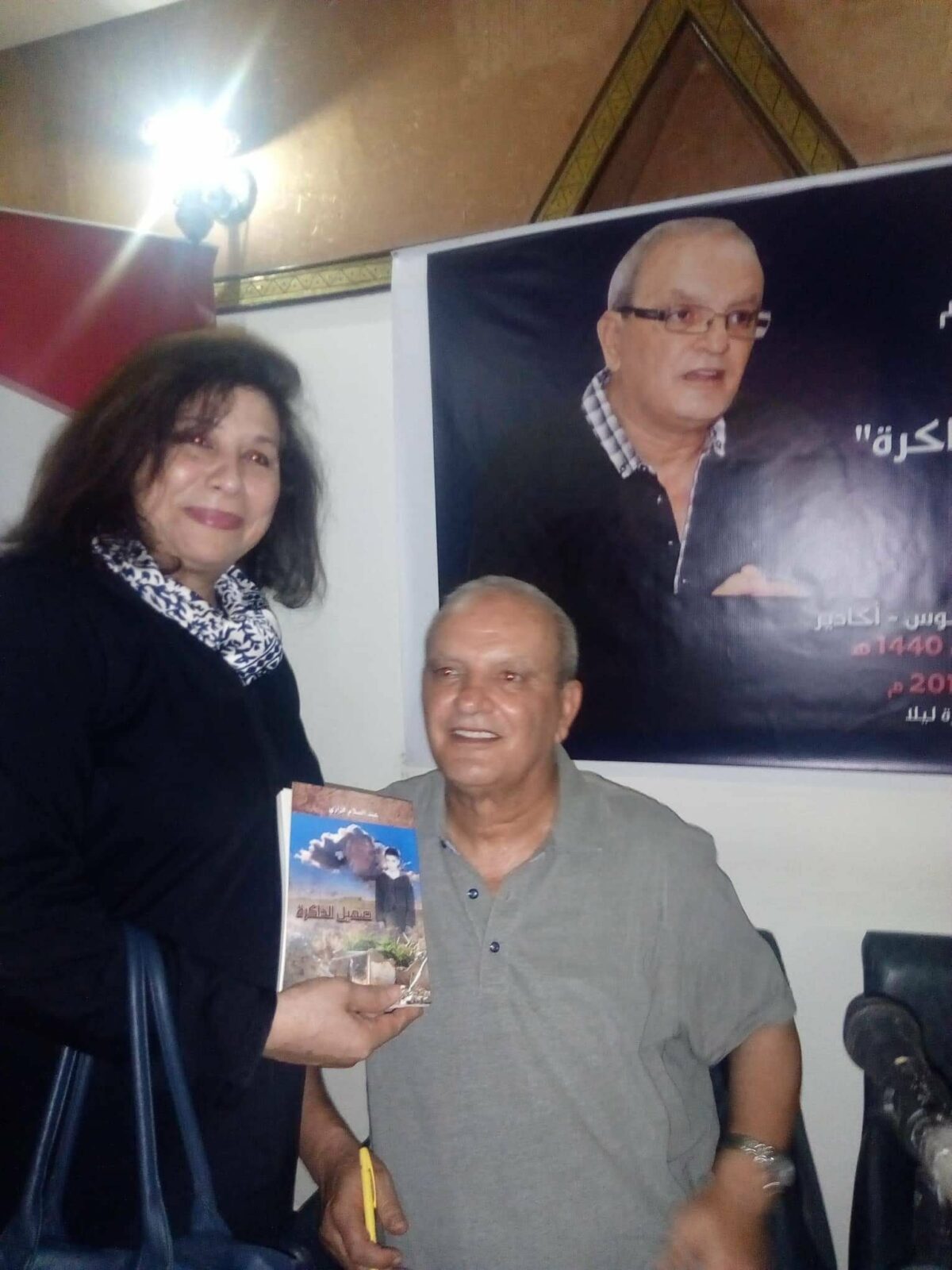
حدثنا عن رحلتك الدراسية بعد أن أنهيت الثانوية العامة حتى الحصول على الأستاذية.
رحلتي الدراسية ذاتها غريبة وعجيبة فالابتدائي كان كله في الريف، وكذلك الإعدادي.. عدت إلى أسرتي حيث شممت عطرها، ولم أشبع منها مثلما شبع باقي إخوتي.. وكان الجميع ينظر إلي شزرا، لأنني كنت متفوقا حدّ الحسد، كيف لا وأنا في المدرسة نهارا، ومع أبي الفقيه الحاج إدريس ليلا، يراقب دراستي، ويلح على استظهار آيات من القرآن، وكنت أقرأ معه حزب صلاة المغرب وكذا الفجر، حيث كان يسعد لهذا ويجعلني مفخرة للأسرة، لا سيما حين يكون مع أصدقائه الفقهاء الذين كنت أكرههم لمناقشتهم البسيطة..
ومن الإعدادي انتقلت إلى الثانوي في مدينة مكناس بعيدا عن أسرتي ثانية وكنت محظوظا لأن الثانوية فيها قسم داخلي تضمن لي المأكل والمشرب، والنوم بالمجان. هنا بدأت رحلة ثانية من التحصيل حيث كانت المنافسة على أشدها بين التلاميذ، وكان من يدرسوننا يحضّرون دروسهم جيدا وإلا فالويل لهم مع تلاميذ يحضرون الدروس مسبقا، ويبحثون للأساتذة عن العثرات.. كنت الرائد بلا منازع. وبعد الحصول على شهادة البكالوريا انتقلنا من مدينة مكناس إلى مدينة فاس مدينة العلم كما تسمى في العالم العربي، فكنت أعيش بين حيص بيص في التوجيه واختيار الشعبة التي أريد، وفي الأخير اسقر الاختيار على شعبة اللغة العربية وآدابها، وكنت محظوظا أيضا لأن جل الرواد من الأساتذة المغاربة، وكذا المشارقة درّسوني، وهم الذين كنت اتمنى بعد قراءة كتبهم أن أتعرف إليهم؛ وها هم نفسهم أصبحوا أستاذتي والحمد لله.. وقد كانت حيرتي تكبر وتكبر كلما لزمنا التخصص.. وتوجيهي نحو الأدب الحديث ما دمت كنت ممن عشقوا القديم، وحفظت المعلقات بتوجيه من الأستاذ الدكتور عبد الله الطيب -رحمه الله- من السودان، والنحوي فخر الدين قباوي؛ وقد أجمع أستاذتي على التخصص في الأدب الحديث، وجلهم كانوا شعراء، وهم من شجعوني على كتابة الشعر، وكنت انشر باسم مستعار خوفا من النقد إلى أن شجعوني على النشر باسمي الحقيقي..
نلت الإجازة (الليسانس) بتفوق، كما اجتزت مباشرة امتحان الماجستير، وكنت فيه متفوقا كما العادة. وفي الأدب الحديث كنت أتقن اللغات وإلا فلم أكن لأقبل في الماجستير، سيما أن الأدب الحديث يعتمد على المصادر والمراجع الغربية وكل ما يستجد في النقد من مناهج حديثة.. وبعد حصولي على الماجستير سجلت أطروحتي تحت إشراف الدكتور محمد السرغيني أطال الله عمره، وقد تتعجبون إذا قلت لكم أنه درس مع السياب..
لكن مع الأسف الشديد اعترضتني مشاكل مع الدكتور، وندم عما اقترفه في حقي بعد أن غادرت إلى أسبانيا، وسجلت الدكتوراه في مدريد، إلا أنه قيل لي أن المعادلة بين الشواهد غير متكافئة؛ ثم رحلت إلى فرنسا، وبالضبط مدينة ليون الفرنسية، وحضرت رسالة الدكتوره هذه المرة في موضوع: “الموقف من خلال الشعر في الأعمال الكاملة للشاعر العراقي سعدي يوسف”.
La prise de position dans la poésie de saidi youssef à travers ses œuvres integrals

ما المعوقات والإكراهات التي اعترضتك في مسيرتك المهنية؟
المعوقات: وتتميما لسؤالك حول المعوقات والاكراهات التي تعرضت لها في مسيرتي المهنية، لم أعطيها اهتماما؛ لأنها تكاد تتشابه بين الجميع واختص بالذكر التعليم العالي؛ وما دام الشيء بالشيء يذكر، أسترجع معك تواجدي في الشعبة مع تخصصين أو قل عقليتين؛ واحدة تؤمن بأن الأدب هو الأدب القديم وما عداه يعد دخيلا يجب محاربته، وعقلية تدّعي أن القديم يجب أن يدرس في تاريخ الفكر، ولا يفيد الطالب الذي ينتظره سوق الشغل، ولن يطلب منه مثلا الشعر الجاهلي؛ الاسلامي الأموي…. فكنت دائما أحمد الله لأنني أحمل الاثنين في جعبتي ولا أتصور حديثا بلا قديم، ولا قديما دون استشراف لأفق انتظار لا مفر منه؛ فكان علي في الشعبة أن أمسك العصا من الوسط، ومن هذا الموقف اكتشفت أن الثقافة الأحادية تُعدّ جهالة مقنعة، ولعل زماننا هذا هو زمن الانخراط والذوبان في الآداب العالمية.. وأعترف أن هذا حفزني أكثر للاشتغال على النصوص كائنة ما كانت، وأعانق فكرة جبرا إبراهيم في الجاحظ، حيث كتب عنه:” الجاحظ الحداثي الأول”، وهذا ما قادني إلى تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبدأتها منذ سنة 1986 حيث قدمت خدمة كبيرة للغة العربية ومدى انفتاحها على العالم، وهنا بالضبط احترمني القدماء وكذا الحداثيون؛ فكنت بذلك عقلانيا بعيدا عن النظرية الضيقة في تعلم وتعليم اللغات. عدا هذا اعترضتنا في ذات الوقت معضلة تدريس الترجمة حيث اعتبرها بعضهم دخيلة وبعضهم اعتبرها مادة يجب أن تدرس؛ فكانت النتيجة أن خصصنا درجة ماجستير في الترجمة، لتصبح مجالا مهما، وحقلا للدكتوراه.. كما أدخلنا مناهج غربية تستجيب لها خصوصيات لغتنا العربية..
كيف تنظر للعلاقة بين الطالب وأستاذه في مرحلة الدراسة، وبعد التخرج؟
العلاقة بين الاستاذ وطلبته علاقة وثيقة تشبه علاقة الأب بابنه أولا، وثانيا علاقة أمانة علمية تتوارث تواتريا، وهناك ما جبلنا عليه في أجيالنا؛ حيث الطالب كان ينادي أستاذه بالشيخ ، ولهذا المصطلح بعد صوفي فيه الوقار والتقدير؛ ولا زلنا نحتفظ بهذا النداء، كما أن بعض طلبتنا في الدكتوراه، وهم تقريبا من جيلنا، يحافظون على هذا التقليد، بل إن بعضهم لا يصافحك، بل يقبل رأسك تقديرا وإجلالا. أما اليوم فقد تغيرت بعض هذه الأخلاقيات، وأصبح الطالب شبه صديق، يقترب من سمة البنوة؛ ونفتح له المجال باللقاءات الخارجة عن الكلية، نظرا لاعتبارات خاصة؛ وهذا ما تعلمناه في الغرب مع احترام خصوصياتنا؛ إلا أن المؤلم حقا أن طلبة اليوم ضاعت منهم أشياء كثيرة بحكم العولمة، فجلهم أصبحوا مجرد ناسخين لا يقرؤون المكتوب؛ فضاع الجيل الورقي كما كنا نسمي أنفسنا، ليحضر جيل يختص في النسخ واللصق، ولا تراه فيما كتب إلا لماما.. وهنا بدأنا نبكي العلم ومن خسروه؛ فقد ضاع منهم المجداف والملاح؛ وضقنا بهم إلى حد الغثيان.. أجل التكنولوجيا جميلة لكن شريطة أن تعود بالنفع على الإنسان. أما آن تصبح عبارة عن سلاح ذي حدين؛ فهذه مقامرة جعلتنا نبكي العلم ونصيح مع النائحين، وكأننا في مأتم.. هذا الجيل يملك كل شيء ولا يملك في الحقيقة شيئا.. ومع ذلك علينا أن نرمم ما يمكن ترميمه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا..
ما هي الكتب التي قمت بتأليفها؟ وما أهم كتاب فيها؟ ولماذا اخترته؟
أما ما يتعلق بالكتب فألفت في عدة أجناس أدبية بالعربية والفرنسية والإسبانية: شعر، نقد الشعر، الرواية، الترجمة، الأدب المقارن؛ الديلاكتيك، ونقد النقد.. إيمانا مني أن الباحث يجب أن لا يكون محليا، ولا حتى عربيا بل وجهته يجب أن تتولى الكونية، سيما في زمن العولمة، والباحث الذي تسيجه التخصصات الكاذبة ربما سيبقى أبدا -كما يقول الشابي- بين الحفر.. ونسيت أنني بصدد الكتابة عن الأديان السماوية على اعتبار أن الأديان يجب أن توحد، لا أن تفرق، وتبتعد قليلا عن السياسة؛ وفيما يتعلق بعلم الإسلام islamologie -وما دمنا قد نهلنا من الثقافة الكونية- فجدير بنا أن نجعل منهه جسرا نحو إنسانية الإنسان، لا أن نجعل منها جسرا نحو القتل والتقتيل والتنكيل..
أما ما هي أفضل كتبي؛ فالجميع يعلم أن لو خير الإنسان بين أولاده لما استطاع بل من المستحيل أن يفضل أحدهم عن الآخر.. لكل كتاب أجله كما له أسباب نزوله ولعله سؤال لا يمكن للمؤلف أن يجيب عنه بقدر ما يمكن أن يمجد كل مؤلف في إطاره الزمني والتاريخي، ولهذا فضل بعضهم أن يعيد نشر مؤلفاته تحت عنوان:” الأعمال الكاملة”، وهي فكرة ذكية ماكرة؛ ويبقى في آخر المطاف الحكم للمتلقي عامة والمتبقي الناقد خاصة. فلتغفر لي مؤلفاتي أولا وأخيرا.. إنها على لسان أستاذتنا خناقة بنونة: “وضعت بين النار والاختيار”..
ما رأيك في حركة النقد العربية الراهنة؟
إن حركة النقد العربية الراهنة تختلف من دولة إلى أخرى على المستوى العربي طبعا، نظرا لطبيعة الدول التي تختلف بدورها في عمل قبول أو رفض روافد النقد التي تأتيني من الغرب والتي تعتبرها بعض الدول مجرد إعجاب واستلاب يأتينا من بعض المكلفين والباحثين العرب الذين درسوا في الغرب، بينما هناك ثلة من الباحثين يرفضون التقدم السلحفاتي من باحثين ينقحون ويشذبون ويهذبون ما سبق أن كتب من القديم ضدا على عملية التثاقف بين التيارات النقدية هنا وهناك؛ وللأمانة فإن هذا الغرب الذي نمقته في كل شيء، أمدنا بمناهج جديدة، ترجمناها إلى العربية، وحاولنا جعلها تنسجم مع خصوصيات أدبنا العربي، وهذا ليس عيبا، فالغرب نفسه أخذ منا الكثير، ولا يشعر بعقدة الذنب. ولا يمكن لنا في هذا الحوار القصير أن نقف عند أمثلة دالة على ما نقول.. فالثقافة لا حدود لها ولا دين ولا ملة؛ فهي -شئنا أم أبينا- إنسانية بلا حدود، ولا مجال لمأسستها سياسيا أو نسبها لملة أو نحلة، فالحركة النقدية تتجدد بتجدد الإنسان وانفتاحه على العالم، بل يستجيب للفعل التكنولوجي الذي عبره تصلنا مسارات هذه الحركات النقدية، وما علينا إلا محاولة تذويبها في متن الأجناس العربية كائنة من كانت؛ فكل ما ينسجم ويذوب في خصوصية لغتنا نقبله وما لا يستجيب نطرده جانبا؛ وهكذا كنا أخي محمود وفي لقا مدينة الجديدة قد أسسنا لبعد نقدي غير مسبوق “حركة البناء والتأصيل”، ونحن ثلة من النقاد الكبار، لكن مع الظروف المتعلقة بكل واحد منا؛ تركنا الحبل على الغارب؛ ترانا هل يمكن أن نتمم مشروعنا القديم – الجديد؟ أسئلة أتركها الآن، لكن لأننا من المؤسسين لهذه اللحظة النقدية، لو استمر الحوار حولها؛ لأصبحت غير مسبوقة.. والنقد عموما تابع لهموم النقاد أنفسهم فمتى تطوروا وطوروا أفكارهم؛ تطور نقدهم. وإلا فالمصيبة ما نعيشه اليوم؛ هناك جبال من النصوص التي تسمي نفسها شعرا، وما هي بشعر نظرا لغياب الموجه الحقيقي، أقصد النقد.. ولقد عشنا معارك في هذا الاتجاه إلى حد العداوة من قبل المتشاعرين..
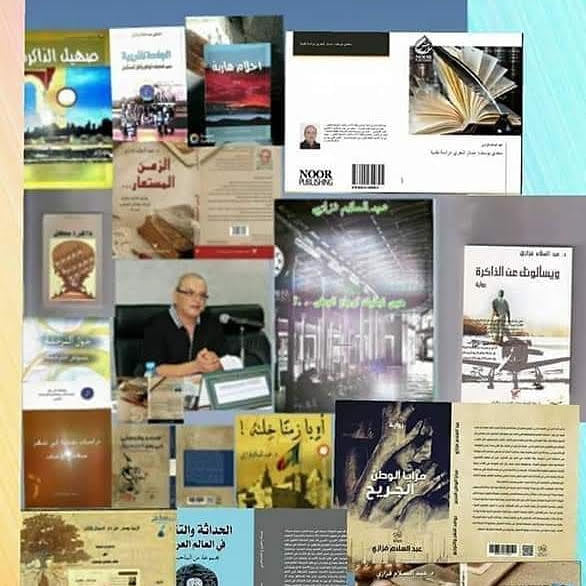
لماذا -في رأيكم- قل الاهتمام بنقد القصيدة، لصالح الرواية؟
سؤال وجيه أستاذنا الجليل، تعلم جيدا أن الشعر أصعب الأجناس الأدبية، فلا أحد يجرؤ على كتابة الشعر، كما قيل في النقد القديم؛ إذ يستحيل كتابته إلا بعد إمكانية حفظ1000 بيت من الشعر، ومع ذلك كلما اقتربت من واد عبقر؛ كلما أزداد خوفك. ويجب عليك خلع نعليك بواد عبقر هذا.. فكيف الكتابة وأنت في حل من البلاغة قديمها وحديثها، وفي حل من العروض مرورا بالإيقاعات الشعرية الحديثة ناهيك من تمكن اللغة وجعلها مطواعة..
ففي كثير من الأحيان أجدني أمام مقالات بعض الكتب التي تتناول جنس الرواية وتكتب بدون خجل: “العصر عصر الرواية ضد الشعر، وفي ذات الوقت يسمح بعض النقاد بكتابة عناوين عريضة مثل: “شعرية الرواية؛ بلاغة الرواية إلخ.. “أو ليست هذه مصطلحات شعرية؟ فمن أعطى الحرية للنقاد بتوظيف هذه المصطلحات من دون استشارة الشعر؟ حيث يبقى السرد سردا والشعر شعرا؛ ومن حاول التطاول على الرواية واخذ منها مصطلحات خاصة بها سيكون قد أجرم في زاوية، وإلى حد الآن حصل العكس. والجميع يعلم أن جنس الشعر هو جنس عربي بامتياز، ألم يسموه “ديوان العرب”: فهذه هوية لا يمكن خدشها بل لا يمكن الاقتراب منها.. وحين نقارن النقد الشعري بالنقد الروائي أو السردي عموما فمن الطبيعي جدا ترجيح كفة الرواية عن الشعر في مجال النقد. فقلة المتقنون لتقنيات النقد الشعري، أظنه العلة في قلة الاهتمام بنقد الشعر، بينما نقد الرواية يبدو من السهل اليسير. وهذا راجع لطبيعة جنس الرواية..
ما تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الإبداع؟
لا يختلف اثنان على أن وسائل التواصل الاجتماعي برمتها أثرت سلبا على الإبداع، فبينما عشنا مع النشر الورقي وفي الملاحق الثقافية خصوصا، كانت نصوصنا تخضع للمراقبة؛ فقد كان لكل ملحق ثقافي لجان من المختصين، لا تمرر الخربشات على حساب الشعر؛ مما كان يجعل المبدع يرجع إلى من يشذب ويهذب وينقح نصوصه، ومن ثم ومع مرور الأيام يدرك أن لا سبيل للنشر إلا إذا تحقق الفهم والإفهام -على حد قول الجاحظ- وإتقان معايير الشعر من بلاغة وإيقاع ولغة.. أما ما نعيشه اليوم فتبكيه البواكي، إذ الأمر أصبح مشرعا على التفاهة، والنشر أصبح متاحا ولا أحد يراقب النصوص؛ فظهر المتشاعرون وغاب النقد الموجه البناء، وبدأنا نعيش في زمن اللاشعر واللاكتابة، وفي ذات الوقت غاب أو تم تغييب الشعر الحقيقي، بينما ظهرت الخواطر الهشة؛ لتصبح في نظر أصحابها شعرا؛ فبمجرد كتابة خربشات عارية من الشعر ينقر أصحابها على الأزرار لتصبح بقدرة قادر “شعرا”، ومع كل هذا حاول ما تبقى من النقاد والغيورين على الشعر التصدي لظاهرة التسيب، إلا أن الرداءة ظلت تواجههم، فانتبذوا مكانا قصيا وهم يرثون الشعر في زمن القبح المطلق..
وجدير بالذكر هنا أننا لسنا ضد وسائل التواصل الاجتماعي التي لو استثمرت بحكمة وتبصر؛ لكانت إضافة جديدة يستفيد منها المبدع في الأجناس الأدبية عامة، والشعر خاصة. لكننا نلاحظ العكس للأسف.
ما رأيك بمدعي الشعر والنقد والكتابة بعامة الذين يتناسخون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويملؤون الدنيا ضجيجا؟
ليس من السهل أن تكون شاعرا، بينما يمكن لك أن تكتب غير الشعر بسهولة مقارنة مع كتابة الشعر؛ وهكذا لم يكن النقد القديم يغالي حين ألحّ على من يرغبون بكتابة الشعر حين جعل أمامهم خيارات لا بد منها إلى جانب الموهبة التي لا يهبها الله إلا لقلة من عباده؛ فقد اشترط بعض القدماء على المبدع أن يحفظ 1000 بيت من الشعر يعني أن تكون الموهبة مصاحبة للحفظ، وهو ما يؤهله إلى كتابة الشعر، ثم بطريقة أو بأخرى يصبح الشاعر فيضا منه، حيي يذوب في الشعر، ويذوب فيه ويصبحا معا ذاتا واحدة -على حد قول الصوفية في نظرية الحلول-
والناقد بدوره يجب أن يكون أقرب من هذا العالم المركب تركيبا مزجيا على حد قول النحاة، ويجدر القول بأن النقاد حالات؛ فهناك الناقد الآلي، والناقد الانطباعي الذي يستخدم قليلا من الآليات النقدية، ويبدأ في تحليل الشكل وصولا إلى المحتوى؛ وهذا يحيلنا إلى النقد الشعري القديم ومتطلباته، أما الناقد المبدع فهذا ما يجعلك تسافر معه داخل الذات المبدعة، تعيش معه عملية تشريح للقصيدة حيث تصبح عنده الذات الكاتبة لا تبتعد عن الذات المنكتبة والجامع بينهما التوغل في الماديات فيكون كما يقول جيرارد جينيت: “على الناقد أن يتقن أسباب النقد الخالص- les raison de la critique pure”.. بينما لا نجد نقدا محايدا إلا لماما، فقد بات من المخجل أن نتكلم عن النقد سيما المحايد والمحايث؛ فجل ما يكتب من ” نقد” لا يعدو أن يكون مجرد قراءات لا تصل إلى القراءة العاشقة؛ والشاهد عندنا أن من لا يتقن قراءة النقد في مدارسه اللسانية: المدرسة التركيبية- المدرسة الوظيفية- المدرسة التوزيعية- والمدرسة الغلوسيماتية؛ عبورا إلى المدرسة التفكيكية؛ ناهيك عن المدرسة التناغمية.. في غياب هذا ولد التسيب المطلق في ماهية أصعب جنس أدبي “الشعر”.. وهكذا كان ميلاد التفاهة والسطحية والعشق واللاعشق..إلخ..
كونك من المواكبين والمشاركين في كثير من أنشطة شعراء بلا حدود، كيف تنظر لمسيرة هذا الكيان؟ وهو يحاول إعادة نشاطه، وبمشروع الصحيفة الإلكترونية ” نوارس- شعراء بلا حدود”؟
شعراء بلا حدود مدرسة قائمة الذات والحال.. إنني كنت ولا زلت مواكبا لها بل مشاركا في كثير من أنشطتها، لا سيما لقاء مدينة الجديدة المغربية الذي كان له بصمة وترك فيها براعم أبت إلا أن تبدأ كتابة الشعر منذ أن تركت فيهم شعراء بلا حدود الأثر الكبير؛ ولقد كرمت شعراء بلا حدود الكثير من الشعراء من بقاع العالم العربي؛ وكان عالم “نوارس” مختلفا دائما ببعده ورفضه للمحاباة والنقد الإخواني، بينما نجد تفاصيل هجينة اليوم في منابر عديدة تنبت مثل الفطريات؛ ولا يهمها أن تحقق الجودة في الشعر ونقده، ولعل ما حضرته من لقاءات على قلتها رأيت كيف تلح هذه المدرسة الشعرية لشعراء بلا حدود على جمالية القراءة، ودوزنة الشعر، وعدم السقوط في النثرية المفرطة؛ وسطحية الكتابة، والسقوط في المنبرية التي غالبا ما لا يتحقق فيها من معايير الشعر شيء للأسف.
ويكفي شعراء بلا حدود فخرا ما أنجزته من مشروع نقدي عربي غير مسبوق، وأعني (حركة البناء والتأصيل)، وابتكار عالم نقدي يصاحب جوهر “شعراء بلا حدود”، حتى لكأنني شعرت بأننا كنا معا نريد بعث ما كتبته مدرسة الديوان، ومدرسة ميخائيل نعيمة، وأبولو ومجلة شعر ليوسف الخال، وصولا إلى ما رسخته صاحبة قصيدة النثر Bernad Souzane” De baudelair jusqu’à nos jours..من بودلير إلى أيامنا هذه… التي أخذ عنها أدونيس الكثير في قصيدة النثر.. ولعل الشكر لا يمكن كتمانه ونحن نعرف -أبوح بها مفردا بصيغة الجمع- أن “شعراء بلا حدود” تعد رائدة من رواد الحداثة الشعرية في القرن الواحد والعشرين..
