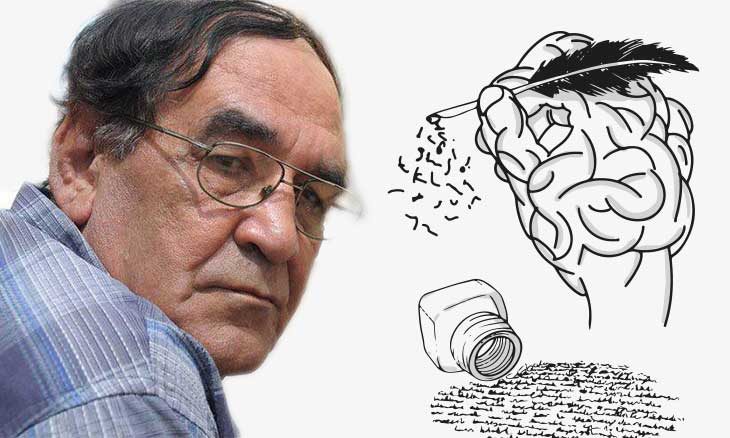
لا شكَّ في أن الحديث عن الشاعر صلاح فائق يتطلبُ عُدّة نقدية استثنائية، ومعرفة تاريخية تخصّ التعرّف على تجربته، في سياق قراءة تحولات الشعرية العراقية، في أسئلة تجريبها، وفي سياق خصوصية تجربة «شعراء كركوك» بوصفها مغامرة شعرية، لها زمنها، وظروفها، وإنجازها، وهذا ما يجعل الحديث عن تجربة صلاح فائق حديثا عن التحوّل والتجاوز في المجال الشعري- تجربة الستينيات، وتجربة كركوك – بوصفها أنموذجا جريئا في التعاطي مع «حرية الكتابة الشعرية»، ومع ممارستها الواعية والقصدية، بوصفها مغامرة في تأصيل مفهوم «القطيعة الشعرية» ليس بدلالتها كنظير لـ»القطيعة المعرفية» بتوصيف باشلار، بل بفاعليتها في ممارسة فعل التجدد والتجاوز، وفي إغناء مساحات التجريب الشعري، ووضع القصيدة إزاء العالم، مُباحة، مكشوفة، متمردة، لكنها تملك جدّة النظر إلى الحياة، لكي تسوّغ خروجها الصاخب من معطف التاريخ.. شاعرٌ مثل صلاح فائق يفتح أفقا لا حدود فيه لهذه الكتابة، فهو يدرك صعوبتها وخطورتها، مثلما يعي حساسية تسويغها لمفهوم القطيعة، مع مركزية مفاهيم ضاغطة وقارّة مثل التاريخ والفحولة والريادة و»الشعر الحر» ومع استيهامات أعطت للشعر- بوصفه تاريخا للأمة- ما يُعطى للمقدّس، ولمهيمنات تاريخ الفروسية والحماسة وغيرها، فكان خروج الشاعر عن «جمعية الشعراء الموتى» إلى عالم يضجّ بحياة أخرى، وبأسئلة أخرى..
يتركنا صلاح فائق عند لغة غاوية، لا إقفال لها، سائلة، غامرة، تنزع فيها الاستعارات إلى التخلّص من أحمالها، لتبدو جزءا من تفاصيل اليومي والحياتي، حتى تبدو تلك اللغة وكأنها في نوبة من النزيف الدائم، والشاعر في شغف هوسٍ صاخب، وما بين الاثنين تتخلّص القصيدة من قشرتها، أو من قميصها لتعيش لذة الغواية أو الخيانة أو التعرّي، وهي رهانات تنحاز إلى فكرة الحياة وليس إلى الموت، لأن الكتابة اليومية هي دفاع عن تلك الحياة، والانحياز لشرطها الوجودي، بعيدا عن صورة الشاعر المتأمل، الغاطس في التاريخ والأيديولوجيا والزمن.
يعترف صلاح فائق بأن الكتابة خيارٌ شعري لحياة ضدية، ورهان على صناعة فائقة التجاوز، يكون فيها الشعر وجودا تمثيليا متعاليا لهذا الخيار، ولذلك الرهان، وبقدر ما تحمل هذه الثنائية من شراهة، ومن اندفاع إلى التلذذ والتشهي بفكرة الأفق المفتوح، فإن اللغة في خيارها تبقى مسكونة بحدوس الآخر، إذ يكون الحدس رهانا مُحرّضا على التجدد، والتجاوز والتعالي، ما يجعلها تحفل باليومي، ليس بوصفه العابر، بل بالإنساني والرؤيوي، حيث تحفل القصيدة باللعبة اللغوية، عبر استعارات ماكرة ومخادعة، وعبر مفارقات تجعل من الصورة الشعرية/ الجملة الشعرية أكثر إثارة، وأكثر إغواء للقراءة..
يكتب صلاح فائق هذه القصيدة، بوصفها قصيدة رهانه على شعرية اليومي، إذ يجعلها أكثر احتفاء بطقوسه، وهو يرى العالم الذي يخصّه، متحولا، هائجا، مرئيا داخل اللغة التي تمثل مكوثه، حادسا بكشوفاته، ملتّذا باغوائه، فينزع عنها معطف بلاغتها، يتركها عند عريٍّ سحري، أو عند سعادة من يتشهى قراءاتها، فالقصيدة هنا تبدو وكأنها جسدٌ في نوبة لذة، أو في لحظة تحوّل عابر للطبيعة، فهي تشبه نهرا في الفلبين، أو امرأة في حانة، أو عارضة أزياء في ليل لندن.
سعيدٌ لأني لم أتعلمْ بلاغة موتى
وجدتُ التجوال في السواحلِ أجمل
هناكَ، ذات مرة، في أحدها
صادفتُ فلاحاً، خرجَ من قصيدة لي قبل أيام
ليبحثَ عن شجرة زيتونٍ أخفى عندها بعض النقود
كان الوقتُ ظهيرةً والمطرُ في كل مكان…
صلاح فائق وقصيدة القطيعة
قد يبدو الانخراط في جماعة مثل جماعة «كركوك» نوعا من الورطة، وبقدر ما تبدو شعرية اللحظة التي صنعتها تلك الجماعة فارقة، ومثيرة للجدل، في أهميتها، وفي تنوّع مصادرها، إلا أنها وقعت مع الزمن في نسيان فادح، وربما تحولت إلى قيد قاسٍ، وإلى تاريخ يفرض شروطه على التقبّل والمراجعة والنقد، وصلاح فائق الشاعر المهووس بالمغايرة كان يعيش معاناة حريته في مرحلة ما بعد الجماعة، لذا اندفعت قصيدته الجديدة إلى ما يشبه شعرنة القطيعة، حيث الانجرار إلى كتابة قصيدته الرائية/ القصيدة الشخصية، بوصفها نظيرا لكتابة التاريخ الشخصي، الكاشف عن فرادته، وعن شغفه بكتابة قصيدة يحدس بها، يتلمس عبرها وجوده المتخيّل في عالم مختلف، حيث تمثل عالمه عبر أمكنة الطبيعة والمدن، وحيث رؤيته القلقة التي تجعله أكثر صحوا، وأكثر تشهيا لعالمه الشعري، فيعيش مع القصيدة لذتها، بهجتها، إشراقها، يعترف من خلالها بقطيعته، وتمرده، وصخبه الداخلي، خروجه من زمن «الرهائن» الصادرة عام 1975 إلى ارتهان العالم عند الطبيعة، وعند اللغة، حيث الاقتراب الحر من الوجود، وحيث التلذذ بمراجعة تاريخه النفسي والحزبي والوجودي، لكي يُحرر ذاته من اسئلتها القديمة، ومن زمنها العالق بالوثيقة والسيرة..
قصيدة «الخفّة» التي يكتبها صلاح فائق تنحاز إلى الحرية، وإلى ما يجعله مبهورا بها، وبما تستدعيه من «قاموس» تنحلّ فيه الاستعارات من تاريخها، لتصنع لها نسقا آخر، مكشوفا على اليومي، وعلى التفاصيل التي تتحول فيها «المفردات» إلى شذرات تنبض بالحياة، وبكلّ ما يجعل منها مكشوفة على الطبيعة الشخصية، وعلى التحوّل الحادث في تشكلات اللغة، إذ تكون الكتابة في هذا التشكل نظيرا لحريته في ممارسة طقسه اليومي، باحثا فيه عن الغائب، متحسسا الجسد هو يرى العالم عبر ما تصنعه اللغة من سوانح لا حدود لها..
ليس في الذي أقوله أي مجاز
تورية أو استعارة
كل ما هنالك أنني أتحسس حقيبتي اليدوية
أعثر فيها على حبوب ضد الصداع
وألحظ منازل تنظر إليَّ بصمت
فأشعر أنها تعاني حشرجة أخيرة
في عديد مجموعاته الشعرية، وفي قصائده اليومية التي ينشرها في مدونته الشخصية يكشف صلاح فائق عن شغفه باليومي، وبما تهبه القصيدة من تعويض، ومن شغف يجعله أكثر هوسا بالمغايرة، وبما تصنعه تلك القصيدة الجديدة وهي تستكنه بهجة الإشهار والحرية، فتبدو وكأنها خطابه الشخصي إلى العالم، أو هي رؤيته وحريته، وجرأته فيما يكتب عبرها تاريخه الشخصي شعرا، إذ ينحاز إلى ما يشبه «الكتابة المفتوحة» التي يتوهج فيها النثر عبر ما ينغمر فيه من تشكّلات وأبنية وتصاوير يدرك ضرورتها الشاعر، ليس لتبرير قصيدته الشخصية في تمثيلها النثري فحسب، بل بكتابة الشعر الذي لا يمكن أن يكون إلّا شعرا…
الشاعر بين النثري واليومي
أحسب أن ما أقرأه في شعرية فائق اليومية يكشف لي عن قصيدة لا تشبه سوى نفسها، حيث تساكن الذات في حميميتها، في حسيتها، في تمردها وصخبها وفي أسئلتها، ربما تدعو إلى الوقوف الشهواني أمام المرآة، أو الجلوس عند طاولةِ موعدٍ عشق، أو الخروج إلى الطبيعة المبللة بتقلباتها العاصفة، فالشاعر يصنع عالمه، تفاصيله عبر هذه القصيدة، حيث تمنح لغتها البصرية حساسية العين الرائية، وشغف الشاعر الذي لا يرى العالم إلّا عبر اللغة، وهذا ما يجعل قصيدته لا حدود لها، ولا تفسير لها، لأنها شأن شخصي، أو ممارسة عميقة يمارس من خلالها الشاعر وجوده في «اللامكان»، إذ تتوهج تلك اللغة عبر استعارات متعالية، تتشبع بالاحالات والصور واليوميات التي يدرك سحرها فائق وهو يستدعي العالم إلى تلك القصيدة، لتمارس وظيفة الأنثى والطبيعة والسيرة.
نثرية «الشعر» في قصيدة صلاح فائق، مع ما هو شعري في توصيفات سوزان برنار، حيث التوهج والكثافة والإشراق، لكنني أجد أن كتابة تلك القصيدة مسكونة بتمردٍ ما، على الوصايا، وعلى النمط، إذ يكتبها وكأنه في طقسٍ من اللذة، وهذا ما يجعل قصيدته غامرة بالبوح والتطهير والخلاص، إذ يترك الشاعر الجسد للطبيعة، والفكرة للرؤيا، وللغة للاستعارات، فهو غير معنيٍّ بالحقيقة، بقدر ما يُعنى بسحر اللغة، وهي تتحوّل إلى نشيد شخصي، أو إلى ترياق أو خطاب في الألفة..
لا أدلجة في قصيدة فائق، رغم أن ذاكرته اليسارية تهجس بها، لكن تطوّر شعريته واتساع مداها في التحول والتجاوز، والتحرر من وصايا التاريخ والآباء، ومن ذاكرة السرديات الكبرى، جعل تلك القصيدة أكثر انحيازا للشخصانية، في تمثيل الذات التي ترى العالم عبر ما تقترحه سرديتها الخاصة، بوصفها تمثيلا لتلك الذات، وهي تشتري حقل التفاح، وأسيجة المنفى، وقميص يوسف، لكي تمارس بحرية فائقة، نبل الخطيئة الشهية، ومساحة البيت الذي يتحول إلى قصيدة، والقميص الذي يحمل سيرة الميثولوجيات الساحرة عن الجسد المشتهي، والجسد الرافض…
