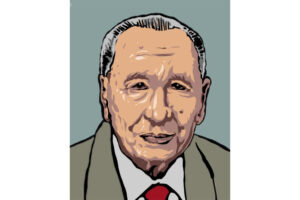
تشير الدراسات الرصينة المُوثقة إلى أن بدايات الشعر الغنائي الإنكليزي قد ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر، تحت تأثير الشعراء التروبادور والتروفير الذين نقلتهم معها إلى إنكلترا الكونتيسة إليانور، حفيدة التروبادور الأول كيوم التاسع، بزواجها من هنري الثاني ملك إنكلترا عام 1154. ونجد أمثلة على ذلك في كتاب الأب هنري جيتر بعنوان “الشعراء التروبادور” (1912) وفي عمله اللاحق بعنوان “الشعراء التروبادور وإنكلترا” (1923). وقد اعتمد على هذين الكتابين الباحثون الفرنسيون وخاصة جان أوديو (1920) وجوزيف أونكلاند (1929). وتشير هذه الكتب إلى العلاقات الثقافية والسياسية والتجارية بين فرنسا شمالاً وجنوباً مع إنكلترا بحكم البيئة الثقافية والسياسية التي بدأت مع الفتح النورمندي لإنكلترا على يد وليم الفاتح عام 1066. كما تشير تلك الدراسات وغيرها إلى أن اللغة الرسمية كانت الفرنسية وأن اللغة الإنكليزية كانت قد توارت على امتداد القرون، حتى بدأت بالظهور التدريجي في بدايات القرن الرابع عشر، مثقلةً ببقايا الأنكلوساكسونية وجذورها الجرمانية. والشعر الذي يعود إلى تلك الفترة، على ندرة المُسجل منه، كان باللغة الأنكلونورمندية، وهي خليط من فرنسية وليم الفاتح النورماندي الأصل، وإنكليزية العوام. وتشير هذه الكتب جميعاً إلى أمثلة من الشعر الإنكليزي الغنائي المبكر، مع أمثلة مما سبقها أو عاصرها من شعر التروبادور البروفنسيين. وهنا يبدو جلياً مدى تأثر الشعر البروفنسي بشعر الموشح والزجل، من حيث موضوعات الحب مفهوماً وموقفاً، ومن حيث بنية القصيدة تقسيماً وتقفيةً. لكن الباحثين الفرنسيين والإنكليز لا يجدون غضاضةً في “الاعتراف” بدور الشعر البروفنسي في تطور الشعر الغنائي الفرنسي والإنكليزي بشكل خاص منذ بدايات القرن الثالث عشر، ويقولون إن ذلك جاء عن “تأثير مباشر أو غير مباشر”. أما عند النظر في تأثير الموشح والزجل بجذورهما في الشعر العربي التراثي “تأثيراً مباشراً أو غير مباشر” في ظهور شعر غنائي أوروبي خارج حدود اللاتينية القروسطية فتلك “مسألة فيها نظر”.

ربما كان كتاب سيجيك وجيمبرز بعنوان “الشعر الغنائي الإنكليزي المبكر” من أهم الكتب التي تبين مدى تأثر ذلك الشعر بشعراء التروبادور والتروفير بما يسرُد من أمثلة سابقة أو معاصرة، تماماً كما نجد عند الباحثين الإسبان في بيان مدى تأثر شعر بروفانس بالموشحات والأزجال السابقة أو المعاصرة. هذا مثال من غنائية إنكليزية مبكرة لشاعر مجهول الإسم، تحمل آثار اللغة الإنكليزية في بداية ظهورها من خلف غيوم الأنكلونورماندية، كما تحمل آثاراً من جذورها الجرمانية، مما نجد في أمثلة من ملحمة “بيولف” لكن هذه الغنائية تتحدث عن حب لم يكن معروفاً في التراث الأوروبي قبل ظهور الشعر الجديد في بروفانس:
” أُحب موتي وأكره حياتي/ من أجل سيدة جميلة/ هي وضاءة مثل نور النهار/ الذي سيشرق علي/ يعلوني اصفرارٌ كما يعلو على الورقة/ التي تكون خضراء في الربيع /إذا أحسستُ أنها لا تُعينني/ فلمن أشكو حالتي؟”.
قوافي هذه الأغنية هي: أ-ب-أ-ب -ج-ب-د-ب إضافةً إلى هذا التفجع المألوف عند العشاق نلاحظ تقسيم القصيدة إلى مقاطع ذات 72 بيتاً، كما نلاحظ نظام التقفية المألوفة في الموشح: أ-ب-أ-ب ثم يتغير إلى ج-ب-د-ب، لكنه لا يلتزم النظام نفسه في كل مقطع، بل يحافظ على القافية فيها، قدر ما تسمح به لغة ليست غنيةً بالقوافي. فلو فتحنا الأبيات الأربعة الأولى إلى شطر وعجز، أي: أ-ب وتحتها: أ-ب ثم تركنا الأبيات الأربعة اللاحقة على حالها في التتابع لازداد الشبه بنظام الموشح وقوافيه. ولا يعني هذا أن المنتظر من هذا الشاعر المبكر في تاريخ تطور الشعر الغنائي الإنكليزي أن ينظم على منوال شاعر بروفانسي أو وشاح أندلسي. يكفي أنه حاول جهده في التزام نظام تقطيع جديد على تراثه الشعري.
الموشحات الأندلسية
في قصيدة مشهورة في بابها بعنوان “أليسون” تعود إلى بدايات القرن الثالث عشر، ولو أنها وُجدت في مخطوطة تعود إلى بدايات القرن الرابع عشر، نجد مثالاً أشد قرباً من الشعر البروفنسي من حيث موضوع الحب والموقف منه ومن حيث نظام المقاطع والتقفية. موضوع القصيدة وبنيتها وقوافيها أشد قرباً من أجواء الموشحات الأندلسية. نجد ثمانية أبيات/أسطر قوافيها: أ-ب-أ-ب، ثم: ب-ب-ب-ج. فلو أعدنا ترتيب الأبيات/ الأسطر الأربعة الأولى إلى:
أ-ب-أ-ب ثم أبقينا على تسلسل بقية المقطع لكان صورة من نظام الموشح وبخاصة مع وجود “الخرجة” التي تتكرر على شكل أغنية. هذا النظام الدقيق في التقفية وتقسيم المقاطع لا سابقة له في التراث الشعري الأوروبي حتى في غنائيات التروبادور أو التروفير التي تلتزم نظام القوافي بدقة، ربما لضعف في المواهب المبكرة. وقد رأينا مثل ذلك في قوافي كيوم في قصائده الثلاثة الأولى.
وقد لا يكون من باب التجديف الأدبي القول بأن شاعر “أليسون” كان على معرفة بالموشحات والأزجال إلى جانب معرفته بشعر التروبادور والتوفير، لأن نظام المقاطع/ الأقفال، ونظام القوافي يمثل مرحلة متقدمة جداً على شعر التروبادور والتروفير. وإعادة ترتيب أبيات هذه القصيدة في كل مقطع يبين التشابه الشديد مع بنية الموشح وقوافيه، ولو أنه تشابُه غير مُطلق، لكي لا نتجاوز على موهبة الشاعر الفردية. فاذا فعلنا ذلك تصبح القصيدة شديدة الشبه بموشح إبن زُهر( إبن المعتز): “أيها الساقي إليك المُشتكى”. وهذه هي قصيدة أليسون:
“ما بين شهري آذار ونيسان/ عندما تُزهر البراعم على الغصون/ وتنطلق العصفورة بمتعتها/ مغردة بألحانها الخاصة/ أعيش في حُب وشوق/ إلى الأجمل في هذا الوجود/ التي قد تجلبُ لي السعادة:/ فأناملكُ يمينها/ لقد نعمتُ بحظ عجيب/ أعرف أنه أتاني من السماء/ فأزال عني حُب جميع النساء/ وأحاط به أليسون.”
إفتتاحيات غنائيات الحُب الإنكليزية سواء منها ما نُظم بالأنكلونورماندية أو بالإنكليزية الوسطى، في تطورها اللاحق، تُشير إلى جمال الطبيعة والطيور، ثم تنتقل إلى مشاعر الحُب كما في قصيدة “أليسون” هذه. ويشير جيتر إلى الكثير من الأمثلة في شعر التروبادور السابقة على ظهور غنائيات الحب بالإنكليزية، بحيث يصعُب القول من الأمثلة اللاحقة إن لم تكُن صوره من الأمثلة السابقة، من حيث الموقف من الحب، ومن حيث نظام القوافي.
ثمة مثال من التروبادور كاوسيلم فايديت (1190-1240) يتساءل الشاعر فيه أسئلةً تُقلقُه عن سلوك المحبين مما يدُل على أنه معني بالحب، حتى عندما يكون من شأن الآخرين. والذي يستدعي انتباه جيتر نظام القوافي الدقيق في كل مقطع مما يشابه نظام القوافي في قصيدة “أليسون”.
قصيدة هذا التروبادور فيها إغراق في الحب حد التهتك، فهو القائل: “يجب أن يكون الحب موضوع الغنائية، وإدخال أي موضوع آخر هو إفساد للشعر”. لكن الذي يعني جيتر هو هذا التطابق التام بين قوافي شاعر بروفانسي سابق وآخر إنكليزي لاحق، وذلك النظام في التقفية في الحالين هو: أ-ب-أ-ب- ب-ب- ب-ج. ولأن كتاب جيتر الأول قد ظهر عام 1912 فلا يُنتظر أن نجد في هذا الكتاب إشارات إلى أمثلة من الشعر العربي ومؤثراته، كما نجد في دراسات الإسبان لاحقا، أو في دراسات الفرنسيين مثل ليفي بروفنسال أو غيره، أو في كتاب الجيكي الأمريكي آلويس نيكل مثلاً. هذا موشح للأعمى التُطيلي (ت.1125):
“ضاحكٌ عن جُمان/ سافرٌ عن بدر/ ضاق عنه الزمان/ وحواه صدري” يشبه فيه أول بيتين من شطر وعجز قصيدة “أليسون” بعد إعادة ترتيبهما.
الغنائيات الأنكلونورماندية
ومثل ذلك ينطبق على قصيدة كاوسيلم فايديت كما أن الأبيات الثلاثة اللاحقة (الغُصن في الموشح) تشبه الأبيات/ الأسطر الثلاثة اللاحقة في قصيدتي “أليسون” وقصيدة كاوسيلم مع الفرق في غنى القوافي العربية الذي لا تبلغه الغنائيات في “لطينية الأندلس” لغة الشعر البروفنسي، ولا الغنائيات في اللغة الأنكلونورمندية أو الإنكليزية الوسطى. ولا يتوقع أي باحث جاد أن يرى في الغنائيات باللغات الأوروبية تطابقاً تاماً مثل الذي نجده بين بعض الغنائيات الأنكلونورماندية وما جاء بعدها، أو بين الموشحات والأزجال السابقة عليها. لكن المعروف أن الموشحات والأزجال أشعار نُظمت لأجل الغناء. وإذا استمع إليها أي شاعر أو مُغن غير عربي فليس من الصعب عليه أن يحتفظ بذلك اللحن والإيقاع في ذهنه لكي يفيد منه في ما ينظم بالبروفنسية أو غيرها، كما يفيد من الألحان، ولو أنه لا يفهم لغه الموشح.
الشعر الغنائي في أغلب الثقافات العالمية موضوعُه الرئيس هو الحب. نجد هذا عند أول شاعرة إغريقية: سافو (620-550ق.م) كما نجده عند امرئ القيس في الجاهلية وعند المُنخل اليشكري. وقد امتد من الشعراء العذريين في العهد الأموي مروراً بالعهد العباسي في شعر العباس بن الأحنف الذي نظم أبياتاً في الحب على لسان الخليفة هارون الرشيد، الذي لا أحسبه قد مانع في ما صرح به الشاعر. ولما انتقل الشعر إلى الأندلس ازدهر غناء في موشحات وأزجال أبدع فيها زرياب على عوده الذي حمله من بغداد. وبظهور الموشحات والأزجال في الأندلس ظهرت في إقليم بروفانس أنشطة شعرية تستوحي الشعر الأندلسي وبخاصة موقفه من الحب. ولم تكن كنيسة الكاثوليك الرومية المسيطرة على الثقافة لا ترضى عن هذا النشاط الوثني، فسعى البابا إنوسنت الثالث إلى القضاء عليه وعلى حضارة بروفانس الوثنية. فهرب شعراء بروفانس وحملوا معهم الحب إلى صقلية وجنوب إيطاليا فانتشر شعر لم يكن للثقافة القروسطية به من عهد. ومن إيطاليا انتشر شعر الحب إلى أنحاء أوروبا حتى وصل إلى شكسبير الذي أطلقه غنائيات مئة وأربع وخمسين. ولشعر الحب في اللغه الإنكليزية جذور ضاربةٌ في القدم، منها هذه القصيدة التي أوحت بها “أليسون”.
