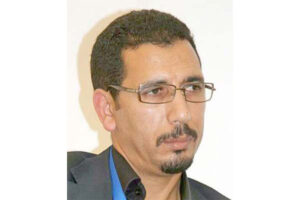
حل وعقد
حاول بعض النقاد القدامى استشكال العلاقة بين الشعر والنثر، بمنأى عن الأحكام الانطباعية في تفضيل النظم على النثر، أو النثر على النظم، بيد أنه ما وقر في ظنَّهم أن المعيار الوحيد الذي ينأى بالشعر عن النثر هو الوزن، فابتكروا مصطلح «حل المنظوم ونظم المنثور» مُدّعين أن نقل الصيغ الشعرية إلى جنس النثر يختزل في إجراء أدبي، لا يتطلب إلا مهارةً وحذقاً بتبديد الوزن وهدمه، كما أن نقل الصيغة النثرية إلى أسلوب شعري لا يزيد عن عقدها بالوزن.
ولم يتوقف الفرْقُ بين النظم والنثر عند المستوى العروضي والشكلي، بل وجد الكتاب أنفسهم في صميم الافتنان بالقول وهم يناقشون «حلّ الشعر ونظم النثر» منذ أن شرع عبد الحميد الكاتب في حلِّ معقود الكلام، ومنذ أن فُهِم بأن «الكتابة نقض الشعر» وأن «الشعر رسائل معقودة والرسائل شعر محلول» وأعانتهم البلاغة على هذه الصنعة؛ فقد «قيل للعتابي: بما قدرت على البلاغة؟ فقال: بحلِّ معقود الكلام». ولهذا، توالت المباحث التي تُعنى بثنائيّة الحلّ/ العقد، وتفشت صنعةُ حلِّ الشعر حتى وصلت ذروتها مع ابن الأثير.
من ينظر في كتاب «الوشي المرقوم في حلِّ المنظوم» الذي يُرجح أنه كُتب بعد «المثل السائر» يلمس انحدار ابن الأثير إلى نزوع سكولائي يعكس رغبته في تعليم النثر والكتابة؛ فهو يعمد إلى الشعر ويأخذ معانيه ويُصيِّرها نَثْراً، كأنّه يُرينا ما يحسن أن يُحلَّ من الشعر، ويُحدّثنا عن الطريقة المثلى في حلِّه، وعن أيِّ الألفاظ التي يحقُّ أن تبقى، وأيُّها يحقُّ أن تُستبدل بغيرها أثناء الحلّ، ثم السبب في هذا أو ذاك. وقد وجد في شعر أبي تمام والبحتري والمتنبّي لعظم معانيهم الشعرية مادّةً دسمةً يُقلّبها أنى شاء «تقليب السماسرة للمتاع»؛ ثم انتهى إلى أن حلَّ الشعر ثلاثة أوجه، وهي درجات بين «التنويع» واللاجنس»:
حلّ الشعر بلفظه، وهو أدنى مرتبة ولا فضيلة فيه كما يعتقد، ويُمثِّله بـمن هدم بِناءً، ثُمّ أخذ تلك الآلات المهدومة، فأنشأ بها بِناءً آخر، فإنّه يجيءُ حينئذٍ مُخلولق البناء لا محالة. وهذا ما لا يحسبه من صناعة حلِّ الشعر في شيء، لأنّه ينبغي عدم «حلّ المعاني الشعرية بلفظها بعينه».
حلّ الشعر ببعض لفظه، ويعدُّه «أصعب منالاً» لأنّ حلَّ شعر شاعرٍ مُجيدٍ يتطلّبُ مؤاخاة لفظه بمثله في الحسن والجودة.
حلّ الشعر بغير لفظه، ويَضعُه في «الطبقة العليا» ويرتبط بنقل المعنى من لفْظٍ إلى لفظ ثانٍ تثبت الفضيلة فيه لمن أحسن سبكه وأبرزه في «حليةٍ رائقة». واشتقَّ ابن الأثير من هذا القسم ضَرْباً يُسمّى «توليد المعاني» ونعته هو بـ«الكيمياء».
ويظهر ممّا يسوقه بخصوص العلاقة بين الشعر والنثر عامّة، وحلّ المنظوم تحديداً، أنَّه قلب مفهوم الصنعة كما تجسّدت بوضوح عند ابن طباطبا؛ فبدلاً من أن يكون النثر مادّةً للشعر، جعل الشعر مادّةً للنثر والكتابة. كان ابن طباطبا، في حديثه عن «صناعة الشعر» يُعطي للمعنى أسبقيّةً في البناء، ويجعله مستقلّاً عن شكله الإيقاعي، وإن كان قد استحضر في الظاهر العناصر جُلّها، مُتفاعلةً في ما بينها، بما في ذلك عنصرا النظم: الوزن والقافية. في المُقابل، لم يحصر ابن الأثير صنعة حلّ الشعر إلّا داخل ثنائية اللفظ والمعنى، ولم يتطرق إلى مشكلة البناء بذكْرٍ ذي اعتبار، إلّا من عباراتٍ انطباعيّة فرضها ذوقه الفنّي كناثِرٍ من الطراز الرفيع. فهو، مثلاً، يأخذ معنىً من شعر البحتري، وهو:
سَمّاهُ سَعْداً ظنَّ أن يحيا بِـهِ عمري، لقَدْ أَلْفاهُ سعد الذّابـح
فنثره، قائلاً: «إذا رفعت الخطوب أعناقها، لقيها من رأيه بسعد الذّابح، وإن دجى ليلها غَشِيَه من عزمه بالسِّماك الرامح؛ فهو في إحدى الحالتين يسفك دماءَها، وفي الحالة الأخرى يجلو ظلماءَها. ولهذا تُرى وقد أجفلت من طريقه، ورجعت عن حرب عدوِّه إلى سلم صديقه». وبدلاً من أن يُلاحظ ما صار عليه البناء المنقول إليه حَلّاً، من سمات النثر وخواصّه كانتظام الفواصل والسجع والازدواج والالتفات، علّقَ عليه: «إنّ الذي أتيتُ به أسدّ وأمتن وأحسن مَوْقعاً، وألطف مأخذاً؛ لأنّي ذكرت: العنق والذّبح، والليل والسماك. ولا خفاء بما في ذلك من المناسبة».
هاجس تعليمي
مع ما يكشفه ابن الأثير من تمرُّس على أساليب الكتابة الفنّية، وقدرته على الانتقال بين تنويعاتها الجمالية في ما كان يُنْشئه ويضربه من أمثلة، إلّا أن آليّة تحليله النظريّ لها لم تكن بالدرجة نفسها، ولا بالوعي نفسه. كانت المسافة التي يسلكها من الشعر إلى النثر مضبوطة ومحكومة بهاجسٍ تعليميٍّ، إذ لم يكن المهمّ هو الشكل، بقدر المادّة المحمولة؛ فالشعر، كما القرآن والأخبار النبويّة، لا يأخذه إلّا باعتبار ما يحملهُ من مَعْرفةٍ (مثل، حكمة، وجه بلاغي..) وذلك لزعمه أن «الكلام المنظوم» استغرق «جميع المعاني، فكان الأخذ منه أولى». ولهذا نفهم لماذا كان ابن الأثير يهتمُّ بـ«نقل المعنى» من وَجْهٍ إلى وَجْهٍ آخَر، ولم يُعِرْ للموازنات الصوتية ـ الإيقاعيّة التي ضمّنها نثره اهتماماً في النظر والاعتبار، ورُبّما شغلَهُ عن ذلك أن الكتاب «كتاب تعليم». لقد اتّضحَ، بالفعل، الطابع السكولائي للكتاب، وخفتَ الطابع الإشكاليّ للقضايا التي من المفترض أن تطرحها صنعة حلّ الشعر تجريبيّاً، وذلك على صُعُد البناء والدلالة والإيقاع؛ فالفرق بين النظم والنثر ليس فَرْقاً في استخدام المعاني والسبق إليها، لكنّه فَرْقٌ في طريقة التعبير وتوقيعه. وأين هذه الصنعة ممّا أثبته الجاحظ، بقوله إن الشعر «لا يستطيع أن يُترج ولا يجوز عليه النقل، ومتى حُوّل تقطّع نظمه وبطل وزنه، وذهب حسنه وسقط موضع التعجُّب».
وهذا التوجُّه الأثيري هو ما نكتشفه كذلك في «الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام المنثور»؛ فرغْمَ ما يبديه ضياء الدين فيه من عِلْمٍ بأفانين الكتابة الأدبية، ومن تحصيل «آلات التأليف» التي يخرج بها ما في القوّة إلى الفعل، ابتداءً من حديثه عن شرائط الصناعة في النثر والنظم، ومروراً بالقول في الحقيقة والمجاز، والألفاظ مُفردةً ومركَّبة ًوالمعاني، وأساليب البيان مع ما تقتضيه من وجوه الخطاب، وانتهاءً بأضرب البديع من سجْعٍ وازدواج وتجنيسٍ وغيرهما، إلّا أنه ظل يراوح مأزق النظريّة نفسه؛ فهو، من جهة أولى، يظلُّ داخل دائرة ما هو تعليمي وما يمليه عليه من نزوع تجزيئي، ومن جهة ثانية يُفضِّل النثر ويراه أشقّ وأصعب مأخذاً من النظم، وإلّا لما نزل به القرآن، ولما كان جميع العرب يقولون الشعر لسهولته «وكان عليهم من أسهل الأشياء حتّى على نسائهم». كما يذهب إلى أن النّثر يحتاج إلى تحصيل أدوات مخصوصة، فيما يقدر على قول الشّعر من لم يحصل من آلاته شيئاً ولا يعرف أدواته البتّة، كالسّوقة والعامّة من أرباب الحرف والصنائع، ولهذا يستوعب النّثْرُ الشِّعرَ وينوب عنه، وليس كذلك الشِّعر.
بوصفه كلاما منظوما ومُوقَّعا، يفترض الشعر طريقته المخصوصة في التعبير، التي تعتمد على تأليف الكلام وبَنْينته، وكذلك النثر. هناك فرقٌ في اللغة، وفرقٌ في طريقة التعبير: أمّا عن فرق اللغة، فلغة الشعر تتميّز عن لغة النثر بخصائص على مستويين: صوتيّ ودلالي؛ فأمّا ما يخصُّ طريقةَ التعبير فسطر النثر يُعبّر عن عناصر الدلالة بطريقة متتابعة ومترابطة من حيّزٍ إلى آخر؛ وأمّا أبيات القصيدة فتفتقر إلى هذا التتابع والترابط في كثيرٍ من المرّات. الفرق بين الشعر والنثر، إذن، هو فَرْقٌ في النوع، لا في الدرجة حسب.
داخل الوزن، خارج الشعر
إنّ خاصية الوزن لا تتجلى قيمتها في أنّها تَسِمُ الشعر بـ«النّظْمية» بل في ما تُجريه من تَحْويلٍ حقيقي يعبُرُ بالكلام في الشعر من مستوى إلى آخر أكثر تأثيراً وإيحاءً، وفق النسيج الفنّي الذي تتعيّش منه، ووفق قوانينه اللغوية التي تتأثّر بها. ولذلك، كلّما كان الوزن يعتمد نسقاً مُحدّداً في توزيع أعاريضه وحركاته وسكناته في كَمٍّ إيقاعيٍّ ما، أثّر ذلك رَأْساً في «صورة الكلام» وجعل اللغة تنتظم انتظاماً يختلف عن الصور العادية للكلام، بقدر ما يجعل الإيقاع في عبور اللغة الشعريّة أكثر ملموسيّةً وماديّة في مستوى بنية الكلمة والتركيب والفضاء برُمّته. في المقابل، أن البقاء في حدود النّظْم واعتباره قيمةً في حدّ ذاته، ودون ميزة التحويل، يترك الشعر خارجه وليس له إلّا فضل الوزن والقافية. لقد كان ذلك نكوصا في الوعي الجمالي للشعر، إذ نجد لدى سابقيه وعياً أكثر تقدُّماً في ما نقلوه لنا من آراء؛ من ذلك ما ينقله المرزباني: «ليس كلّ من عقد وزناً بقافية فقد قال شعراً، الشعر أبعد من ذلك مراماً وأعزّ انتظاماً» أو ما قاله ابن سلام الجمحي: «فليس بشعر إنّما هو كلام مؤلّف معقود بقوافٍ».
يعكس ما يقوم به ابن الأثير صورةً من ذلك الصراع المُغرض الذي كان يسعى إلى ردّ النثر إلى الشعر بإغراقه فيه وتطويقه بوسائله، ومن ثمّ ردّ الاختلاف إلى الائتلاف، والمتعدّد إلى المفرد، كأنّ تلك الثقافة التي نشأ فيها ترفض الخروج عن دور الشعر الذي شبّتْ على غنائيّته. فالنثر الذي ساد، ابتداءً من نهاية القرن الثالث للهجرة، كان من أبرز خصائصه هيمنة المحسّنات الصوتية والبديعية فيه، وقد تفشّى ذلك بوضوح حتّى أصبح النثر في جزء مُهمٍّ من نماذجه متين الصلة بالشعر لا يُفرّقه عنه إلا الوزن. حتّى علماء النقد والبلاغة أنفسهم، ساهموا في تكريس هذا الواقع، إذ لم يهتمُّوا في بناء آرائهم ومقولاتهم بمسألة الأنواع الأدبية التي بدأت تتشكل إلّا لماماً، وتركوا المدوّنة النصّية نَهْباً لحلبة الصراع الصامت الذي يفتقد لمصطلحات السجال، بقدر ما عمل على تمتين عرى البلاغة المعيارية؛ فالشعر شعر، والقرآن ليس شعراً ولا نثراً، والنثر لا يكون إلّا خطابةً وترسُّلاً.
وهكذا، بدا نظام الحل والعقد بمثابة الفنّ العاطل الذي لا شغل له إلا إظهار براعته في تقليب أفانين القول، فيما هو يسخر من «مؤسسة» النوع الأدبي، ومن مفهوم الكتابة التي أخذت تتلمس عناصرها الشكلية والتلفظية بعد انقلاب البديع مع الشعراء المحدثين، أو في التنازع المجالي بين «الصناعتين» الذي كان بوسعه أن يضبط عناصر النوع ومحدّداته بدلاً من أن تنحلّ في كيمياء خادعة.
